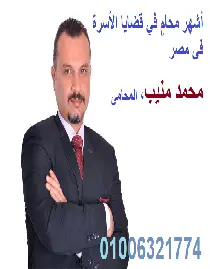المادة 128 – وقف الخصومة وإنقطاعها وسقوطها وإنقضاؤها بمضي المدة وتركها
تُعد الخصومة القضائية سلسلة من الإجراءات القانونية التي قد تتوقف أو تنتهي لأسباب متعددة. فقد يتم وقف الخصومة باتفاق الخصوم أو بحكم من المحكمة في حالات معينة، مثل طلب أحد الأطراف أو لوجود مانع قانوني يمنع الاستمرار في نظر الدعوى. أما انقطاع الخصومة فيحدث تلقائيًا عند وقوع سبب قانوني يمنع أحد الخصوم من متابعة الدعوى، كوفاة أحد الأطراف أو فقدان الأهلية، مما يستلزم استئنافها من قبل الورثة أو من له مصلحة قانونية.
أما سقوط الخصومة، فيحدث عند تقاعس الخصوم عن السير في الدعوى لمدة محددة يحددها القانون، مما يؤدي إلى زوال الآثار الإجرائية التي تمت فيها، بينما يؤدي انقضاء الخصومة بمضي المدة إلى إنهاء الدعوى بانقضاء الأجل القانوني المحدد لها، دون الحاجة إلى قرار قضائي. كذلك، يمكن للخصم ترك الخصومة بإرادته المنفردة، مما يؤدي إلى إنهاء النزاع شريطة عدم اعتراض الطرف الآخر، وذلك وفقًا لما تقضي به القوانين الإجرائية المنظمة لهذه المسائل.
تنص المادة 128 من قانون المرافعات على أنه يجوز وقف الدعوى باتفاق الخصوم لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق. ومع ذلك، فإن هذا الوقف لا يؤثر على المواعيد القانونية المحددة للإجراءات، حيث تظل سارية وفقًا للقانون.
ويهدف هذا النص إلى إتاحة الفرصة للخصوم لمحاولة التسوية الودية أو ترتيب أوضاعهم القانونية دون الإضرار بسير العدالة، ولكن مع ضمان عدم استغلال الوقف لتعطيل الإجراءات أو تجاوز المدد القانونية المقررة.
تُعد المادة 128 من قانون المرافعات المصري من المواد المهمة التي تنظم وقف سير الدعوى باتفاق الخصوم، حيث توازن بين حق الأطراف في الاتفاق على تعليق النزاع مؤقتًا وبين ضمان عدم تعطيل سير العدالة.
نص المادة 128 من قانون المرافعات :
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف اثر فى أى ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإجراء ما .
وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه
شرح المادة 128 :
جواز وقف الدعوى باتفاق الخصوم :
تتيح هذه المادة للأطراف إمكانية الاتفاق على وقف السير في الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويشترط في ذلك أن تقوم المحكمة بإقرار هذا الاتفاق. وهذا الحق يمنح الخصوم فرصة لمحاولة التسوية الودية أو ترتيب أوضاعهم القانونية دون الحاجة إلى الاستمرار في الخصومة القضائية خلال تلك الفترة.
دور المحكمة في وقف الدعوى :
لا يُعد الاتفاق بين الخصوم كافيًا لوقف الدعوى، بل يجب أن تقره المحكمة. وهذا الشرط يهدف إلى ضمان أن يكون الاتفاق جادًا وغير متعسف، بحيث لا يُستخدم كوسيلة للمماطلة أو تعطيل سير العدالة.
الأثر القانوني للوقف :
وفقًا للمادة 128، فإن الوقف المتفق عليه لا يؤثر على المواعيد القانونية التي حددها القانون لإجراءات معينة. بمعنى أنه إذا كان هناك ميعاد يجب الالتزام به، مثل ميعاد الطعن أو تقديم مذكرة معينة، فإن الوقف لا يمدد هذه المدة، بل تظل المواعيد محسوبة كما هي وفقًا للقانون.
الحكمة من نص المادة 128 :
تهدف هذه المادة إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
- إتاحة الفرصة للصلح: قد يكون لدى الأطراف رغبة في تسوية النزاع وديًا دون اللجوء إلى إجراءات طويلة، ولذلك يُسمح لهم بإيقاف الدعوى بشكل مؤقت.
- منع إساءة استخدام حق التقاضي: من خلال اشتراط موافقة المحكمة، يتم التأكد من أن الوقف ليس مجرد وسيلة للمماطلة أو الإضرار بالطرف الآخر.
- ضمان استقرار المواعيد الإجرائية: حيث لا يؤثر الوقف على المواعيد المحددة قانونًا، مما يمنع التأخير غير المبرر في الفصل في القضايا.
الفرق بين وقف الخصومة وفقًا للمادة 128 وأشكال الوقف الأخرى :
هناك أشكال مختلفة من وقف الخصومة في قانون المرافعات، منها:
- وقف الخصومة بالاتفاق (المادة 128): يتم بناءً على اتفاق الخصوم ويحتاج إلى إقرار المحكمة، ويكون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- وقف الخصومة بحكم المحكمة: يتم بناءً على أسباب قانونية مثل طلب أحد الأطراف لسبب وجيه، مثل انتظار الفصل في قضية أخرى متعلقة بالنزاع.
- انقطاع الخصومة: يحدث تلقائيًا عند وفاة أحد الخصوم، أو فقدانه الأهلية، أو زوال صفة من يمثل الخصم قانونًا.
التطبيق العملي للمادة 128 في المحاكم :
في الواقع العملي، يلجأ الخصوم إلى وقف الدعوى في حالات مثل:
- انتظار تنفيذ تسوية ودية بين الأطراف.
- الرغبة في استكمال مفاوضات الصلح أو التحكيم.
- انتظار حكم في قضية أخرى قد يكون له تأثير على النزاع القائم.
وتحرص المحاكم عند الموافقة على وقف الدعوى على التأكد من عدم الإضرار بأحد الأطراف أو تعمد تعطيل الإجراءات.
أثر انتهاء مدة الوقف :
بعد انتهاء مدة الوقف المتفق عليها، يجب على الخصوم استئناف السير في الدعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء المدة، وإلا جاز للمحكمة الحكم بشطب الدعوى إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء من جانب الخصوم.
التعريف بوقف الخصومة والتفرقة بينه وبين التأجيل :
وقف الخصومة هو إجراء قانوني يؤدي إلى تعليق سير الدعوى مؤقتًا، بناءً على اتفاق الخصوم أو لأسباب قانونية محددة، مثل وقفها بحكم المحكمة أو لوجود مانع قانوني كوفاة أحد الأطراف أو فقدان الأهلية. ويترتب على وقف الخصومة توقف جميع الإجراءات في الدعوى خلال مدة الوقف، دون أن يؤدي ذلك إلى زوالها نهائيًا.
أما التأجيل، فهو قرار تتخذه المحكمة بتحديد موعد لاحق لنظر القضية، ويكون عادةً لأسباب إجرائية، مثل منح الأطراف فرصة لتقديم مستندات إضافية أو انتظار نتيجة تقرير خبير. على عكس وقف الخصومة، فإن التأجيل لا يؤدي إلى تعليق الإجراءات كليًا، بل يكون مجرد تأخير زمني محدد دون أن يؤثر على استمرار سير الدعوى.
الوقف الإتفاقي وقف الخصومة بناء على إتفاق الأطراف :
الوقف الاتفاقي لخصومة الدعوى :
الوقف الاتفاقي للخصومة هو أحد صور وقف الدعوى، ويتم بناءً على اتفاق الأطراف على عدم السير فيها لمدة محددة، بشرط ألا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق، وفقًا لما نصت عليه المادة 128 من قانون المرافعات .
يهدف هذا الوقف إلى منح الأطراف فرصة لمحاولة التسوية الودية أو إنهاء النزاع بطرق بديلة دون الحاجة إلى الاستمرار في الخصومة القضائية .
ومع ذلك، فإن هذا الوقف لا يؤثر على المواعيد الإجرائية المحددة قانونًا، مما يضمن عدم استغلاله كوسيلة للمماطلة أو تعطيل العدالة. وبعد انتهاء مدة الوقف، يتعين على الخصوم استئناف السير في الدعوى خلال ثمانية أيام، وإلا جاز للمحكمة الحكم بشطبها.
شروط الوقف الإتفاقي للخصومة :
يخضع الوقف الاتفاقي للخصومة لعدة شروط قانونية يجب توافرها حتى يكون صحيحًا ونافذًا، وذلك وفقًا للمادة 128 من قانون المرافعات. وأهم هذه الشروط:
- اتفاق جميع الخصوم: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح بين أطراف الدعوى على وقف السير فيها، فلا يجوز لأحد الأطراف طلب الوقف بشكل منفرد.
- إقرار المحكمة للاتفاق: لا يكون الوقف نافذًا بمجرد اتفاق الخصوم، بل يتطلب صدور إقرار من المحكمة لضمان عدم استغلاله في تعطيل إجراءات التقاضي.
- تحديد مدة الوقف: يجب ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة، وإذا انتهت المدة دون استئناف الدعوى خلال ثمانية أيام، جاز للمحكمة شطبها.
- عدم تأثير الوقف على المواعيد القانونية: الوقف لا يمدد أو يؤثر على المواعيد التي حددها القانون للإجراءات المختلفة، مثل مواعيد الطعن أو تقديم المذكرات.
تضمن هذه الشروط أن يكون الوقف الاتفاقي أداة مشروعة لتنظيم سير الدعوى دون الإضرار بحقوق الخصوم أو تعطيل العدالة.
الشرط الإول : إتفاق الخصوم على الإيقاف :
اتفاق الخصوم على إيقاف الخصومة :
يُعد اتفاق الخصوم على إيقاف الخصومة الشرط الأساسي لتحقق الوقف الاتفاقي، فلا يجوز لأي طرف بمفرده طلب وقف الدعوى دون موافقة باقي الأطراف. ويجب أن يكون هذا الاتفاق صريحًا وواضحًا، بحيث يُعبر جميع الخصوم عن إرادتهم في تعليق إجراءات الدعوى لمدة محددة، دون إكراه أو ضغط من أي طرف. يهدف هذا الشرط إلى ضمان أن الوقف يتم بناءً على مصلحة مشتركة بين الأطراف، سواء لمحاولة التسوية الودية أو ترتيب أوضاعهم القانونية قبل استئناف النزاع أمام القضاء. ومع ذلك، يظل هذا الاتفاق خاضعًا لتقدير المحكمة التي تملك سلطة إقراره أو رفضه، وفقًا لما تراه محققًا لمبدأ حسن سير العدالة.
الشرط الثاني : ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر :
يُعد تحديد مدة الوقف الاتفاقي للخصومة بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة أحد الشروط الجوهرية التي نصت عليها المادة 128 من قانون المرافعات. ويهدف هذا القيد إلى منع تعطيل إجراءات التقاضي لفترات طويلة قد تؤدي إلى الإضرار بحقوق الخصوم أو التأثير على سير العدالة .
فإذا اتفق الأطراف على وقف الدعوى، يجب ألا تتجاوز المدة المحددة قانونًا، حتى لا يتحول الوقف إلى وسيلة للمماطلة والتأخير. وبعد انتهاء مدة الوقف، يتعين على الخصوم استئناف السير في الدعوى خلال ثمانية أيام، وإلا جاز للمحكمة الحكم بشطبها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
الشرط الثالث : إقرار المحكمة للإتفاق :
يُعد إقرار المحكمة للاتفاق شرطًا أساسيًا لنفاذ الوقف الاتفاقي للخصومة، حيث لا يكفي مجرد اتفاق الخصوم على وقف الدعوى، بل يجب أن توافق المحكمة على هذا الاتفاق وتصدر قرارًا بإقراره. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان عدم استغلال الوقف كوسيلة للمماطلة أو الإضرار بحقوق أحد الأطراف .
كما أن المحكمة تتحقق من أن الاتفاق يتماشى مع القانون، وخاصة فيما يتعلق بمدة الوقف التي يجب ألا تتجاوز ثلاثة أشهر .
فإذا رأت المحكمة أن الوقف قد يؤدي إلى تعطيل العدالة أو الإضرار بمصلحة أحد الخصوم، جاز لها رفض إقراره، مما يعكس دورها في تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف وسرعة الفصل في النزاعات.
الآثار المترتبة على وقف الخصومة أيا كان سببه :
يترتب على وقف الخصومة، بغض النظر عن سببه، عدة آثار قانونية تؤثر على سير الدعوى وإجراءاتها. أولًا، يؤدي الوقف إلى تعليق جميع الإجراءات في الدعوى طوال مدة الوقف، فلا يجوز اتخاذ أي إجراء جديد فيها، سواء من قبل الخصوم أو المحكمة، حتى ينتهي الوقف ويتم استئناف السير فيه ا.
ثانيًا، لا يؤثر الوقف على المواعيد القانونية المحددة للإجراءات، بمعنى أن أي ميعاد نص عليه القانون، مثل مواعيد الطعن أو تقديم المستندات، لا يتوقف بسبب وقف الخصومة .
ثالثًا، بعد انتهاء مدة الوقف، يجب على الخصوم استئناف الدعوى خلال ثمانية أيام، وإلا جاز للمحكمة الحكم بشطبها. ويختلف أثر الوقف عن الانقطاع أو الشطب، حيث إن الدعوى لا تزول وإنما تبقى معلقة حتى ينتهي سبب الوقف ويتم استكمالها وفقًا للإجراءات القانونية.
الآثر الأول : أن الخصومة تعتبر قائمة رغم وقفها :
يُعد الأثر الأول لوقف الخصومة هو أن الخصومة تظل قائمة قانونًا على الرغم من توقف السير فيها. فالوقف لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى أو زوالها، وإنما يعلق إجراءاتها مؤقتًا حتى ينتهي سبب الوقف ويتم استئنافها .
وهذا يعني أن جميع الإجراءات التي تمت قبل الوقف تظل صحيحة ونافذة، ولا تحتاج إلى إعادة من جديد عند استئناف الدعوى .
كما أن المحكمة تحتفظ باختصاصها في نظر القضية، ويبقى أثر الدعوى قائمًا، بحيث يمكن استئنافها بمجرد انتهاء مدة الوقف دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة.
الآثر الثاني : إن الخصومة تعتبر قائمة رغم وقفها :
على الرغم من وقف الخصومة لأي سبب من الأسباب، إلا أنها تبقى قائمة قانونًا، حيث لا يؤدي الوقف إلى إنهائها أو زوالها، وإنما يترتب عليه تعليق السير في إجراءاتها مؤقتًا. وبذلك، فإن جميع التصرفات والإجراءات التي تمت قبل الوقف تظل صحيحة وسارية، ويمكن استكمال الدعوى من النقطة التي توقفت عندها بمجرد انتهاء مدة الوقف.
كما تظل المحكمة محتفظة باختصاصها في نظر النزاع، مما يتيح للأطراف استئناف الدعوى دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة، وهو ما يميز الوقف عن انقضاء الخصومة أو سقوطها.
إنتهاء ركود الخصومة الموقوفة أيا كان سبب الوقف بالتعجيل أو بالإنقضاء :
تنتهي حالة ركود الخصومة الموقوفة بطريقتين رئيسيتين، وهما التعجيل أو الانقضاء، وذلك وفقًا لسبب الوقف وطبيعة الإجراءات القانونية المرتبطة به.
-
التعجيل باستئناف السير في الدعوى: إذا انتهت مدة الوقف، سواء كان وقفًا اتفاقيًا أو قضائيًا، يتعين على أحد الخصوم اتخاذ إجراء إيجابي لتعجيل الخصومة واستئناف النظر فيها خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء الوقف، وإلا جاز للمحكمة شطب الدعوى.
-
الانقضاء بزوال الخصومة: إذا لم يتم التعجيل بالسير في الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف، أو إذا طرأ سبب قانوني يؤدي إلى انتهاء النزاع، مثل التصالح بين الخصوم أو سقوط الخصومة بمضي المدة، فإن الدعوى تنقضي نهائيًا ولا يجوز الاستمرار فيها، إلا إذا تم رفعها من جديد وفقًا للقانون.
وبذلك، فإن انتهاء الركود المترتب على وقف الخصومة يتوقف على مبادرة الخصوم بتحريك الدعوى في الوقت المناسب، وإلا فقد تنتهي الخصومة بانقضائها وزوالها قانونًا.
مدى جواز الحكم بزوال الخصومة الموقوفة وقفا إتفاقيا من تلقاء نفس المحكمة إذا لم تعجل خلال ثمانية أيام من تاريخ إنتهاء مدة الوقف :
مدى جواز الحكم بزوال الخصومة الموقوفة وقفًا اتفاقيًا من تلقاء نفس المحكمة :
وفقًا لقواعد المرافعات، إذا تم وقف الخصومة اتفاقيًا بموجب المادة 128 من قانون المرافعات، فإنها تظل موقوفة طوال المدة المتفق عليها، بشرط ألا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة للاتفاق. وبعد انقضاء هذه المدة، يتعين على الخصوم اتخاذ إجراء لتعجيل الدعوى خلال ثمانية أيام، وإلا جاز للمحكمة الحكم بشطبها.
ومع ذلك، فإن المحكمة لا تحكم بزوال الخصومة من تلقاء نفسها، وإنما يتطلب الأمر تقديم طلب من أحد الخصوم أو إثارة المسألة أثناء نظر الدعوى. أي أن المحكمة لا تملك إصدار حكم بانتهاء الخصومة دون أن يكون هناك طلب صريح بذلك، وذلك حفاظًا على حقوق الخصوم وإتاحة الفرصة لهم لاستئناف السير في الدعوى إذا رغبوا في ذلك.
مدى جواز إنهاء الوقف الإتفاقي قبل الإنتهاء مدته بالإرادة المنفردة :
لا يجوز لأي من الخصوم إنهاء الوقف الاتفاقي للخصومة بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته المتفق عليها، وذلك لأن الوقف تم بناءً على اتفاق جميع الأطراف، مما يقتضي أن يكون إنهاؤه أيضًا باتفاقهم المشترك .
وبمجرد أن تقر المحكمة هذا الاتفاق، يصبح ملزمًا للأطراف، ولا يمكن لأحدهم الرجوع عنه بمفرده إلا إذا وافق باقي الخصوم، أو إذا وُجد سبب قانوني يبرر إنهاء الوقف قبل مدته .
وفي حال أراد أحد الخصوم استئناف الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف، يتعين عليه تقديم طلب إلى المحكمة وإثبات وجود مبرر قانوني قوي لإنهائه، وإلا فإن المحكمة سترفض التعجيل بالسير في الدعوى قبل انتهاء المدة المقررة للوقف.
مادة 129- فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى:
تتحدث المادة 129 عن وقف الدعوى القضائية وتعطي المحكمة الحق في ذلك إذا كان الفصل في موضوع الدعوى يعتمد على حسم مسألة أخرى.
يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية أحد القوانين الأساسية التي تنظم الإجراءات القضائية أمام المحاكم، ومن بين مواده المهمة المادة 129، التي تتعلق بـوقف الدعوى القضائية .
وتعتبر هذه المادة إحدى الوسائل التي تمنح المحكمة سلطة تنظيم سير الدعوى بما يحقق العدالة، من خلال تعليق الفصل فيها حتى يتم البت في مسألة أخرى تتوقف عليها.
في هذه المقالة، سنتناول شرح المادة 129، أنواع الوقف في القانون، أهم التطبيقات القضائية، والآثار القانونية لوقف الدعوى.
نص المادة 129 من قانون المرافعات المصري :
فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى.
مفهوم وقف الدعوى وفقًا للمادة 129 :
وقف الدعوى هو إجراء قانوني يتم بموجبه تعليق نظر القضية أمام المحكمة مؤقتًا، وذلك عندما يكون الحكم فيها متوقفًا على الفصل في مسألة أخرى يجب حسمها أولًا. ويعني ذلك أن المحكمة ترى أنه لا يمكن إصدار حكم عادل دون معرفة النتيجة القانونية لمسألة أخرى منظورة أمام جهة أخرى.
أنواع وقف الدعوى في القانون المصري :
ينقسم وقف الدعوى إلى نوعين رئيسيين:
-
الوقف الوجوبي (الإجباري):
- يكون ملزمًا للمحكمة ولا تملك السلطة التقديرية فيه.
- يحدث في حالات محددة نص عليها القانون، مثل وقف الدعوى لحين صدور حكم في دعوى جنائية مرتبطة بها.
-
الوقف الجوازي (التقديري):
- تملك المحكمة سلطة تقديرية في إقراره.
- ينطبق على الحالات التي ترى فيها المحكمة ضرورة وقف الدعوى لتعليق الحكم على مسألة أخرى، كما ورد في المادة 129.
شروط تطبيق المادة 129 :
لوقف الدعوى وفقًا لهذه المادة، يجب توافر الشروط التالية:
-
عدم وجود نص قانوني يلزم بالوقف الوجوبي أو الجوازي:
- أي أن الحالة لا تكون منصوصًا عليها ضمن الوقف الوجوبي أو الجوازي في مواد أخرى من القانون.
-
وجود مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم في الدعوى الأصلية:
- يجب أن تكون هناك مسألة لم يُفصل فيها بعد، ويعتمد الحكم في الدعوى الحالية على نتيجتها.
-
سلطة المحكمة التقديرية:
- للمحكمة الحق في أن تقرر ما إذا كان وقف الدعوى ضروريًا لحسم النزاع أو لا.
أمثلة وتطبيقات قضائية على المادة 129 :
يمكن توضيح كيفية تطبيق هذه المادة من خلال بعض الأمثلة:
✅ المثال الأول: دعوى مدنية متعلقة بجريمة جنائية :
- إذا رفع شخص دعوى تعويض ضد آخر بسبب ادعائه بتزوير مستند، وكان هناك دعوى جنائية قائمة للتحقيق في التزوير، فإن المحكمة المدنية قد توقف نظر الدعوى لحين صدور الحكم الجنائي الذي سيحدد ما إذا كان المستند مزورًا أم لا.
✅ المثال الثاني: دعوى ملكية تتوقف على الفصل في نزاع آخر :
- إذا كانت هناك دعوى أمام المحكمة تطالب بإبطال عقد بيع عقار، وكان هناك نزاع أمام محكمة أخرى لتحديد مالك العقار الحقيقي، فيجوز للمحكمة وقف دعوى الإبطال حتى يتم الفصل في مسألة الملكية.
✅ المثال الثالث: منازعات الأحوال الشخصية :
- إذا كانت هناك دعوى نفقة زوجية، وكان هناك نزاع قائم حول صحة الزواج نفسه أمام محكمة أخرى، فقد ترى المحكمة وقف الدعوى لحين الفصل في مسألة الزواج.
الآثار القانونية لوقف الدعوى :
-
تعليق جميع الإجراءات:
- بمجرد صدور قرار الوقف، تتوقف جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوى، ولا يتم السير فيها إلا بعد زوال السبب الذي أدى إلى الوقف.
-
لا يؤثر الوقف على حقوق الخصوم:
- الوقف لا يعني خسارة أحد الخصوم لحقوقه، بل هو مجرد تعليق مؤقت لحين الفصل في المسألة المرتبطة بالدعوى.
-
إمكانية التعجيل بعد زوال سبب الوقف:
- بمجرد انتهاء المسألة المعلقة، يكون لأي من الخصوم الحق في طلب تعجيل نظر الدعوى واستكمال إجراءاتها.
الفرق بين وقف الدعوى وانقطاع الخصومة :
قد يختلط الأمر بين وقف الدعوى وانقطاع الخصومة، لكن هناك اختلافات جوهرية بينهما:
| وجه المقارنة | وقف الدعوى (المادة 129) | انقطاع الخصومة |
|---|---|---|
| السبب | ارتباط الحكم بمسألة أخرى | وفاة أحد الخصوم أو فقدانه الأهلية |
| من يأمر به | المحكمة بقرار تقديري | يحدث بقوة القانون |
| أثره | تعليق الدعوى مؤقتًا | يجب على الورثة أو الممثل القانوني متابعة القضية |
متى ينتهي وقف الدعوى؟
ينتهي الوقف تلقائيًا بمجرد زوال السبب الذي أدى إليه، وعندها يحق للخصم أن يطلب تعجيل نظر الدعوى واستئناف الإجراءات أمام المحكمة.
في بعض الحالات، قد يمتنع الخصوم عن طلب التعجيل، وهنا يكون للقاضي أن يحدد مدة معينة لاستمرار الوقف، وبعدها يتخذ الإجراء المناسب لضمان عدم تعطيل العدالة.
خاتمة :
تمثل المادة 129 من قانون المرافعات المصري أداة قانونية مهمة لتحقيق العدالة وضمان صدور أحكام قضائية سليمة غير متعارضة. فهي تمنح المحكمة سلطة وقف الدعوى إذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى، مما يساعد في توحيد الأحكام القضائية وتجنب التعارض بينها.
ومن ثم، فإن تطبيق هذه المادة يعد أمرًا ضروريًا في بعض القضايا لضمان تحقيق العدالة بأفضل صورة ممكنة.
الوقف التعليمي للخصومة :
الوقف التعليمي للخصومة هو إجراء قانوني غير منصوص عليه صراحة في قانون المرافعات، لكنه يُستخدم عمليًا عندما تحتاج المحكمة إلى منح أحد الخصوم فرصة لاستكمال مستندات أو إجراءات ضرورية للفصل في الدعوى.
ويهدف هذا الوقف إلى تحقيق العدالة من خلال تمكين الأطراف من تقديم الأدلة أو الحصول على تقارير الخبراء أو الاطلاع على مستندات مؤثرة في القضية .
يظل الوقف مؤقتًا، ويتم استئناف سير الدعوى بمجرد زوال السبب الذي أدى إليه، مما يضمن تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في النزاع وإتاحة الفرصة لتقديم دفاع متكامل.
شروط الوقف التعليقي :
يشترط للوقف التعليقي للخصومة عدة شروط أساسية لضمان تطبيقه بصورة صحيحة، أولها أن يكون الفصل في الدعوى مرتبطًا بمسألة أخرى لم يُفصل فيها بعد، بحيث يكون الحكم في القضية الأصلية متوقفًا على نتيجة هذه المسألة .
ثانيًا، يجب أن تكون هذه المسألة محل نظر أمام جهة قضائية أخرى أو تتطلب إجراءً قانونيًا لم يكتمل بعد. ثالثًا، تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في تقرير الوقف، بحيث توازن بين ضرورة الانتظار وبين عدم تعطيل العدالة. وأخيرًا، بمجرد زوال السبب الذي أدى إلى الوقف، يحق لأي من الخصوم تعجيل نظر الدعوى واستئناف إجراءاتها.
الشرط الأول : أن تثار مسألة أولية :
يشترط للوقف التعليقي أن تثار مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الأصلية، أي أن تكون هناك نقطة قانونية أو واقعية تحتاج إلى حسم أولًا قبل أن تتمكن المحكمة من إصدار حكمها. وتكون هذه المسألة خارجة عن نطاق الدعوى المنظورة ولكنها تؤثر بشكل مباشر على نتيجتها .
على سبيل المثال، إذا كانت هناك دعوى مدنية تتعلق بتعويض عن ضرر ناشئ عن تزوير، وكان هناك نزاع جنائي جارٍ حول ثبوت التزوير، فإن المحكمة المدنية قد توقف الدعوى لحين الفصل في القضية الجنائية، لأن الحكم في المسألة الأولية (التزوير) يؤثر بشكل جوهري على الحكم النهائي في الدعوى الأصلية.
الشرط الثاني : أن تخرج المسألة الأولية عن ولاية أو إختصاص المحكمة :
يشترط للوقف التعليقي أن تكون المسألة الأولية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى خارجة عن ولاية أو اختصاص المحكمة التي تنظر القضية الأصلية، أي أن المحكمة لا تملك سلطة الفصل فيها بشكل مباشر .
ويحدث ذلك عندما تكون هذه المسألة منظورة أمام جهة قضائية أخرى مختصة بالفصل فيها، مثل محكمة جنائية أو محكمة إدارية أو جهة رسمية مختصة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك دعوى مدنية تتعلق بصحة عقد بيع، وكان هناك طعن بالتزوير على العقد أمام المحكمة الجنائية، فإن المحكمة المدنية لا يمكنها البت في صحة العقد قبل صدور حكم في التزوير، لأن الفصل في الجرائم الجنائية يخرج عن اختصاصها .
في هذه الحالة، يتم وقف الدعوى لحين صدور حكم نهائي في المسألة الأولية من الجهة المختصة.
الشرط الثالث : أن تأمر المحكمة بوقف الخصومة الأصلية :
يشترط للوقف التعليقي أن تصدر المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية قرارًا بوقف الخصومة، إذ لا يتم الوقف تلقائيًا بل يتطلب أمرًا قضائيًا صريحًا .
وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في هذا الشأن، حيث تقيّم ما إذا كان الفصل في الدعوى الأصلية يتوقف بشكل جوهري على نتيجة المسألة الأولية المنظورة أمام جهة أخرى .
فإذا رأت المحكمة أن حسم هذه المسألة ضروري لإصدار حكم عادل، فإنها تأمر بوقف الخصومة حتى يتم البت فيها. ويظل قرار الوقف ساريًا إلى أن يزول السبب الذي أدى إليه، وبعد ذلك يحق لأي من الخصوم طلب استئناف السير في الدعوى الأصلية.
ليس للوقف التعليقي مدة معينة :
يتميز الوقف التعليقي بعدم وجود مدة محددة ينقضي بانتهائها، بل يستمر طالما أن السبب الذي أدى إلى الوقف ما زال قائمًا .
ويرجع ذلك إلى طبيعة الوقف التعليقي، حيث يرتبط الفصل في الدعوى الأصلية بحسم مسألة أولية أمام جهة أخرى، مما يعني أن مدة الوقف تتوقف على الفترة التي تستغرقها تلك الجهة في إصدار قرارها أو حكمها النهائي.
وبمجرد زوال سبب الوقف، سواء بصدور الحكم أو انتهاء النزاع في المسألة الأولية، يصبح للخصوم الحق في طلب استئناف الدعوى الأصلية دون الحاجة إلى مدة زمنية محددة لاستمرار الوقف.
عدم إمتداد أثر الحكم بسقوط الخصومة أو بانقضائها بمضى المدة إلى حكم الوقف :
لا يمتد أثر الحكم بسقوط الخصومة أو بانقضائها بمضي المدة إلى حكم الوقف التعليقي، نظرًا لاختلاف الطبيعة القانونية لكل منهما .
فسقوط الخصومة أو انقضاؤها يكون بسبب عدم اتخاذ أي إجراء فيها لمدة معينة يحددها القانون، مما يؤدي إلى إنهائها بقوة القانون أو بناءً على طلب أحد الخصوم. أما الوقف التعليقي، فهو إجراء مؤقت تفرضه المحكمة بسبب ارتباط الدعوى بمسألة أولية لم يُفصل فيها بعد، وبالتالي فإن فترة الوقف لا تُحسب ضمن المدد المؤدية إلى سقوط الخصومة، لأن الخصوم لا يكونون في حالة تقاعس، بل يكونون ملزمين بانتظار الفصل في المسألة المعلقة لاستئناف الدعوى الأصلية.
الحكم بوقف الدعوى حكم قطعي فرعي يجوز إستئنافة على إستقلال عملا بالمادة 212 مرافعات :
يُعتبر الحكم الصادر بوقف الدعوى حكمًا قطعيًا فرعيًا، مما يعني أنه يفصل في مسألة إجرائية دون إنهاء النزاع برمته .
وبموجب المادة 212 من قانون المرافعات المصري، يجوز استئناف هذا الحكم على استقلال، حيث تنص على أن الأحكام الصادرة في شق من الدعوى أو الأحكام التي تنهي الخصومة في جزء منها يجوز الطعن عليها فور صدورها .
ونظرًا لأن وقف الدعوى يؤثر على سير الخصومة ويترتب عليه تعليق الإجراءات إلى حين الفصل في المسألة الأولية، فإنه يُعد حكمًا قابلًا للاستئناف، ما لم يكن الوقف وجوبيًا، حيث يكون حينها ملزمًا للمحكمة ولا يجوز الطعن عليه.
وقف الخصومة بقوة القانون :
يحدث وقف الخصومة بقوة القانون عندما ينص القانون صراحة على تعليق سير الدعوى في حالات معينة، دون الحاجة إلى صدور حكم من المحكمة بذلك .
ومن أبرز هذه الحالات، وفاة أحد الخصوم، فقدان الأهلية، أو زوال صفة من يمثل الخصم قانونيًا، حيث يؤدي أي من هذه الأسباب إلى وقف الدعوى تلقائيًا حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل إدخال الورثة أو تعيين ممثل قانوني جديد .
ويهدف هذا الوقف إلى حماية حقوق الخصوم وضمان استكمال سير الدعوى بشكل عادل بعد زوال السبب القانوني الذي أدى إلى توقفها، ثم تستأنف الخصومة بمجرد تصحيح الأوضاع الإجرائية المطلوبة.
المادة 130 أنقطاع الخصومة :
انقطاع الخصومة هو توقف سير الدعوى القضائية تلقائيًا بحكم القانون عند وقوع أحداث تؤثر على أحد الخصوم أو من ينوب عنه، مثل وفاة أحد الأطراف، فقدان الأهلية القانونية، أو زوال صفة النائب القانوني. ويترتب على ذلك تعليق جميع الإجراءات إلى حين إدخال الخلف القانوني أو تعيين ممثل جديد للطرف المتأثر. ومع ذلك، إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم، أي استُكملت المرافعات ولم يتبقَ سوى النطق بالحكم، فلا ينقطع سير الخصومة. يهدف هذا النظام إلى حماية حقوق الخصوم وضمان عدالة التقاضي، مما يمنع صدور أحكام ضد أشخاص غير قادرين على الدفاع عن مصالحهم القانونية. الوكالة الأولى .
المادة 130 من قانون المرافعات: أثر انقطاع الخصومة وأحكامها
يعتبر قانون المرافعات أحد القوانين الأساسية التي تنظم سير الدعاوى القضائية، ويحدد كيفية مباشرة الخصومة بين الأطراف المختلفة. ومن بين الأحكام الهامة التي يتناولها هذا القانون، المادة 130، التي تعالج مسألة انقطاع سير الخصومة بسبب ظروف معينة تؤثر على أحد الخصوم أو ممثليه القانونيين.
النص القانوني للمادة 130(1)
تنص المادة 130(1) من قانون المرافعات على ما يلي:
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى .
شرح المادة 130 :
تتناول هذه المادة أحوال انقطاع الخصومة في الدعاوى القضائية، وذلك لحماية حقوق الأطراف وضمان تحقيق العدالة. وتوضح المادة أن الخصومة تنقطع تلقائيًا في الحالات التالية:
- وفاة أحد الخصوم: إذا توفي أحد أطراف الدعوى، يتوقف سير الإجراءات إلى حين إدخال الورثة أو من يمثلهم قانونيًا.
- فقدان الأهلية القانونية: يشمل ذلك الحالات التي يصبح فيها أحد الأطراف غير قادر على التقاضي بسبب فقدان الأهلية المدنية، مثل الحجر عليه لجنون أو عته.
- زوال صفة النائب القانوني: إذا كان أحد الأطراف يمثله وكيل أو وصي أو قيم، ثم زالت صفته لأي سبب، تنقطع الخصومة حتى تعيين ممثل جديد.
الإستثناء من القاعدة :
وضعت المادة استثناءً مهمًا، حيث لا ينقطع سير الخصومة إذا كانت الدعوى قد وصلت إلى مرحلة تهيئها للحكم في الموضوع، أي أن المحكمة استكملت المرافعات ولم يبقَ سوى النطق بالحكم. في هذه الحالة، تستمر الإجراءات دون الحاجة إلى إدخال ورثة أو ممثلين جدد.
آثار انقطاع الخصومة :
عند تحقق أحد أسباب انقطاع الخصومة، يترتب على ذلك:
- توقف جميع الإجراءات تلقائيًا دون الحاجة إلى صدور قرار من المحكمة.
- عدم اتخاذ أي إجراءات قضائية جديدة إلى حين تعيين ممثل قانوني أو إدخال الورثة.
- إمكانية استئناف السير في الخصومة بمجرد تقديم طلب بذلك من أحد الأطراف، شريطة استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
كيفية استئناف الخصومة بعد انقطاعها :
يمكن استئناف الخصومة من خلال تقديم طلب إلى المحكمة لإعادة السير في الدعوى، ويشترط الآتي:
- إثبات سبب الانقطاع (مثل تقديم شهادة وفاة أو حكم قضائي بفقدان الأهلية).
- إدخال الورثة أو الممثل القانوني الجديد للطرف الذي انقطعت الخصومة بسببه.
- إعلان باقي الخصوم بالطلب لاستئناف السير في الدعوى.
الفرق بين انقطاع الخصومة ووقف الخصومة :
يختلف انقطاع الخصومة عن وقف الخصومة، حيث إن:
- الانقطاع يحصل بقوة القانون ودون حاجة إلى طلب من الخصوم.
- الوقف يتم بناءً على طلب أحد الخصوم أو باتفاقهم، أو لوجود أسباب تستدعي ذلك، مثل انتظار حكم في مسألة أولية تؤثر على موضوع الدعوى.
أهمية المادة 130 في تحقيق العدالة :
تعتبر المادة 130 من الضمانات الإجرائية المهمة في التقاضي، حيث تحقق عدة أهداف، منها:
- حماية حقوق الورثة أو الممثلين القانونيين الجدد.
- ضمان عدم إصدار أحكام ضد أشخاص غير قادرين على الدفاع عن مصالحهم.
- تحقيق التوازن بين استمرار العدالة وحماية حقوق الخصوم.
تلعب المادة 130 من قانون المرافعات دورًا جوهريًا في تنظيم سير الدعاوى القضائية وحماية حقوق الخصوم عند حدوث ظروف غير متوقعة تؤثر على استمرارية الخصومة. ومن خلال القواعد التي تحددها هذه المادة، يمكن تحقيق العدالة وضمان عدم المساس بحقوق الأطراف نتيجة وفاة أحد الخصوم أو فقدانه الأهلية القانونية.
المقصود بإنقطاع الخصومة وخصائصة وهدفه ووروده على جميع أنواع الدعاوى :
انقطاع الخصومة هو توقف سير الدعوى القضائية بحكم القانون عند حدوث أسباب قهرية تتعلق بأحد الخصوم أو من يمثله، مثل وفاة أحد الأطراف، فقدان الأهلية القانونية، أو زوال صفة النائب القانوني .
يتميز انقطاع الخصومة بعدة خصائص، أبرزها أنه يقع بقوة القانون دون الحاجة إلى طلب من الخصوم، كما يؤدي إلى وقف جميع الإجراءات تلقائيًا إلى حين تعيين من يحل محل الطرف المتأثر .
أما هدفه، فهو حماية حقوق الخصوم وضمان عدم الإضرار بأحد الأطراف نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، مما يحقق التوازن بين استمرارية التقاضي وحماية العدالة. كما أن انقطاع الخصومة يرد على جميع أنواع الدعاوى، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية أو جنائية متى توفرت أسبابه، إلا إذا كانت القضية قد تهيأت للحكم، حيث تستمر المحكمة في إصدار الحكم دون الحاجة إلى إدخال ورثة أو ممثلين جدد.
شروط أنقطاع الخصومة وأسبابه :
لوقوع انقطاع الخصومة لا بد من توافر شروط معينة، وهي: أن تكون هناك دعوى قضائية قائمة، وأن يحدث سبب من أسباب الانقطاع بعد رفع الدعوى وليس قبلها، وأن يكون السبب متعلقًا بأحد الخصوم أو من يمثله قانونًا. أما عن أسباب انقطاع الخصومة، فقد حددها القانون في ثلاث حالات رئيسية، وهي: وفاة أحد الخصوم، مما يستدعي إدخال ورثته لمواصلة الدعوى، فقدان الأهلية القانونية بسبب الجنون أو العته أو الحجر، مما يتطلب تعيين ممثل قانوني جديد، وزوال صفة النائب القانوني، مثل انتهاء ولاية الوصي أو القيم أو عزل المحامي، مما يوقف الإجراءات لحين تعيين بديل قانوني.
الشرط الأول للإنقطاع : أن يتحقق سبب من أسباب أنقطاع الخصومة :
لكي ينقطع سير الخصومة، يجب أولًا تحقق سبب قانوني يؤدي إلى الانقطاع، وهو أحد الأسباب الثلاثة المحددة في القانون، وهي: وفاة أحد الخصوم، فقدان الأهلية القانونية، أو زوال صفة النائب القانوني. ويشترط أن يقع السبب بعد رفع الدعوى وليس قبلها، حيث إنه إذا كان السبب موجودًا قبل إقامة الدعوى، فإنها تكون غير مقبولة أو تحتاج إلى تصحيح الإجراء قبل نظرها. فعلى سبيل المثال، إذا توفي المدعي قبل رفع الدعوى، لا تنعقد الخصومة أصلًا، بل يجب أن تُرفع الدعوى من ورثته مباشرة. أما إذا توفي بعد رفعها، فيترتب على ذلك انقطاع الخصومة تلقائيًا، مما يؤدي إلى وقف جميع الإجراءات إلى حين إدخال الخلف القانوني ومواصلة التقاضي.
السبب الأول للإنقطاع : وفاة أحد الخصوم :
تُعد وفاة أحد الخصوم من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الخصومة بحكم القانون، حيث يترتب عليها وقف جميع إجراءات الدعوى تلقائيًا حتى يتم إدخال الورثة أو من يحل محل المتوفى قانونيًا .
ويهدف هذا الحكم إلى حماية حقوق الورثة ومنحهم الفرصة لاتخاذ القرار بشأن متابعة الدعوى أو عدم الاستمرار فيها .
ومع ذلك، فإن هذا الانقطاع لا يحدث إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم، أي أن المرافعات قد انتهت ولم يبقَ سوى النطق بالحكم، حيث تستمر المحكمة في إصدار الحكم دون الحاجة إلى إدخال الورثة.
السبب الثاني للإنقطاع : فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي :
يحدث انقطاع الخصومة إذا فقد أحد الخصوم أهليته القانونية للتقاضي بعد رفع الدعوى، مثل تعرضه للجنون أو العته أو الحجر عليه قضائيًا، مما يجعله غير قادر على التصرف في حقوقه القانونية أو متابعة الدعوى بنفسه.
ويترتب على ذلك توقف جميع الإجراءات تلقائيًا حتى يتم تعيين ممثل قانوني عنه، مثل الوصي أو القيم، لإدخاله في الدعوى واستئناف الخصومة .
ويهدف هذا الحكم إلى حماية مصالح الشخص الذي فقد الأهلية وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده في غيابه أو دون تمثيله بشكل قانوني صحيح. ومع ذلك، إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم، فإن فقدان الأهلية لا يمنع المحكمة من إصدار حكمها.
السبب الثالث للإنقطاع : زوال الصفة في التقاضي لمن يمثل الخصم :
يحدث انقطاع الخصومة إذا زالت الصفة القانونية عن الممثل القانوني لأحد الخصوم، مثل عزل الوصي أو القيم، انتهاء ولاية الوكيل، أو فقدان المحامي وكالته عن موكله في الدعاوى التي تستوجب التمثيل القانوني .
ويترتب على ذلك توقف جميع الإجراءات تلقائيًا حتى يتم تعيين ممثل قانوني جديد للخصم، سواء كان ذلك من خلال تعيين وصي جديد أو توكيل محامٍ آخر. ويهدف هذا الحكم إلى ضمان عدم المساس بحقوق الخصوم أو اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم دون وجود من يمثلهم رسميًا. ولكن، إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم، فإن زوال الصفة لا يمنع المحكمة من إصدار حكمها.
الشرط الثاني للإنقطاع : يجب أن يتحقق سبب الإنقطاع بعد بدء الخصومة :
لكي ينقطع سير الخصومة، يشترط أن يتحقق سبب الانقطاع بعد بدء الدعوى وليس قبلها، أي بعد رفع صحيفة الدعوى وقيدها رسميًا أمام المحكمة. فإذا كان السبب موجودًا قبل رفع الدعوى، مثل وفاة المدعي قبل إقامتها أو فقدانه للأهلية مسبقًا، فإن الخصومة لا تنعقد أصلًا، ويجب أن تُرفع الدعوى مباشرة من الورثة أو الممثل القانوني المختص. أما إذا وقع سبب الانقطاع أثناء سير الدعوى، فإنه يؤدي إلى توقف جميع الإجراءات بحكم القانون حتى يتم تصحيح الوضع بإدخال الخلف القانوني أو الممثل الجديد. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان استقرار إجراءات التقاضي ومنع أي تعطيل غير مبرر لسير العدالة.
الشرط الثالث للإنقطاع : يجب أن يتحقق سبب الإنقطاع قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها :
يشترط لانقطاع الخصومة أن يقع سبب الانقطاع قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، أي قبل انتهاء جميع المرافعات وكون القضية جاهزة للفصل فيها. فإذا تحقق سبب الانقطاع، مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدانه الأهلية أو زوال صفة من يمثله، في مرحلة تبادل الدفوع والمذكرات، فإن الخصومة تنقطع تلقائيًا حتى يتم إدخال من يحل محل الطرف المتأثر.
أما إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم، أي اكتملت إجراءاتها ولم يبقَ سوى النطق بالحكم، فإن الخصومة لا تنقطع، وتستمر المحكمة في إصدار حكمها دون الحاجة إلى إدخال الورثة أو تعيين ممثل قانوني جديد، وذلك لضمان عدم تعطيل سير العدالة أو إعادة الإجراءات من البداية.
التأجيل لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الإنقطاع :
عند تحقق سبب انقطاع الخصومة، مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدانه الأهلية القانونية أو زوال صفة من يمثله، تؤجل المحكمة نظر الدعوى حتى يتم إعلان الورثة أو الممثل القانوني الجديد للخصم المتأثر .
ويهدف هذا التأجيل إلى منح الفرصة لمن يحل محل الخصم المنقطع لإعداد دفوعه واتخاذ القرار بشأن متابعة الدعوى .
ويجب أن يتم الإعلان وفقًا للإجراءات القانونية المحددة، بحيث يتم إخطار الورثة أو الممثل القانوني الجديد رسميًا بوجوب الحضور لاستكمال سير الخصومة. وخلال هذه الفترة، تتوقف جميع الإجراءات مؤقتًا إلى حين إدخال الخلف القانوني، لضمان عدم الإضرار بحقوق الأطراف ولتحقيق العدالة بين الخصوم.
إذا توفى أحد خصوم الدعوى وكأن ورثته ممثلين فيها فإن المحكمة لا تقضي بالإنقطاع ولا تكلف صاحب المصلحة بأختصامهم :
إذا توفي أحد الخصوم في الدعوى وكان ورثته ممثلين فيها بالفعل، سواء بصفتهم متدخلين أو أطرافًا أصليين في القضية، فإن المحكمة لا تقضي بانقطاع الخصومة، ولا يُلزم الطرف الآخر باختصام الورثة أو إدخالهم من جديد.
ويرجع ذلك إلى أن الغاية من انقطاع الخصومة هي حماية حق الورثة وإتاحة الفرصة لهم للدفاع عن مصالحهم، وهو ما يكون متحققًا بالفعل إذا كانوا طرفًا في الدعوى منذ البداية. وبالتالي، تستمر المحكمة في نظر الدعوى وإصدار الحكم دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية.
ينقطع سير الخصومة بصدور حكم بعقوبة جنائية على أحد الخصوم :
ينقطع سير الخصومة إذا صدر حكم بعقوبة جنائية على أحد الخصوم، متى كان هذا الحكم يؤدي إلى فقدانه لأهليته القانونية للتقاضي، مثل الأحكام التي تقضي بالسجن المؤبد أو الإعدام، أو تلك التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق المدنية .
ويترتب على ذلك توقف جميع إجراءات الدعوى تلقائيًا إلى حين تعيين من يمثل المحكوم عليه قانونًا، كالحارس القضائي أو الوصي، إذا استدعى الأمر ذلك. ويهدف هذا الانقطاع إلى حماية حقوق المحكوم عليه ومنحه الفرصة للدفاع عن مصالحه من خلال ممثل قانوني مؤهل، مع ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده في غيابه.
المادة 131 :
مادة 131 – تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة :
تنص المادة 131 على أن الدعوى تعتبر مهيأة للحكم في موضوعها عندما يكون الخصوم قد قدموا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة. وهذا يعني أن حدوث أي من الأمور التالية بعد هذه المرحلة لا يؤثر على سير الدعوى:
- وفاة أحد الخصوم
- فقدان الأهلية القانونية للخصومة
- زوال الصفة القانونية للخصومة
بمعنى آخر، إذا تمت المرافعة النهائية قبل وقوع أي من هذه الحالات، فإن الدعوى تستمر دون انقطاع، ويمكن للمحكمة إصدار حكمها في الموضوع دون الحاجة إلى إعادة الإجراءات أو إدخال ورثة المتوفى أو تعيين ممثل قانوني جديد.
هذه المادة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإجرائي ومنع تعطيل الفصل في القضايا بسبب تغييرات طارئة على أحد الخصوم.
النص القانوني للمادة 131 :
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .
تعد المادة 131 من قانون المرافعات من النصوص الإجرائية المهمة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سير الدعوى وضمان عدم تعطيل الفصل فيها بسبب ظروف طارئة تصيب أحد الخصوم. حيث تنص هذه المادة على أن الدعوى تعتبر مهيأة للحكم متى قدم الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة، حتى لو طرأت بعد ذلك أحداث قد تعرقل السير الطبيعي للدعوى، مثل وفاة أحد الخصوم، أو فقدان الأهلية القانونية، أو زوال الصفة.
مفهوم تهيئة الدعوى للحكم:
يشير مفهوم “تهيئة الدعوى للحكم” إلى المرحلة التي تصبح فيها القضية جاهزة للفصل فيها من قبل المحكمة، بعد أن يكون الخصوم قد أدلوا بجميع دفوعهم ومرافعاتهم وطلباتهم النهائية. في هذه المرحلة، يكون القاضي قد استكمل استيعاب النزاع وأصبح بإمكانه إصداره حكمًا دون الحاجة إلى مزيد من المرافعات أو الإجراءات.
أثر وفاة أحد الخصوم بعد تهيئة الدعوى للحكم :
عند وفاة أحد أطراف الدعوى بعد تقديم المرافعات النهائية، لا يتم إيقاف الدعوى أو شطبها، بل تستمر المحكمة في إصدار الحكم بناءً على ما قُدّم من طلبات وأسانيد، ولا يلزم إدخال ورثة المتوفى أو اتخاذ إجراءات قانونية جديدة. وهذا يعزز سرعة التقاضي ويمنع تعطيل العدالة بسبب وفاة أحد الخصوم.
أثر فقدان الأهلية القانونية للخصومة :
تشمل فقدان الأهلية الحالات التي يصبح فيها أحد الأطراف غير قادر قانونًا على إدارة شؤونه، مثل فقدان الأهلية بسبب الجنون أو العته أو الحجر عليه. ولكن إذا حدث ذلك بعد أن أصبحت الدعوى مهيأة للحكم، فلا يؤثر هذا على سير الدعوى، وتصدر المحكمة حكمها دون الحاجة إلى تعيين ممثل قانوني جديد.
أثر زوال الصفة القانونية للخصومة :
يقصد بزوال الصفة القانونية انتهاء صلاحية الخصم في تمثيل نفسه أو الغير في الدعوى، مثل انتهاء ولاية وصي أو وكيل قانوني. ومع ذلك، إذا تم تقديم الطلبات الختامية قبل زوال الصفة، فإن الحكم يصدر بشكل طبيعي دون أن يؤثر ذلك على مجرى القضية.
الحكمة التشريعية من المادة 131 :
تسعى هذه المادة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية:
- سرعة الفصل في الدعاوى ومنع تعطيلها بسبب ظروف شخصية قد تصيب أحد الأطراف.
- تحقيق استقرار الإجراءات القضائية بحيث لا تتأثر بتغيرات طارئة بعد اكتمال المرافعات.
- حماية حق التقاضي للأطراف الآخرين في الدعوى، بحيث لا يتضررون بسبب وفاة خصمهم أو فقدانه للأهلية.
- تقليل الإجراءات الشكلية غير الضرورية التي قد تؤخر إصدار الحكم النهائي.
تطبيقات قضائية للمادة 131 :
تطبق هذه المادة في العديد من الدعاوى التي تصل إلى مرحلة المرافعة الختامية ثم يتعرض أحد الخصوم لطارئ مثل الوفاة أو الحجر عليه. وفي هذه الحالات، تستمر المحكمة في إصدار الحكم بناءً على ما تم تقديمه من أدلة ومرافعات، دون الحاجة إلى إعادة الإجراءات من جديد.
الفرق بين انقطاع الخصومة واعتبار الدعوى مهيأة للحكم :
- انقطاع الخصومة يحدث عندما يقع سبب الانقطاع (مثل وفاة أحد الخصوم) قبل تهيئة الدعوى للحكم، مما يستوجب إدخال الورثة أو الممثل القانوني واستئناف الدعوى.
- أما إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم وفق المادة 131، فلا تنقطع الخصومة، بل تستمر المحكمة في إصدار الحكم بناءً على ما تم تقديمه.
خاتمة :
تعتبر المادة 131 من القواعد الإجرائية التي تعكس فلسفة التشريع في ضمان استمرارية التقاضي وعدم تعطيل العدالة بسبب أمور طارئة. فهي تؤكد على أن استكمال المرافعات النهائية يجعل القضية جاهزة للحكم، بغض النظر عن أي تغييرات قد تطرأ على الخصوم بعد هذه المرحلة. وتعد هذه المادة إحدى الدعائم المهمة لتحقيق العدالة الناجزة والفعالة في النظام القانوني.
المادة 132 :
مادة 132 – يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع .
المادة 132 تشير إلى أثر انقطاع الخصومة في الدعاوى القضائية. وفقًا لهذه المادة، فإن انقطاع الخصومة يؤدي إلى وقف جميع المواعيد الإجرائية التي كانت سارية في مواجهة الخصوم. كما أن أي إجراء يتم أثناء فترة الانقطاع يُعتبر باطلًا قانونيًا.
يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية من أهم القوانين التي تنظم إجراءات التقاضي، وتضمن تحقيق العدالة بين الخصوم. ومن بين الأحكام المهمة التي يتضمنها هذا القانون، المادة 132 التي تتعلق بانقطاع الخصومة وآثاره. تنظم هذه المادة الوضع القانوني الذي يترتب على انقطاع الخصومة، سواء فيما يتعلق بالمواعيد الإجرائية أو بصحة الإجراءات التي تتم خلال فترة الانقطاع.
الآثار المترتبة على إنقطاع الخصومة :
يترتب على انقطاع الخصومة وفقًا للمادة 132 من قانون المرافعات وقف جميع المواعيد القانونية المتعلقة بالدعوى، مثل مواعيد المرافعات والطعن والاستئناف، بحيث لا تُستأنف إلا بعد زوال سبب الانقطاع. كما يؤدي الانقطاع إلى بطلان جميع الإجراءات التي تتم خلال هذه الفترة، مما يعني أن أي تصرف قانوني يتم أثناء الانقطاع يُعتبر كأنه لم يكن. ولا تُستأنف الخصومة تلقائيًا، بل يجب اتخاذ إجراءات قانونية مثل إدخال الورثة أو الخلف القانوني للطرف المنقطع عنه الخصومة، وإعلانهم بمتابعة الدعوى، حتى تعود الإجراءات إلى مسارها الطبيعي.
مفهوم انقطاع الخصومة :
انقطاع الخصومة هو توقف سير الدعوى بسبب حدوث واقعة معينة تتعلق بأحد الخصوم، مما يترتب عليه وقف جميع الإجراءات مؤقتًا لحين زوال سبب الانقطاع. يحدث الانقطاع تلقائيًا دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي، وهو يختلف عن وقف الخصومة الذي يكون بناءً على طلب الخصوم أو بأمر المحكمة.
أسباب انقطاع الخصومة :
طبقًا لقانون المرافعات، يحدث انقطاع الخصومة في الحالات التالية:
- وفاة أحد الخصوم: إذا توفي أحد أطراف الدعوى، سواء كان المدعي أو المدعى عليه، تنقطع الخصومة إلى حين إدخال الورثة في القضية.
- فقدان الأهلية القانونية: مثل إصابة أحد الخصوم بمرض عقلي أو نفسي يمنعه من مباشرة الدعوى.
- زوال صفة الممثل القانوني: كحالة عزل الوكيل أو انتهاء ولاية الولي أو الوصي على القاصر.
النص القانوني للمادة 132 :
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع
تنص المادة 132 من قانون المرافعات على أن انقطاع الخصومة يترتب عليه أثران رئيسيان :
-
وقف جميع مواعيد المرافعات:
- جميع المهل القانونية المتعلقة بالإجراءات القضائية تتوقف، مثل مواعيد تقديم المستندات والمذكرات، أو مواعيد الاستئناف والطعن.
- لا يبدأ سريان المهل مرة أخرى إلا بعد زوال سبب الانقطاع وإعلان الورثة أو ممثل الخصم الجديد بمتابعة الدعوى.
-
بطلان جميع الإجراءات التي تتم أثناء الانقطاع:
- أي إجراء يتم خلال فترة الانقطاع، سواء من قبل الخصوم أو المحكمة، يكون باطلًا.
- الهدف من ذلك هو حماية حق الطرف المتأثر بانقطاع الخصومة وضمان عدم الإضرار به بسبب تغيّر وضعه القانوني.
كيفية استئناف الدعوى بعد الانقطاع :
يمكن استئناف الدعوى بعد زوال سبب الانقطاع باتباع الإجراءات التالية:
- إدخال الخلف القانوني: يتم استكمال الدعوى من قبل الورثة أو الممثل القانوني الجديد للخصم المتوفي أو فاقد الأهلية.
- إعلان الطرف الجديد: يجب أن يتم إخطار الورثة أو الممثل الجديد بضرورة متابعة الخصومة.
- استئناف الإجراءات: بمجرد دخول الطرف الجديد في الدعوى، تعود الإجراءات إلى مسارها الطبيعي وتستأنف المرافعات من النقطة التي توقفت عندها.
الفرق بين انقطاع الخصومة ووقف الخصومة :
رغم التشابه بين المفهومين، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينهما:
| وجه المقارنة | انقطاع الخصومة | وقف الخصومة |
|---|---|---|
| السبب | حدوث واقعة تؤثر على أحد الخصوم (وفاة، فقدان الأهلية، زوال الصفة القانونية) | يتم بناءً على طلب الخصوم أو المحكمة |
| التأثير على المواعيد | توقف جميع المواعيد تلقائيًا | تتوقف المواعيد باتفاق الأطراف |
| الإجراءات خلال الفترة | تكون باطلة | صحيحة ولكن متوقفة لحين انتهاء الوقف |
خاتمة :
تعتبر المادة 132 من قانون المرافعات أداة قانونية مهمة لحماية حقوق الخصوم في الدعاوى، حيث تضمن لهم عدم فوات المواعيد القانونية بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، كما تضمن عدم اتخاذ إجراءات قانونية قد تضر بأحد الأطراف أثناء فترة الانقطاع. لهذا السبب، يجب على جميع المتقاضين والمحامين فهم هذه المادة جيدًا والالتزام بأحكامها لضمان حسن سير العدالة.
المادة 133 :
مادة 133 – تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
تنص المادة 133 من قانون المرافعات على القواعد والإجراءات المتعلقة باستئناف سير الدعوى في حال وفاة أحد الخصوم أو فقدانه لأهليته القانونية أو زوال صفته. ووفقًا لنص المادة، فإن الدعوى تستأنف سيرها من خلال إعلان صحيفة إلى من يحل محل الخصم المتوفى أو من فقد أهليته أو زالت صفته، وذلك بناءً على طلب الطرف الآخر. كما يمكن استئنافها بإعلان الصحيفة إلى الطرف الآخر بناءً على طلب الخلف القانوني للخصم الذي تغيرت حالته.
علاوة على ذلك، إذا حضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى أحد الورثة أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت عنه الصفة، وتولى مباشرة السير في الدعوى، فإن ذلك يعد بمثابة استئناف طبيعي لها دون الحاجة إلى إعلان جديد. تهدف هذه القواعد إلى تحقيق الاستقرار واستمرار التقاضي دون تعطيل الإجراءات نتيجة التغيرات التي قد تطرأ على أحد أطراف النزاع.
المادة 133 من قانون المرافعات:
يعد قانون المرافعات من الركائز الأساسية لتنظيم العملية القضائية، حيث يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لضمان تحقيق العدالة وسير الدعاوى بسلاسة. ومن بين المواد المهمة في هذا القانون، تبرز المادة 133، التي تعالج مسألة استئناف الدعوى في حال وفاة أحد الخصوم أو فقدانه للأهلية أو زوال صفته القانونية. تهدف هذه المادة إلى منع توقف الدعاوى بسبب التغيرات الطارئة على أحد الأطراف، مما يضمن استمرارية التقاضي وتحقيق العدالة دون تأخير غير مبرر.
نص المادة 133 من قانون المرافعات :
تنص المادة 133 على أنه:
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها “
تحليل المادة 133 :
تتضمن هذه المادة عدة نقاط قانونية هامة، يمكن تحليلها على النحو التالي:
-
حالات انقطاع سير الدعوى
تنقطع الدعوى قانونًا إذا طرأ على أحد أطرافها أي من الحالات التالية:- وفاة أحد الخصوم: وهو ما يستلزم تحديد الورثة أو من يمثل التركة قانونيًا.
- فقدان الأهلية: أي إذا أصبح الخصم غير قادر قانونيًا على متابعة الإجراءات، كأن يصاب بجنون أو يصدر حكم بالحجر عليه.
- زوال الصفة: مثل عزل الوكيل القانوني أو انتهاء ولاية القيم أو الوصي.
-
كيفية استئناف الدعوى
- يتم استئناف الدعوى بإعلان صحيفة إلى الخلف القانوني للخصم المتوفى أو من فقد أهليته أو زالت صفته، ويكون ذلك بناءً على طلب الطرف الآخر.
- كما يجوز استئناف الدعوى إذا قام الخلف القانوني للخصم باتخاذ إجراءات مباشرة للحضور واستئناف السير فيها.
-
استئناف الدعوى دون الحاجة إلى إعلان جديد
- إذا حضر الخلف القانوني للخصم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، سواء كان وارث المتوفى أو من يحل محل من فقد الأهلية أو زالت عنه الصفة، وباشر السير في الدعوى، فإنها تستأنف سيرها تلقائيًا دون الحاجة إلى إجراءات إعلان جديدة.
أهمية المادة 133 في تحقيق العدالة :
تلعب هذه المادة دورًا هامًا في تحقيق التوازن بين استقرار الدعاوى واستمرار التقاضي من جهة، وضمان الحقوق القانونية للخلف القانوني من جهة أخرى. ومن أبرز فوائدها:
- منع تعطيل القضايا: حيث تمنع المادة تجميد الدعاوى بسبب وفاة أحد الخصوم أو فقدان أهليته، مما يساهم في سرعة الفصل في المنازعات.
- ضمان حق الخلف القانوني: تعطي المادة الفرصة للخلف القانوني لاتخاذ إجراءات متابعة الدعوى دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة.
- توفير مرونة في الإجراءات: إذ تسمح باستئناف السير في الدعوى دون الحاجة إلى تعقيدات إجرائية إضافية إذا حضر الخلف القانوني في الجلسة المحددة.
التطبيقات القضائية للمادة 133 :
في الواقع العملي، يتم تطبيق المادة 133 في العديد من القضايا المدنية والتجارية، حيث تلعب دورًا حاسمًا في الحالات التي يتغير فيها أحد أطراف النزاع. ومن التطبيقات العملية لهذه المادة:
- في حالة وفاة المدعي أثناء سير الدعوى، يحق للورثة استكمال الدعوى عن طريق تقديم طلب إعلان باستمرار السير فيها.
- إذا فقد أحد الخصوم أهليته القانونية أثناء النزاع، يمكن تعيين وصي أو قيم عليه لاستكمال الإجراءات.
- عند زوال صفة أحد الخصوم، مثل انتهاء ولاية وكيل قانوني لشركة، يمكن للخلف القانوني مباشرة الدعوى بنفس الحقوق والالتزامات.
خاتمة :
تعد المادة 133 من قانون المرافعات من الأحكام الجوهرية التي تضمن استمرارية التقاضي وعدم تعطيل سير العدالة. من خلال وضع آليات واضحة لاستئناف الدعوى، تحقق هذه المادة التوازن بين حماية الحقوق القانونية للأطراف وتجنب التأخير غير الضروري في الفصل في القضايا. ومن ثم، فإن الالتزام بتطبيق أحكامها يعد ضروريًا لضمان نزاهة وكفاءة المنظومة القضائية.
أنتهاء ركود الخصومة المنقطعة بالتعجيل أو الإنقضاء :
ينتهي ركود الخصومة المنقطعة بإحدى طريقتين رئيسيتين: التعجيل أو الانقضاء. يحدث التعجيل عندما يبادر أحد الأطراف أو الخلف القانوني للخصم المنقطع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف السير في الدعوى، مثل تقديم طلب لإعلان الخلف القانوني للخصم المتوفى أو من فقد أهليته أو زالت صفته. أما الانقضاء، فيتم إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لتعجيل الخصومة خلال المدة القانونية المحددة، مما يؤدي إلى اعتبار الدعوى كأنها لم تكن، وبالتالي زوال جميع الآثار المترتبة عليها . ويساهم هذان السبيلان في تحقيق التوازن بين استمرار التقاضي وضمان عدم بقاء النزاعات معلقة إلى أجل غير مسمى.
معاودة السير في الخصومة بأحد طريقين :
الطريق الأول : الحضور :
تتم معاودة السير في الخصومة بإحدى طريقتين، أولاهما الحضور، حيث يُعد حضور الخلف القانوني للخصم المنقطع (مثل ورثة المتوفى، أو من يقوم مقام من فقد أهليته، أو من زالت عنه الصفة) في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، ومباشرته للإجراءات، بمثابة استئناف تلقائي لسير الخصومة دون الحاجة إلى إعلان جديد. ويشترط في هذا الحضور أن يكون واضحًا وصريحًا، بحيث يتخذ الحاضر موقفًا إيجابيًا من الخصومة، مثل تقديم طلبات أو الإدلاء بدفوع، مما يؤكد رغبته في متابعة الدعوى واستئناف الإجراءات دون تأخير.
الطريق الثاني : أعلان صحيفة التعجيل :
الطريق الثاني لمعاودة السير في الخصومة هو إعلان صحيفة التعجيل، حيث يتم استئناف الدعوى من خلال تقديم صحيفة تعجيل تُعلن إلى الخلف القانوني للخصم المنقطع، سواء كان وارثًا للمتوفى، أو من يقوم مقام من فقد أهليته، أو من زالت عنه الصفة .
يتم هذا الإعلان بناءً على طلب الطرف الآخر في النزاع، أو بناءً على طلب الخلف القانوني نفسه، لضمان استئناف السير في الدعوى بشكل رسمي وقانوني .
ويعد هذا الإجراء ضروريًا في الحالات التي لا يتم فيها الحضور التلقائي للجلسة، إذ يضمن إخطار الأطراف المعنية وإعطائهم فرصة عادلة لمباشرة الدفاع عن حقوقهم واستكمال إجراءات التقاضي دون إطالة غير مبررة.
لا يشترط في صحيفة إستئناف الدعوى لسيرها بعد إنقطاع الخصومة فيها أن يوقعها محام :
لا يشترط في صحيفة استئناف الدعوى لاستكمال السير فيها بعد انقطاع الخصومة أن تكون موقعة من محامٍ، وذلك لأن الغرض الأساسي منها هو مجرد إخطار الخلف القانوني للخصم المنقطع أو الطرف الآخر بوجوب استئناف الإجراءات .
فهذه الصحيفة لا تعد عملاً إجرائيًا جوهريًا يتطلب توكيل محامٍ، وإنما تُعتبر مجرد وسيلة لإعادة تفعيل الخصومة وإعلام الأطراف المعنيين بها .
وبالتالي، يمكن لأي من الخصوم أو من يقوم مقامهم تقديمها وإعلانها دون الحاجة إلى توقيع محامٍ، ما لم يكن القانون ينص صراحة على خلاف ذلك في حالات معينة.
حضور المدعى عليه بعد تعجيل السير في الدعوى يترتب على إنعقاد الخصومة دون حاجة لإعلانه بالتعجيل حتى ولو لم يكن قد أعلن بأصل الصحيفة :
يترتب على حضور المدعى عليه بعد تعجيل السير في الدعوى انعقاد الخصومة بشكل صحيح، حتى ولو لم يكن قد تم إعلانه بصحيفة التعجيل أو بأصل صحيفة الدعوى. فالحضور الطوعي للجلسة يُعتبر بمثابة إقرار ضمني بإعادة السير في الخصومة، مما يغني عن أي إجراءات إعلان جديدة. ويستند هذا المبدأ إلى أن الهدف من الإعلان هو تحقيق علم الخصم بالدعوى وإتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه، وهو ما يتحقق بالحضور الفعلي. وبذلك، يصبح التعجيل منتجًا لآثاره القانونية بمجرد الحضور، دون الحاجة إلى إعادة إعلانه رسميًا، مما يضمن استمرارية التقاضي ويمنع تعطيل الإجراءات بسبب متطلبات شكلية غير ضرورية.
المادة 134 سقوط الخصومة وأنقضاؤها بمضى المدة :
تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أن “السقوط في الخصومة يحدث إذا انقضت مدة معينة دون اتخاذ أي إجراء في الدعوى، مما يؤدي إلى انقضائها بمضي المدة”. ويهدف هذا النص إلى تحقيق الاستقرار القانوني ومنع استمرار النزاعات القضائية دون حسمها.
سقوط الخصومة يُعد جزاءً إجرائيًا يترتب على إهمال الطرف المدعي في متابعة دعواه، ويختلف عن انقضاء الدعوى الموضوعية التي قد تزول بأسباب أخرى كالتسوية أو الحكم النهائي. يترتب على السقوط إنهاء الخصومة دون المساس بالحق الموضوعي للمدعي، حيث يمكنه إعادة رفع الدعوى طالما لم يسقط الحق ذاته بالتقادم.
المادة 134 من قانون المرافعات: سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة :
تُعد المادة 134 من قانون المرافعات المصري أحد الأحكام التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدعي في المطالبة بحقه ومصلحة المدعى عليه في عدم ترك الدعوى معلقة إلى أجل غير مسمى. حيث تقرر هذه المادة سقوط الخصومة في حالة عدم قيام المدعي باتخاذ أي إجراء في الدعوى خلال مدة معينة، مما يؤدي إلى انقضائها بمضي المدة.
النص القانوني للمادة 134 :
تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه:
لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي
مفهوم سقوط الخصومة :
سقوط الخصومة هو جزاء قانوني يترتب على إهمال المدعي في متابعة دعواه، حيث يؤدي إلى انقضاء الخصومة الإجرائية وليس الحق الموضوعي ذاته. أي أن الدعوى لا تنتهي بحكم قضائي في موضوعها، بل تُعتبر كأنها لم تُرفع من الأساس بسبب تقاعس المدعي عن السير في إجراءاتها.
شروط سقوط الخصومة وفق المادة 134
لكي يتم الحكم بسقوط الخصومة وفق المادة 134، يجب توافر الشروط التالية:
- عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه: أي أن يكون سبب التوقف في الإجراءات راجعًا إلى المدعي، وليس بسبب قوة قاهرة أو خطأ من المحكمة.
- مرور مدة ستة أشهر: يجب أن يمر ستة أشهر كاملة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الدعوى دون أي تحرك من المدعي.
- تقديم طلب من أحد الخصوم: لا يُحكم بسقوط الخصومة تلقائيًا، بل يجب أن يتقدم المدعى عليه أو أي خصم في الدعوى بطلب إلى المحكمة للحكم بالسقوط.
الآثار القانونية لسقوط الخصومة
عند الحكم بسقوط الخصومة، تترتب الآثار التالية:
- انقضاء الخصومة الإجرائية: تُعتبر الخصومة منتهية من الناحية الإجرائية دون المساس بالحق الموضوعي.
- إمكانية إعادة رفع الدعوى: يجوز للمدعي إعادة رفع الدعوى إذا لم يكن الحق ذاته قد سقط بالتقادم، ولكن بشرط سداد الرسوم القضائية مرة أخرى.
- عدم تأثير السقوط على الأحكام السابقة: إذا صدر أي حكم في الدعوى قبل السقوط، فإنه يبقى صحيحًا وساريًا.
الفرق بين سقوط الخصومة وانقضائها بالتقادم
- سقوط الخصومة: يتعلق بالإجراءات القضائية، ويعني انتهاء سير الدعوى بسبب إهمال المدعي في تحريكها.
- التقادم: يتعلق بالحق الموضوعي ذاته، ويؤدي إلى سقوط الحق في المطالبة به بعد مرور مدة معينة يحددها القانون.
الاستثناءات من سقوط الخصومة
هناك بعض الحالات التي لا يسري فيها سقوط الخصومة، ومنها:
- إذا كان هناك عذر قانوني يمنع المدعي من السير في الدعوى.
- إذا كان التوقف ناتجًا عن المحكمة أو قوة قاهرة.
خاتمة :
تُعد المادة 134 من قانون المرافعات ضمانة قانونية لتحقيق العدالة ومنع تكدس القضايا دون مبرر. فهي تُلزم المدعين بمتابعة دعاواهم بجدية، وفي الوقت نفسه تحمي المدعى عليهم من إطالة أمد النزاعات بشكل غير مبرر. ومع ذلك، فإن السقوط لا يمس الحق الموضوعي، مما يتيح للمدعي فرصة أخرى لإقامة دعواه إذا لم يكن قد سقط بالتقادم.
التعريف بسقوط الخصومة وعلته والتفرقة بينه وبين سقوط حق الدعوى بالتقادم :
سقوط الخصومة هو جزاء قانوني يترتب على إهمال المدعي في متابعة دعواه لفترة زمنية معينة، حيث يؤدي إلى انقضاء الخصومة الإجرائية دون المساس بالحق الموضوعي ذاته. ويهدف هذا السقوط إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدعي في المطالبة بحقه، ومصلحة المدعى عليه في عدم ترك الدعوى معلقة لفترة طويلة دون مبرر. وتنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يقم المدعي بأي إجراء في الدعوى لمدة ستة أشهر، جاز للمدعى عليه طلب الحكم بسقوطها.
أما التفرقة بين سقوط الخصومة وسقوط حق الدعوى بالتقادم، فتتمثل في أن سقوط الخصومة يتعلق بالإجراءات القضائية ويؤدي فقط إلى إنهاء سير الدعوى دون التأثير على الحق الموضوعي، مما يسمح للمدعي بإعادة رفع الدعوى إذا لم يكن قد سقط بالتقادم. بينما التقادم يؤدي إلى زوال الحق ذاته بعد مرور مدة زمنية محددة يحددها القانون، مما يمنع المطالبة به أمام القضاء نهائيًا.
سريان السقوط على كل خصومة ماعدا النقض وسريانه في مواجهة كافة الأشخاص :
يطبق سقوط الخصومة كقاعدة عامة على جميع أنواع الخصومات القضائية، حيث يسري على كافة الدعاوى التي يُهمل المدعي في تحريك إجراءاتها لمدة ستة أشهر وفقًا لنص المادة 134 من قانون المرافعات. ويترتب على ذلك انقضاء الخصومة من الناحية الإجرائية، مع احتفاظ المدعي بحقه في رفع الدعوى مجددًا ما لم يكن قد سقط بالتقادم.
إلا أن هذا السقوط لا يسري على دعاوى الطعن أمام محكمة النقض، حيث يتم استثناؤها نظرًا لطبيعتها الخاصة، والتي تتطلب استقرار الأحكام وعدم خضوعها لذات القواعد المنظمة لسقوط الخصومة في الدرجات الأدنى من التقاضي.
كما أن سقوط الخصومة يسري في مواجهة جميع الخصوم، سواء كانوا أفرادًا أو جهات اعتبارية، ولا يقتصر على طرف معين في الدعوى، مما يعني أن أي خصم له مصلحة في إنهاء الخصومة يمكنه التمسك بالسقوط وطلب الحكم به أمام المحكمة المختصة.
شروط سقوط الخصومة :
يشترط لسقوط الخصومة توافر ثلاثة عناصر أساسية وفقًا لنص المادة 134 من قانون المرافعات، وهي:
-
عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه: يجب أن يكون التوقف عن اتخاذ الإجراءات في الخصومة راجعًا إلى تقاعس المدعي أو عدم مبادرته بمتابعة دعواه، وليس بسبب قوة قاهرة أو تصرف من المحكمة.
-
مرور ستة أشهر متصلة دون أي إجراء صحيح: يجب أن تمضي ستة أشهر كاملة من تاريخ آخر إجراء صحيح في الدعوى دون أن يقوم المدعي بأي خطوة لإعادة تحريكها، مما يدل على إهماله في متابعتها.
-
تقديم طلب من أحد الخصوم: لا يُحكم بسقوط الخصومة تلقائيًا، بل يجب على المدعى عليه أو أي خصم في الدعوى تقديم طلب إلى المحكمة للحكم بالسقوط، حيث لا يُعتبر من النظام العام ولا تلتفت إليه المحكمة من تلقاء نفسها.
بتحقق هذه الشروط، يجوز للمحكمة الحكم بسقوط الخصومة، مما يؤدي إلى إنهاء الإجراءات القضائية المتعلقة بها، مع احتفاظ المدعي بحقه في رفع الدعوى من جديد ما لم يكن قد سقط بالتقادم.
الشرط الأول لسقوط الخصومة : أن تكون الخصومة قائمة :
لكي يُحكم بسقوط الخصومة وفقًا للمادة 134 من قانون المرافعات، يجب أولًا أن تكون الخصومة قائمة أمام القضاء، أي أن تكون الدعوى قد رُفعت بالفعل وظلت منظورة أمام المحكمة دون صدور حكم فاصل في موضوعها. فإذا انتهت الدعوى بحكم نهائي أو تم شطبها ولم تُجدد خلال المدة القانونية، فلا مجال للحديث عن سقوط الخصومة، إذ إن السقوط لا ينطبق إلا على الدعوى التي لا تزال مستمرة لكنها متوقفة بسبب إهمال المدعي.
وبذلك، فإن الخصومة يجب أن تكون قائمة بإجراءات صحيحة، بحيث تكون المحكمة لا تزال مختصة بنظرها، ولم يصدر فيها حكم منهي لها أو يتم حفظها لأي سبب آخر. فإذا زالت الخصومة لأي سبب آخر غير السقوط، كالتصالح بين الأطراف أو التنازل عن الدعوى، فلا يكون هناك مجال لتطبيق جزاء السقوط.
الشرط الثاني لسقوط الخصومة : عدم السير فيها لمدة ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها :
يُشترط للحكم بسقوط الخصومة أن تمر ستة أشهر متصلة دون أن يقوم المدعي أو من يمثله قانونًا بأي إجراء صحيح يهدف إلى تحريك الدعوى. يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم اتخاذه في الخصومة، سواء كان هذا الإجراء صادرًا من المدعي نفسه أو من المحكمة بناءً على طلبه.
ولا يُحتسب ضمن هذه المدة أي توقف يكون ناتجًا عن سبب خارج عن إرادة المدعي، مثل صدور قرار بوقف الدعوى تعليقًا أو وجود قوة قاهرة حالت دون السير فيها. كما أن الإجراءات غير الصحيحة أو التي ليس من شأنها تحريك الدعوى لا تقطع هذه المدة، فالعبرة بالإجراءات الجدية التي تدل على متابعة الدعوى بجدية أمام المحكمة.
وعند انقضاء ستة أشهر دون اتخاذ أي إجراء صحيح، يحق للمدعى عليه أو أي خصم في الدعوى أن يتقدم بطلب إلى المحكمة للحكم بسقوط الخصومة، مما يؤدي إلى إنهائها إجرائيًا مع احتفاظ المدعي بحقه في رفعها مجددًا ما لم يكن قد سقط بالتقادم.
الشرط الثالث لسقوط الخصومة : أن يكون عدم السير في الخصومة بإهمال من المدعى أى بفعله أو إمتناعه :
لكي يُحكم بسقوط الخصومة، يجب أن يكون التوقف عن السير فيها ناتجًا عن إهمال المدعي أو امتناعه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة دعواه. بمعنى أن يكون هو المسؤول عن تعطل سير الخصومة، سواء بعدم المبادرة إلى تقديم المستندات المطلوبة، أو عدم القيام بالإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى.
أما إذا كان التوقف راجعًا إلى سبب خارج عن إرادة المدعي، مثل صدور قرار بوقف الدعوى تعليقًا، أو خطأ من المحكمة، أو ظروف قاهرة حالت دون متابعة الإجراءات، فلا يسري عليه السقوط، لأن القانون لا يُرتب الجزاء إلا على التقاعس المتعمد أو الإهمال.
ويُشترط أيضًا ألا يكون المدعى عليه هو المتسبب في تعطيل السير في الدعوى، لأن سقوط الخصومة هو جزاء يقع على المدعي الذي لم يُبدِ جدية في متابعة دعواه، وليس على الطرف الذي يتلقى الدعوى. وعند تحقق هذا الشرط، يجوز للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم بسقوط الخصومة، مما يؤدي إلى إنهائها إجرائيًا، مع بقاء الحق الموضوعي للمدعي ما لم يكن قد سقط بالتقادم.
الشرط الرابع للسقوط الخصومة : ألا يتخذ خلال الستة أشهر التي تسقط الخصومة بإنقضائها أى إجراء يقصد به موالاة السير فيها :
يشترط لسقوط الخصومة ألا يقوم المدعي بأي إجراء صحيح يدل على رغبته في متابعة الدعوى خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة 134 من قانون المرافعات. فإذا قام المدعي خلال هذه الفترة باتخاذ أي إجراء جدي يكون من شأنه تحريك الخصومة، فإن مدة السقوط تُقطع، ولا يجوز للمدعى عليه طلب الحكم بالسقوط.
يجب أن يكون الإجراء صحيحًا ومرتبطًا بالدعوى، مثل تقديم مذكرات دفاع، طلب تحديد جلسة، أو تقديم مستندات مطلوبة، ولا يُعتد بالإجراءات الشكلية أو غير المؤثرة، مثل تقديم طلبات غير منتجة أو ناقصة. كما أن الإجراءات التي تصدر عن المحكمة من تلقاء نفسها لا تكفي لقطع المدة، إذ يُشترط أن يكون الإجراء صادرًا عن المدعي أو بناءً على طلبه.
وبذلك، إذا انقضت ستة أشهر كاملة دون قيام المدعي بأي إجراء حقيقي لمتابعة الدعوى، يكون للمدعى عليه أو أي خصم آخر الحق في تقديم طلب للمحكمة للحكم بسقوط الخصومة، مما يؤدي إلى إنهائها من الناحية الإجرائية، مع بقاء الحق الموضوعي قائمًا ما لم يكن قد سقط بالتقادم.
الشرط الخامس للسقوط : التمسك به آي أن يطلب السقوط المدعى عليه ومن حكمه :
سقوط الخصومة لا يُحكم به تلقائيًا من قبل المحكمة، بل يجب أن يتمسك به المدعى عليه أو أي خصم له مصلحة في إنهاء الدعوى. أي أن المحكمة لا تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها، وإنما يتعين على المدعى عليه التقدم بطلب رسمي يطلب فيه الحكم بسقوط الخصومة بسبب عدم السير فيها خلال المدة القانونية المحددة بستة أشهر.
ويعتبر السقوط حقًا للمدعى عليه، فإن لم يتمسك به أمام المحكمة وظل صامتًا أو واصل الدفاع في الدعوى، فإنه يُعد متنازلًا ضمنيًا عن حقه في طلب السقوط، وتستمر الدعوى بشكل طبيعي. ويجوز التمسك بالسقوط في أي مرحلة من مراحل الدعوى طالما لم يقم المدعي بأي إجراء صحيح لتحريك الخصومة قبل تقديم الطلب.
أما بالنسبة لحكم السقوط، فإنه يؤدي إلى إنهاء الخصومة إجرائيًا فقط دون أن يمس أصل الحق الموضوعي، مما يتيح للمدعي إعادة رفع الدعوى من جديد ما لم يكن قد سقط حقه بالتقادم.
المادة 135 :
مادة 135 – لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقـد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي:
تنص المادة 135 من قانون المرافعات على أنه لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي يقوم فيه الطرف الذي يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه المتوفى، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. وتأتي هذه المادة لضمان عدم الإضرار بأطراف الدعوى نتيجة لظروف خارجة عن إرادتهم، مثل الوفاة أو فقدان الأهلية، حيث تمنح الورثة أو من يحل محل الطرف المنقطع فرصة كاملة لمباشرة الدعوى قبل بدء احتساب مدة السقوط، مما يحقق التوازن بين مصالح الخصوم ويكفل حسن سير العدالة.
تعد المادة 135 من قانون المرافعات المصري إحدى المواد المهمة التي تنظم مسألة انقطاع الخصومة وآثاره، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخصوم وضمان عدم الإضرار بأحد الأطراف نتيجة ظروف قهرية، مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدانه الأهلية. وتتناول هذه المادة بشكل دقيق متى يبدأ احتساب مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع، مما يضمن تحقيق العدالة ويمنع أي تلاعب بالإجراءات القضائية.
نص المادة 135
تنص المادة 135 من قانون المرافعات على ما يلي:
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقـد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
تحليل المادة 135
مفهوم انقطاع الخصومة :
انقطاع الخصومة هو توقف السير في الدعوى بسبب حدوث سبب قانوني يؤثر على أحد أطرافها، مثل وفاة أحد الخصوم، أو فقدانه للأهلية القانونية، أو زوال صفته. ويترتب على الانقطاع وقف جميع الإجراءات القضائية حتى يتم تحديد من يحل محل الطرف المنقطع.
أسباب انقطاع الخصومة :
وفقًا للقانون، تنقطع الخصومة في الحالات التالية:
- وفاة أحد الخصوم: إذا توفي أحد أطراف الدعوى، فإن إجراءاتها تتوقف حتى يتم تحديد الورثة وإدخالهم في الخصومة.
- فقدان الأهلية القانونية: إذا فقد أحد الخصوم أهليته للخصومة بسبب إصابته بعارض من عوارض الأهلية، كالعته أو الجنون، تنقطع الدعوى إلى حين تعيين من ينوب عنه قانونًا.
- زوال الصفة القانونية: إذا فقد أحد الخصوم صفته في الدعوى، مثل زوال صفة الوكيل أو الممثل القانوني، فإن الخصومة تنقطع إلى حين تحديد من يحل محله.
متى تبدأ مدة سقوط الخصومة؟
توضح المادة 135 أن المدة المقررة لسقوط الخصومة لا تبدأ فور حدوث سبب الانقطاع، بل تبدأ فقط من تاريخ إعلان من يطلب الحكم بسقوط الخصومة للطرف الآخر أو ورثته أو من يقوم مقامه.
وهذا يعني أنه لا يمكن اعتبار الدعوى ساقطة قبل أن يتم إخطار الورثة أو من يحل محل الخصم الأصلي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم أو مفاجأة غير عادلة للورثة أو الخلف القانوني.
الهدف من المادة 135 :
تسعى المادة 135 إلى تحقيق عدة أهداف قانونية مهمة، من بينها:
- حماية حقوق الخصوم: فمن غير العدل احتساب مدة السقوط في غياب من يحق له مباشرة الخصومة.
- تحقيق التوازن بين الأطراف: بحيث لا يستفيد الطرف الآخر من الانقطاع للإضرار بالورثة أو الخلف القانوني.
- ضمان استمرارية العدالة: فمن خلال تنظيم بدء مدة السقوط، يتم الحفاظ على حق التقاضي وعدم إهدار حقوق المتقاضين.
الفرق بين سقوط الخصومة وانقضائها :
- سقوط الخصومة: هو جزاء إجرائي يقع على المدعي بسبب عدم السير في الدعوى خلال مدة معينة بعد انقطاعها.
- انقضاء الخصومة: يحدث نتيجة لسبب قانوني مثل صدور حكم نهائي في الدعوى أو التنازل عنها.
أثر تطبيق المادة 135 في الواقع العملي :
عند تطبيق هذه المادة في المحاكم، يلتزم الطرف الذي يريد الحكم بسقوط الخصومة بإعلان الورثة أو الخلف القانوني بشكل صحيح. وإذا لم يتم هذا الإعلان، فلا تبدأ مدة السقوط، مما يضمن عدم التلاعب بالإجراءات القضائية.
كذلك، تساعد هذه المادة في حماية حقوق الورثة، حيث تمنحهم فرصة قانونية عادلة لمتابعة الدعوى، بدلاً من إسقاط الخصومة عليهم دون علمهم بها.
الخاتمة :
تعتبر المادة 135 من قانون المرافعات المصري من المواد الجوهرية التي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الخصوم، حيث تمنع سقوط الخصومة تلقائيًا بمجرد حدوث سبب الانقطاع، بل تشترط الإعلان الرسمي لمن يحل محل الطرف المنقطع قبل بدء احتساب المدة. وهذا يعكس مبدأ أساسيًا في القانون، وهو حماية حقوق المتقاضين وضمان عدم إساءة استخدام الإجراءات القانونية.
بدء مدة سقوط الخصومة في حالات الإنقطاع :
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي يقوم فيه الطرف الذي يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه المتوفى، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو من زالت صفته، بوجود الدعوى بينهم وبين الخصم الأصلي. ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضمان عدم الإضرار بأحد الخصوم نتيجة أسباب خارجة عن إرادته، كما يمنح الخلف القانوني فرصة عادلة لمباشرة الدعوى قبل احتساب مدة السقوط، مما يعزز مبادئ العدالة وحماية الحقوق الإجرائية للمتقاضين.
المادة 136
مادة 136 – يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة .ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.
تنص المادة 136 من قانون المرافعات على أن طلب الحكم بسقوط الخصومة يُقدَّم إلى المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. كما تجيز هذه المادة التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا قام المدعي بتعجيل دعواه بعد مرور سنة على وقف السير فيها دون اتخاذ أي إجراء لاستمرارها. ويُشترط لقبول الطلب أو الدفع أن يكون موجهاً ضد جميع المدعين أو المستأنفين، وإلا اعتُبر غير مقبول. تهدف هذه القاعدة إلى تحقيق العدالة وضمان عدم تعطيل الإجراءات القضائية لفترات طويلة دون مبرر مشروع.
المادة 136 من قانون المرافعات: سقوط الخصومة وضوابطه :
تُعَدّ الخصومة القضائية إحدى الركائز الأساسية لضمان حقوق المتقاضين في النظام القانوني، حيث تتيح للأطراف اللجوء إلى القضاء لحسم النزاعات وفقاً للإجراءات القانونية المقررة. ومع ذلك، قد تواجه الخصومة بعض العوائق التي تؤدي إلى تعطيل سيرها لفترة طويلة، وهو ما استدعى وضع قواعد قانونية تنظم سقوطها لضمان استمرارية العدالة وعدم تعطيل الفصل في القضايا دون مبرر مشروع. ومن هذا المنطلق، جاءت المادة 136 من قانون المرافعات المصري لتحدد الأحكام المنظمة لسقوط الخصومة والضوابط المرتبطة بها.
نص المادة 136 من قانون المرافعات:
تنص المادة 136 على ما يلي:
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة .
ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.
شرح أحكام المادة 136
كيفية تقديم طلب سقوط الخصومة :
وفقاً للمادة 136، يتم تقديم طلب سقوط الخصومة بنفس الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي من خلال صحيفة دعوى تُقدَّم إلى المحكمة المختصة. ويجب أن يكون الطلب مستوفياً لكافة الشروط القانونية، بما في ذلك بيان أسباب طلب السقوط والمدة التي توقفت فيها الخصومة دون اتخاذ أي إجراء لتعجيلها.
التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع :
لا يقتصر التمسك بسقوط الخصومة على تقديم طلب مستقل، بل يمكن أن يُثار كسلاح دفاعي من قبل المدعى عليه في صورة دفع إذا قام المدعي بتعجيل دعواه بعد انقضاء السنة دون اتخاذ أي إجراءات سابقة لاستمرارها. ويعتبر هذا الدفع وسيلة فعالة لحماية حقوق المدعى عليه من المماطلة والإهمال في السير في الخصومة.
ضرورة توجيه الطلب أو الدفع ضد جميع أطراف الخصومة :
تشترط المادة 136 أن يكون الطلب أو الدفع موجهاً ضد جميع المدعين أو المستأنفين، وإلا كان غير مقبول. والهدف من هذا الشرط هو ضمان عدم تجزئة السقوط على بعض أطراف الدعوى دون الآخرين، مما قد يؤدي إلى تعقيدات إجرائية أو تناقضات في الحكم.
الهدف من المادة 136 وأهميتها :
تهدف المادة 136 من قانون المرافعات إلى تحقيق عدة غايات قانونية، من أهمها:
- ضمان استمرارية التقاضي: تمنع المادة الخصوم من تعطيل الدعاوى وإبقائها معلقة لفترات طويلة دون مبرر، مما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة.
- حماية مصالح المدعى عليه: تعطي المادة الحق للمدعى عليه في التمسك بسقوط الخصومة، مما يحد من استغلال المدعي لحقه في التقاضي بشكل يضر بمصالح الطرف الآخر.
- إلزام المدعي بالجدية في متابعة دعواه: تجبر المادة المدعي على اتخاذ إجراءات متابعة الدعوى خلال المدة المحددة، وإلا تعرضت دعواه للسقوط.
- منع التقاضي الجزئي: من خلال اشتراط توجيه الطلب إلى جميع المدعين أو المستأنفين، تمنع المادة حدوث تضارب في القرارات أو تعطيل بعض أجزاء الدعوى دون الأخرى.
الفرق بين سقوط الخصومة وانقضائها بالتقادم :
من المهم التفرقة بين سقوط الخصومة وفقاً للمادة 136 وبين انقضاء الحق في الدعوى بالتقادم:
- سقوط الخصومة إجراء يتعلق بوقف السير في الدعوى وعدم اتخاذ إجراءات فيها لمدة سنة كاملة، مما يؤدي إلى إسقاطها.
- التقادم يتعلق بانقضاء الحق في رفع الدعوى نتيجة مرور مدة أطول (تختلف بحسب نوع الدعوى)، ويؤدي إلى انعدام الحق في المطالبة به قضائياً.
خاتمة :
تُعد المادة 136 من قانون المرافعات المصري أداة قانونية هامة لضبط سير الدعاوى القضائية ومنع التلاعب في الإجراءات، حيث تحقق توازناً بين حق المدعي في التقاضي وحق المدعى عليه في عدم التعرض لإجراءات غير جادة أو مماطلة غير مبررة. ومن ثم، فإن تطبيق هذه المادة يساهم في تحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات، مما ينعكس إيجابياً على منظومة التقاضي بصفة عامة.
عدم تعلق سقوط الخصومة بالنظام العام وينبغي التمسك به :
سقوط الخصومة لا يُعَدّ من النظام العام، مما يعني أن المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها، بل يجب على الخصم المتمسك به أن يتقدم بطلب بذلك وفقاً للإجراءات القانونية المقررة. ويترتب على ذلك أنه إذا لم يُثر أحد الخصوم مسألة السقوط، فإن الدعوى تستمر بشكل طبيعي، ولا يكون للمحكمة أن تحكم به تلقائياً. ويهدف هذا المبدأ إلى حماية حقوق الخصوم وإعطائهم الفرصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الدعوى أو التمسك بسقوطها، مما يعزز مبدأ المساواة والعدالة في الإجراءات القضائية.
طريقان للتمسك بسقوط الخصومة :
الطريق الأول : رفع دعوى مبتدأة به حتى ولو أمام محكمة الإستئناف بالنسبة لخصومة الإستئناف :
يمكن التمسك بسقوط الخصومة بطريقتين، أولها رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم بسقوط الخصومة، حيث يجوز للخصم الذي له مصلحة في السقوط أن يقيم دعوى مبتدأة أمام المحكمة المختصة، حتى ولو كانت محكمة الاستئناف، وذلك في حالة سقوط خصومة الاستئناف .
ويتم ذلك وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، من خلال تقديم صحيفة دعوى تتضمن الأسباب التي يستند إليها الخصم في طلبه بسقوط الخصومة، مع مراعاة توجيهها إلى جميع المدعين أو المستأنفين، وإلا كانت غير مقبولة. ويسمح هذا الطريق بالحصول على حكم قضائي مستقل يقرر سقوط الخصومة، مما يساهم في تحقيق الاستقرار القانوني والفصل في النزاع بشكل نهائي.
الطريق الثاني : الدفع بالسقوط :
الطريق الثاني للتمسك بسقوط الخصومة هو الدفع بالسقوط، حيث يجوز للمدعى عليه أو المستأنف ضده أن يتمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا قام المدعي أو المستأنف بتعجيل دعواه بعد انقضاء السنة المقررة دون اتخاذ أي إجراء لاستمرارها. ويتم إثارة هذا الدفع أثناء نظر الدعوى دون الحاجة إلى رفع دعوى مستقلة، ويترتب عليه – إذا ثبت للمحكمة صحته – إنهاء الخصومة وإغلاق ملف الدعوى دون الفصل في موضوعها. ويعد هذا الطريق وسيلة دفاعية فعالة تحمي الخصوم من المماطلة في السير في الإجراءات، كما يمنع إطالة أمد التقاضي بغير مبرر.
للمدعى عليه وحده التمسك بسقوط الخصومة وليس للمدعى ذلك وفقا للراجح في الفقه :
يقر الفقه الراجح بأن الحق في التمسك بسقوط الخصومة يقتصر على المدعى عليه وحده، ولا يجوز للمدعي التمسك به. ويرجع ذلك إلى أن المدعي هو صاحب المصلحة في استمرار الدعوى ومتابعة إجراءاتها، وبالتالي لا يمكنه الاستفادة من تقصيره أو تراخيه في السير بها. أما المدعى عليه، فهو الطرف الذي قد يتضرر من إطالة أمد الخصومة دون مبرر، لذا منح له المشرّع حق الدفع بسقوطها لحمايته من بقاء النزاع معلقًا لفترة غير محددة. يعكس هذا التوجه الفقهي مبدأ عدم جواز استفادة الشخص من إهماله، ويعزز استقرار المراكز القانونية للأطراف في الدعوى.
لا يجوز تجزئة الخصومة بالنسبة للسقوط في حالة تعدد المدعين وجواز تجزئتها في حالة تعدد المدعى عليهم :
لا يجوز تجزئة الخصومة عند التمسك بسقوطها في حالة تعدد المدعين، إذ يجب أن يكون طلب السقوط موجهاً ضد جميع المدعين أو المستأنفين، وإلا كان غير مقبول. ويعود ذلك إلى أن الخصومة تُعتبر وحدة واحدة بالنسبة للمدعين، فلا يمكن أن تسقط بالنسبة للبعض وتستمر بالنسبة للآخرين، تجنباً لتعارض الأحكام والإضرار بحسن سير العدالة.
أما في حالة تعدد المدعى عليهم، فيجوز تجزئة السقوط بحيث يتم التمسك به ضد بعضهم دون الآخرين، وذلك لأن كل مدعى عليه يُعد خصماً مستقلاً في الدعوى، ويملك الحق في الدفع بسقوط الخصومة أو التنازل عن هذا الدفع وفقاً لمصلحته الخاصة، دون أن يؤثر ذلك على باقي المدعى عليهم في ذات القضية.
الحالة الأولي : تعدد المدعين : لا تجزئة فالسقوط يكون بالنسبة لجميع المدعين :
في حالة تعدد المدعين، لا يجوز تجزئة سقوط الخصومة، بل يجب أن يكون السقوط شاملاً لجميع المدعين في الدعوى. فإذا تقدم أحد المدعى عليهم بطلب الحكم بسقوط الخصومة، وجب أن يكون موجهاً ضد جميع المدعين أو المستأنفين وليس ضد بعضهم فقط، وإلا كان الطلب غير مقبول. ويرجع ذلك إلى أن الخصومة تُعتبر كياناً قانونياً واحداً بالنسبة للمدعين، ولا يمكن أن تسقط عن بعضهم وتظل قائمة بالنسبة للآخرين، حتى لا يؤدي ذلك إلى تعارض الأحكام أو تفتيت النزاع بطريقة غير منطقية، مما قد يضر بحسن سير العدالة ويؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية للأطراف.
الحالة الثانية : تعدد المدعي عليهم : جواز التجزئة فالسقوط يكون بالنسبة لمن يتمسك به من المدعى عليهم دون غيره :
في حالة تعدد المدعى عليهم، يجوز تجزئة سقوط الخصومة، بحيث يسري فقط على من يتمسك به من المدعى عليهم دون أن يمتد إلى الآخرين. ويرجع ذلك إلى أن كل مدعى عليه يُعتبر خصماً مستقلاً في الدعوى، ويملك حق الدفاع عن نفسه بشكل منفصل، بما في ذلك التمسك بسقوط الخصومة أو التنازل عنه وفقاً لمصلحته.
وبالتالي، إذا دفع أحد المدعى عليهم بسقوط الخصومة، فإن أثر السقوط ينصرف إليه وحده، بينما يمكن لبقية المدعى عليهم الاستمرار في الدعوى إذا لم يتمسكوا بالسقوط. ويحقق هذا المبدأ مرونة في الإجراءات القضائية، بما يضمن عدم إهدار حقوق الأطراف غير الراغبين في التمسك بالسقوط.
المادة 137 من قانون المرافعات :
مادة 137 – يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى ، ولكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى ولا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكـام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها .
على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها .
تنص المادة 137 على أن الحكم بسقوط الخصومة يؤدي إلى إلغاء جميع إجراءاتها، بما في ذلك رفع الدعوى والأحكام الصادرة بشأن إجراءات الإثبات. ومع ذلك، لا يمتد هذا السقوط إلى أصل الحق في الدعوى أو الأحكام القطعية الصادرة فيها، كما لا يمس الإجراءات السابقة لتلك الأحكام، أو الإقرارات الصادرة من الخصوم، أو الأيمان التي حلفوها. ورغم ذلك، يظل للخصوم الحق في التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت خلال سير الخصومة، ما لم تكن باطلة في ذاتها. يعكس هذا النص التوازن بين استقرار الإجراءات القانونية وحقوق الأطراف في الدعوى، حيث يضمن عدم ضياع الحق الموضوعي بسبب سقوط الخصومة، مع الحفاظ على سلامة الإجراءات التي تمت بشكل صحيح.
المادة 137 من قانون المرافعات: دراسة قانونية شاملة
تمثل المادة 137 من قانون المرافعات أحد الأحكام الهامة التي تنظم آثار سقوط الخصومة، حيث تحدد نطاق هذا السقوط وتأثيره على الإجراءات والأحكام المتعلقة بالدعوى. تهدف هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الخصوم في عدم إهدار مجهوداتهم السابقة وبين ضرورة احترام الإجراءات القانونية وتنظيم سير الخصومة بشكل عادل ومنضبط.
نص المادة 137 :
تنص المادة 137 من قانون المرافعات على ما يلي:
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى ، ولكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى ولا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكـام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها .
على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها .
تحليل المادة 137 :
يتضح من نص المادة أن سقوط الخصومة يؤدي إلى آثار متعددة تختلف في نطاقها وتأثيرها، ويمكن تحليلها من خلال العناصر التالية:
سقوط إجراءات الخصومة
بمجرد صدور الحكم بسقوط الخصومة، تزول جميع الإجراءات التي تمت في سياق الخصومة، بما في ذلك رفع الدعوى ذاته. وهذا يعني أن الخصم الذي أقام الدعوى لا يمكنه الاستناد إلى أي إجراء تم خلال الخصومة بعد صدور الحكم بالسقوط، ويحتاج إلى إعادة رفع الدعوى إذا أراد المطالبة بحقه من جديد.
عدم المساس بالحق في أصل الدعوى
على الرغم من سقوط إجراءات الخصومة، فإن هذا السقوط لا يؤثر على أصل الحق موضوع النزاع، بمعنى أن المدعي لا يفقد حقه القانوني في المطالبة بما يدعيه، لكنه يحتاج إلى إعادة مباشرة إجراءات جديدة أمام المحكمة.
عدم سقوط الأحكام القطعية :
الأحكام القطعية التي صدرت خلال سير الخصومة لا تتأثر بسقوطها، أي أن القرارات التي فصلت بشكل نهائي في بعض نقاط النزاع تظل قائمة وملزمة للخصوم. وهذا يعني أن الأحكام التي تحسم مسائل قانونية أو موضوعية في القضية تظل سارية رغم سقوط الخصومة.
عدم المساس بالإجراءات السابقة للأحكام القطعية :
تشمل هذه الإجراءات كل ما تم قبل صدور الأحكام القطعية، مثل الطلبات القانونية، والإجراءات التحضيرية التي لم تتأثر بالسقوط، مما يعني أن تلك الإجراءات لا تُلغى بصدور حكم السقوط.
الإقرارات والأيمان تبقى قائمة :
تظل الإقرارات التي أدلى بها الخصوم والأيمان التي حلفوها قائمة وملزمة، حيث تعتبر بمثابة أدلة قانونية لا تتأثر بسقوط الخصومة، ويمكن للخصوم التمسك بها عند إعادة رفع الدعوى.
جواز الاستناد إلى إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة :
تنص المادة على أن سقوط الخصومة لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت أثناء سير الخصومة، بشرط ألا تكون باطلة في ذاتها. وهذا يمنح الأطراف الحق في الاستفادة من الإجراءات الصحيحة التي تمت في الدعوى السابقة عند إعادة رفع الدعوى، مما يساعد على عدم إهدار الجهود المبذولة في التحقيق الفني والقانوني.
الهدف من المادة 137 :
تسعى المادة 137 إلى تحقيق عدة أهداف قانونية، منها:
- ضمان استقرار المعاملات القانونية من خلال إلغاء الإجراءات التي فقدت أهميتها بسبب سقوط الخصومة.
- حماية حقوق الخصوم من خلال عدم المساس بالأحكام القطعية والإقرارات والأيمان السابقة.
- تحقيق العدالة عبر السماح بالاستفادة من أعمال التحقيق والخبرة التي تمت، ما لم تكن باطلة.
- تنظيم سير الدعاوى بحيث لا تظل الخصومات معلقة لفترات طويلة دون حسم.
التطبيقات القضائية للمادة 137:
يتم تطبيق المادة 137 في العديد من الحالات التي يتقرر فيها سقوط الخصومة نتيجة تقاعس أحد الخصوم عن متابعة دعواه خلال المدة المحددة قانونًا. وتعتبر هذه المادة أداة لضمان عدم تعطيل القضاء بقضايا معلقة لمدد طويلة دون إجراءات فعلية.
في بعض الأحكام القضائية، أكدت المحاكم على أن سقوط الخصومة لا يعني انتهاء النزاع، بل يمكن إعادة رفع الدعوى مجددًا، مع الاحتفاظ ببعض الإجراءات السابقة التي لها أثر قانوني مستمر، مثل الإقرارات وأعمال الخبرة.
خاتمة:
تعتبر المادة 137 من قانون المرافعات من النصوص المهمة التي تحدد آثار سقوط الخصومة بشكل دقيق، حيث توازن بين مبدأ استقرار الإجراءات القانونية وحقوق الخصوم. فهي تضمن عدم فقدان الحق الموضوعي بسبب الإهمال في متابعة الدعوى، مع التأكيد على إلغاء الإجراءات التي لم تؤدِّ إلى أحكام قطعية. وتبرز أهمية هذه المادة في الحفاظ على عدالة التقاضي ومنع استغلال الإجراءات القانونية بشكل غير عادل.
آثار سقوط الخصومة وفقًا للمادة 137 من قانون المرافعات :
يترتب على سقوط الخصومة آثار قانونية مهمة، حيث يؤدي إلى زوال جميع الإجراءات التي تمت في الدعوى، بما في ذلك الأحكام الصادرة بشأن إجراءات الإثبات واعتبار رفع الدعوى كأن لم يكن. ومع ذلك، فإن هذا السقوط لا يؤثر على أصل الحق المطالب به، كما لا يسقط الأحكام القطعية الصادرة في الخصومة أو الإقرارات التي أدلى بها الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. ويجوز للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت قبل سقوط الخصومة، بشرط ألا تكون باطلة في ذاتها.
تحصين بعض الأعمال الإجرائية من السقوط :
تقوم القوانين الإجرائية بتحصين بعض الأعمال من السقوط، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية وعدم إهدار الجهود المبذولة خلال سير الدعوى. ومن بين هذه الأعمال المحصنة الأحكام القطعية التي تفصل في موضوع النزاع، حيث تظل محتفظة بحجيتها ولا تتأثر بسقوط الخصومة .
كما أن الإقرارات الصادرة عن الخصوم، والأيمان التي حلفوها، وكذلك بعض إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت بشكل صحيح، تبقى سارية المفعول ويمكن الاستناد إليها لاحقًا، ما لم تكن باطلة في ذاتها. ويهدف هذا التحصين إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدعي في المطالبة بحقه، ومصلحة المدعى عليه في عدم بقاء الدعوى معلقة لفترات غير محددة.
لا أثر لسقوط الخصومة على الأحكام القطعية التي صدرت في الدعوى ولا على الإجراءات السايقة لها :
لا يترتب على سقوط الخصومة أي أثر على الأحكام القطعية التي صدرت في الدعوى، حيث تبقى هذه الأحكام محتفظة بحجيتها وقوتها الملزمة، ولا يمكن المساس بها أو إلغاؤها بسبب سقوط الخصومة.
كما أن الإجراءات السابقة لصدور هذه الأحكام، مثل الإقرارات الصادرة عن الخصوم، والأيمان التي حلفوها، وأي مستندات أو أدلة تم تقديمها، تظل قائمة ويمكن الاستناد إليها في أي إجراء لاحق. ويهدف هذا المبدأ إلى ضمان استقرار الأوضاع القانونية ومنع إعادة النزاع بشأن مسائل تم الفصل فيها بشكل نهائي.
لا أثر لسقوط الخصومة على الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها :
لا يؤثر سقوط الخصومة على الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها أثناء سير الدعوى، حيث تظل هذه التصرفات قائمة وملزمة لأطرافها، ولا يمكن إنكارها أو التراجع عنها بسبب سقوط الخصومة.
فالإقرار يُعد حجة قاطعة على من صدر منه، كما أن اليمين تُلزم من حلفها بنتائجها القانونية. ويهدف هذا التحصين إلى ضمان استقرار المراكز القانونية والحفاظ على الحجج الثابتة التي تمت أثناء الخصومة، مما يمنع أي محاولة للتحايل أو التهرب من الالتزامات الناشئة عنها.
لا أثر لسقوط الخصومة على إجراءات التحقيق و إعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها :
لا يؤثر سقوط الخصومة على إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت خلال سير الدعوى، حيث تظل هذه الإجراءات قائمة ويمكن للخصوم الاستناد إليها في أي نزاع لاحق، ما لم تكن باطلة في ذاتها. فالتقارير الفنية وأعمال الخبرة التي أجريت وفقًا للقانون تحتفظ بقيمتها الثبوتية، وكذلك شهادات الشهود ومحاضر المعاينة التي تم تنفيذها بشكل صحيح .
ويهدف هذا الاستثناء إلى منع إهدار الجهود المبذولة في جمع الأدلة وضمان عدم المساس بالإجراءات التي تمت وفقًا للأصول القانونية، مما يسهم في تحقيق العدالة وتوفير الوقت والجهد على الأطراف.
بقاء الحق الموضوعي محل الدعوى و كذلك الحق في الدعوى رغم سقوط الخصومة :
لا يؤدي سقوط الخصومة إلى المساس بالحق الموضوعي محل الدعوى، حيث يظل هذا الحق قائمًا للمدعي ويمكنه المطالبة به مجددًا من خلال رفع دعوى جديدة. كما أن الحق في الدعوى ذاته لا يسقط، مما يمنح صاحب الحق إمكانية اللجوء إلى القضاء مرة أخرى للمطالبة بحقه، شريطة ألا يكون قد سقط بالتقادم أو لأي سبب قانوني آخر.
ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق التوازن بين ضرورة إنهاء الإجراءات التي لم يتم السير فيها لفترة طويلة، وبين الحفاظ على حق المدعي في المطالبة بحقه وعدم حرمانه منه بسبب اعتبارات إجرائية بحتة.
المادة 138 :
مادة 138 – متى حكم الخصومة فى الاستئناف أعتبر الحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال .
ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
تنص المادة 138 على أنه إذا تم الحكم في الخصومة في مرحلة الاستئناف، فإن الحكم المستأنف يصبح نهائيًا في جميع الأحوال، مما يعني أنه لا يجوز الطعن عليه بأي طريقة أخرى من طرق الطعن العادية. أما فيما يتعلق بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر، فإذا صدر الحكم بالسقوط قبل قبول الالتماس، فإن الطلب ذاته يسقط تبعًا لذلك. أما إذا تم قبول الالتماس، فإن الإجراءات تتبع القواعد المقررة للاستئناف أو لمحكمة الدرجة الأولى، وفقًا لطبيعة الدعوى والمرحلة التي وصلت إليها.
النص القانوني للمادة 138:
متى حكم الخصومة فى الاستئناف أعتبر الحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال .
ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
شرح المادة 138: أثر الحكم في الخصومة وسقوطها في الاستئناف والتماس إعادة النظر :
تُعد المادة 138 من القوانين الإجرائية المهمة التي تحدد الآثار القانونية للحكم في الخصومة في مرحلة الاستئناف، وكذلك قواعد سقوط الخصومة في التماس إعادة النظر. وهي تنظم كيفية تعامل القضاء مع القضايا التي يتم الطعن عليها، سواء في الاستئناف أو عبر التماس إعادة النظر، وتحدد ما يترتب على هذه الأحكام من آثار قانونية.
أثر الحكم في الاستئناف على نهائية الحكم المستأنف :
وفقًا للمادة 138، إذا صدر حكم في الاستئناف وفصل في الخصومة، فإن الحكم المستأنف يصبح نهائيًا في جميع الأحوال، أي لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى بأي طريقة أخرى من طرق الطعن العادية. ويعني ذلك أن الحكم الذي تم استئنافه لم يعد له وجود قانوني مستقل، بل يندمج في حكم الاستئناف، سواء كان الحكم الجديد بتأييد الحكم السابق أو تعديله أو إلغائه.
هذا الحكم يحقق الاستقرار القانوني، حيث يمنع إعادة فتح النزاع بعد صدور حكم نهائي في مرحلة الاستئناف، إلا إذا توافرت أسباب خاصة للطعن بطرق غير عادية مثل التماس إعادة النظر أو الطعن بالنقض إذا كان مسموحًا به قانونًا.
سقوط الخصومة في التماس إعادة النظر :
تنص المادة أيضًا على أن سقوط الخصومة في التماس إعادة النظر يترتب عليه سقوط طلب الالتماس نفسه، ولكن يختلف الوضع بحسب المرحلة التي وصلت إليها الدعوى:
-
إذا حكم بسقوط الخصومة قبل الحكم بقبول الالتماس:
- في هذه الحالة، يسقط الالتماس ذاته، أي لا يمكن الاستمرار في نظر القضية، وتظل الأحكام السابقة قائمة وسارية المفعول.
- هذا يمنع المتقاضين من استخدام الالتماس كوسيلة للمماطلة أو تعطيل تنفيذ الأحكام.
-
إذا حكم بسقوط الخصومة بعد قبول الالتماس:
- في هذه الحالة، يتم التعامل مع القضية وفق القواعد التي تنطبق على الاستئناف أو على محكمة الدرجة الأولى، بحسب طبيعة النزاع.
- إذا كان الالتماس مقبولًا وتمت إعادة فتح الدعوى، فإنها تُعامل وكأنها دعوى منظورة أمام المحكمة المختصة، سواء كانت محكمة الاستئناف أو المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي.
أهمية المادة 138 في النظام القضائي :
- تؤدي هذه المادة دورًا جوهريًا في تحقيق التوازن بين استقرار الأحكام القضائية وحق المتقاضين في الطعن عليها.
- تضمن عدم استغلال إجراءات الطعن لإطالة أمد التقاضي دون جدوى.
- تضع حدًا زمنيًا واضحًا لإنهاء الخصومة، مما يمنع تراكم القضايا أمام المحاكم.
خاتمة :
المادة 138 من القوانين الإجرائية الحاسمة التي تحدد كيفية التعامل مع سقوط الخصومة في مرحلتي الاستئناف والتماس إعادة النظر. وهي تساهم في تحقيق العدالة من خلال الحفاظ على استقرار الأحكام القضائية، مع إعطاء الفرصة للطعن عليها في الحدود التي يقررها القانون، بما يحقق التوازن بين سرعة التقاضي والعدالة في الفصل في النزاعات.
المادة 139 :
مادة 139 – تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها .
تنص المادة 139 من قانون المرافعات على أن “تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.”
ويعني ذلك أن المدة المحددة قانونًا لانقضاء الخصومة بسبب عدم السير فيها تسري على جميع الأطراف المتقاضين، دون استثناء، حتى لو كان أحدهم عديم الأهلية أو ناقصها، مثل القُصَّر أو المحجور عليهم. وهذا يعكس مبدأ استقرار الأوضاع القانونية وعدم إطالة أمد النزاعات القضائية، بغض النظر عن حالة الخصوم الشخصية أو القانونية. ومع ذلك، يمكن أن يكون للنائب القانوني، مثل الولي أو الوصي أو القيم، دور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق من ينوب عنهم قبل فوات المدة المقررة لسقوط الخصومة.
المادة 139 من قانون المرافعات:
تعد المادة 139 من قانون المرافعات من النصوص القانونية المهمة التي تتعلق بسقوط الخصومة، حيث تؤكد أن المدة المقررة لهذا السقوط تسري على جميع الأشخاص، بما في ذلك عديمو الأهلية وناقصوها. وتعكس هذه المادة مبدأ استقرار الأوضاع القانونية، ومنع إطالة النزاعات القضائية بلا مبرر، وهو ما يحقق التوازن بين مصالح الأطراف المتقاضين وسير العدالة بانتظام.
مفهوم سقوط الخصومة :
سقوط الخصومة هو إحدى الحالات التي تنتهي بها الدعوى، ويحدث عندما يظل النزاع القضائي دون أي إجراء أو متابعة من جانب المدعي لمدة معينة يحددها القانون، مما يؤدي إلى اعتباره كأن لم يكن. ويهدف هذا المبدأ إلى تفادي تعطيل الفصل في القضايا وضمان عدم تراكم الدعاوى أمام المحاكم بلا فائدة.
النص القانوني للمادة 139:
يتضح من النص أن: تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها .
الحكمة من النص :
وضع المشرع هذا النص تحقيقًا لعدة أهداف قانونية، منها:
- تحقيق الاستقرار القضائي: فلو لم تسري مدة سقوط الخصومة على جميع الأشخاص، لأصبحت هناك دعاوى قائمة بلا نهاية، ما يعرقل حسن سير العدالة.
- حماية حقوق الخصوم: حيث يضمن المشرع أن لكل طرف في الدعوى مصلحة في متابعتها وعدم إهمالها.
- منع استغلال الأهلية كذريعة: فقد يدعي أحد الخصوم عدم الأهلية أو نقصها للتحايل على القانون وتفادي سقوط دعواه، لذا أقر المشرع هذا النص لسد هذه الثغرة.
الفرق بين سقوط الخصومة وانقضائها بالتقادم :
من المهم التفرقة بين سقوط الخصومة وانقضاء الحق بالتقادم:
- سقوط الخصومة: مرتبط بعدم اتخاذ إجراءات في الدعوى لمدة معينة، مما يؤدي إلى اعتباره كأن لم يكن، لكنه لا يؤثر على أصل الحق.
- التقادم: يؤدي إلى انقضاء الحق ذاته إذا لم يُطالب به صاحبه خلال مدة محددة قانونًا.
الآثار القانونية لسقوط الخصومة وفقًا للمادة 139
عند تحقق سقوط الخصومة وفقًا لهذه المادة، تترتب عدة آثار قانونية، منها:
- انتهاء الإجراءات السابقة في الدعوى، ما لم تكن هناك حقوق ناشئة عنها.
- إمكانية تجديد الدعوى، ولكن مع فقدان أي إجراءات سابقة ما لم يكن هناك استثناء قانوني يسمح باستمرارها.
- عدم تأثير السقوط على أصل الحق، حيث يمكن للمدعي رفع دعوى جديدة ما دام الحق نفسه لم يسقط بالتقادم.
تطبيقات قضائية للمادة 139:
المحاكم تطبق المادة 139 بصرامة، حيث تقضي بسقوط الخصومة إذا ثبت أن المدعي لم يتخذ أي إجراء في الدعوى خلال المدة القانونية. وفي بعض الأحكام، أكدت المحاكم أنه لا يُقبل الدفع بعدم الأهلية كعذر لعدم السير في الدعوى، لأن القانون يلزم النائب القانوني بمتابعة الخصومة نيابة عن القاصر أو المحجور عليه.
خاتمة:
تؤكد المادة 139 من قانون المرافعات على مبدأ جوهري في النظام القضائي، وهو عدم استثناء أي طرف من سقوط الخصومة، حتى لو كان عديم الأهلية أو ناقصها. ويعكس ذلك التزام المشرع بتحقيق التوازن بين حماية حقوق المتقاضين وضمان سرعة الفصل في المنازعات. ولذلك، يتحمل النائب القانوني مسؤولية كبيرة في متابعة القضايا نيابة عن من يمثلهم، حتى لا يفقدوا حقوقهم بسبب فوات المدة القانونية المقررة لسقوط الخصومة.
سريان مدة سقوط الخصومة في حق كافة الأشخاص :
تسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص دون استثناء، وفقًا لما نصت عليه المادة 139 من قانون المرافعات، بما في ذلك عديمو الأهلية وناقصوها مثل القُصَّر أو المحجور عليهم. ويعني ذلك أن مجرد كون أحد أطراف الدعوى غير قادر على التصرف بنفسه لا يوقف سريان المدة المقررة للسقوط، مما يستوجب على النائب القانوني، كالأب أو الوصي أو القيم، متابعة إجراءات الدعوى نيابة عن من يمثله لتجنب سقوط الخصومة. ويهدف هذا الحكم القانوني إلى تحقيق الاستقرار في الإجراءات القضائية، ومنع إطالة أمد النزاعات دون مبرر، وحماية حقوق الخصوم من التعطيل بسبب الإهمال في متابعة القضايا.
المادة 140 :
مادة 140 (1) – فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.
ومع ذلك ، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض.
تنص المادة 140 (1) على أن الخصومة تنقضي تلقائيًا بمرور سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح تم اتخاذه فيها، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونية وعدم ترك الدعاوى معلقة لفترات طويلة دون متابعة .
ويهدف هذا النص إلى تحقيق مبدأ سرعة الفصل في القضايا ومنع تراكم النزاعات غير المحسومة. ومع ذلك، فقد استثنى المشرع صراحةً الطعون المقدمة بطريق النقض من هذا الحكم، مما يعني أن الطعن بالنقض لا يسقط بمرور المدة المذكورة، وذلك نظرًا لطبيعته الخاصة كمرحلة أخيرة في التقاضي تهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية وضمان تحقيق العدالة.
المادة 140: انقضاء الخصومة بمرور الزمن
تعد المادة 140 من القواعد الإجرائية المهمة التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأوضاع القانونية ومنع استمرار النزاعات القضائية لفترات غير محدودة دون متابعة. وهي تنص على أن الخصومة تنقضي بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح تم فيها، مع استثناء الطعن بطريق النقض من هذا الحكم. في هذه المقالة، سنستعرض مفهوم المادة 140، فلسفتها التشريعية، وأهم تطبيقاتها وتأثيراتها في النظام القضائي.
النص القانوني للمادة 140 :
تنص المادة 140 (1) على ما يلي:
فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.ومع ذلك ، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض
الفلسفة التشريعية للمادة 140 :
تقوم المادة 140 على مبدأين أساسيين:
-
تحقيق استقرار الأوضاع القانونية
- إن ترك القضايا مفتوحة لفترات طويلة دون تحريك يؤدي إلى تعطيل مصالح الأطراف المتنازعة وقد يؤثر على مصداقية النظام القضائي.
- من خلال تحديد مدة السنتين، يتم التأكد من أن الأطراف المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
-
تقليل العبء على المحاكم
- القضايا غير المتحركة تشكل ضغطًا غير مبرر على المحاكم، مما يعرقل سرعة الفصل في الدعاوى الأخرى.
- يساعد انقضاء الخصومة في تصفية القضايا المتروكة وإتاحة المجال للفصل في النزاعات الفعالة.
الفرق بين انقضاء الخصومة وسقوط الحق في التقاضي :
من المهم التفرقة بين مفهوم انقضاء الخصومة بموجب المادة 140 وسقوط الحق في التقاضي بسبب التقادم:
- انقضاء الخصومة: هو أثر إجرائي يؤدي إلى إنهاء الدعوى نتيجة عدم تحريكها لمدة سنتين من آخر إجراء صحيح فيها، لكنه لا يمس أصل الحق المتنازع عليه.
- التقادم: هو قاعدة موضوعية تؤدي إلى سقوط الحق ذاته بمرور مدة معينة دون المطالبة به، وهو يختلف باختلاف نوع النزاع.
استثناء الطعن بالنقض من حكم المادة 140
نصت المادة 140 صراحةً على عدم سريان مدة السنتين على الطعن بطريق النقض، وذلك للأسباب التالية:
-
الطبيعة الخاصة للطعن بالنقض
- الطعن بالنقض يهدف إلى تصحيح الأخطاء القانونية في الأحكام النهائية، ولذلك يجب أن تكون الفرصة متاحة للطعن دون التقيد بقاعدة انقضاء الخصومة.
-
حماية مبدأ العدالة
- استثناء الطعن بالنقض يضمن عدم وقوع أخطاء قضائية جسيمة دون إمكانية تصحيحها بسبب انقضاء الخصومة.
تطبيقات المادة 140 في الواقع العملي :
في الواقع العملي، تطبق المادة 140 في الحالات التالية:
- إذا توقفت الإجراءات في دعوى ما لمدة تتجاوز سنتين دون قيام أحد الأطراف بتحريكها، فإن المحكمة تقضي بانقضاء الخصومة تلقائيًا.
- يجوز للمدعي إعادة رفع الدعوى إذا لم يكن الحق قد سقط بالتقادم، بشرط استيفاء المتطلبات القانونية.
- لا يمكن للمدعى عليه أن يتمسك بانقضاء الخصومة إذا كان هو السبب في تعطيل الإجراءات.
الانتقادات والمقترحات بشأن المادة 140
رغم أهمية المادة 140 في تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وحماية حقوق الأطراف، إلا أن هناك بعض الانتقادات الموجهة إليها:
-
عدم المرونة في بعض الحالات
- قد تكون هناك أسباب قهرية تمنع أحد الأطراف من متابعة الإجراءات خلال المدة المحددة، مثل ظروف طارئة أو قضايا تتطلب وقتًا طويلًا للحصول على الأدلة.
-
عدم شمولية الاستثناءات
- اقتصرت المادة 140 على استثناء الطعن بالنقض فقط، بينما قد تكون هناك حالات أخرى تستدعي استثناءً مماثلًا، مثل إعادة النظر في الأحكام بناءً على ظهور أدلة جديدة.
مقترحات للتطوير
- إدخال استثناءات إضافية في الحالات التي يكون فيها تأخير الإجراءات مبررًا بشكل موضوعي.
- منح المحكمة سلطة تقديرية لعدم تطبيق انقضاء الخصومة إذا ثبت أن التأخير كان خارجًا عن إرادة الأطراف.
خاتمة
تشكل المادة 140 من القواعد الأساسية التي تساهم في ضبط الإجراءات القضائية ومنع تراكم الدعاوى غير المتحركة. وهي تعكس حرص المشرع على تحقيق التوازن بين سرعة التقاضي وضمان العدالة. ورغم بعض التحديات التي قد تواجه تطبيقها، إلا أنها تظل أداة مهمة للحفاظ على كفاءة النظام القضائي وتخفيف العبء على المحاكم.
تعديل المادة 140 مرافعات بالقانون 18 لسنة 1999 :
تم تعديل المادة 140 من قانون المرافعات بموجب القانون رقم 18 لسنة 1999، حيث أُعيدت صياغتها لتنص على انقضاء الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح تم فيها، مع استثناء الطعن بالنقض من هذا الحكم.
وقد جاء هذا التعديل بهدف تحقيق المزيد من الانضباط في سير الدعاوى، ومنع تراكم القضايا غير المتحركة، وتقليل العبء على المحاكم. كما ساهم في تعزيز مبدأ استقرار الأوضاع القانونية من خلال تحديد مدة زمنية معقولة لانتهاء الخصومة في حالة عدم تحريكها من قبل الأطراف.
تقادم الخصومة في قانون المرافعات :
تقادم الخصومة في قانون المرافعات هو حكم إجرائي يهدف إلى إنهاء الدعوى القضائية بعد فترة معينة من عدم اتخاذ أي إجراء صحيح فيها. وفقًا للمادة 140 من قانون المرافعات، تنقضي الخصومة بمرور سنتين على آخر إجراء صحيح تم في الدعوى، وهو ما يعنى أن إذا لم يتخذ أي من الأطراف إجراءً رسميًا في الدعوى خلال هذه المدة، تصبح الدعوى منقضية تلقائيًا.
يهدف هذا التقادم إلى منع تراكم الدعاوى غير المتحركة وحث الأطراف على متابعة قضاياهم بشكل مستمر، بالإضافة إلى تخفيف العبء على المحاكم. ومن المهم ملاحظة أن هذا الحكم لا يسري على الطعن بالنقض، حيث يظل الطعن بالنقض قائمًا بغض النظر عن مرور المدة.
التعريف بإنقضاء الخصومة بالتقادم وحكمتة والتفرقة بينه وبين سقوط الخصومة :
انقضاء الخصومة بالتقادم هو أحد الأحكام الإجرائية التي تؤدي إلى إنهاء النزاع القضائي نتيجة مرور مدة معينة دون اتخاذ أي إجراء صحيح فيها، وذلك وفقًا للمادة 140 من قانون المرافعات التي تنص على انقضاء الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح تم فيها، باستثناء الطعن بالنقض. وتكمن حكمة هذا الحكم في تحقيق الاستقرار القانوني، ومنع تراكم الدعاوى غير المتحركة داخل المحاكم، وحث الأطراف على متابعة قضاياهم بجدية.
ويختلف انقضاء الخصومة بالتقادم عن سقوط الخصومة، حيث إن الانقضاء بالتقادم يحدث تلقائيًا بمجرد مرور المدة المحددة دون الحاجة إلى تقديم طلب بذلك، في حين أن سقوط الخصومة يتطلب أن يتقدم الخصم بطلب إلى المحكمة لإثبات عدم قيام الطرف الآخر بتحريك الدعوى خلال ستة أشهر، وفقًا للمادة 134 من قانون المرافعات. كما أن سقوط الخصومة لا يؤدي إلى إنهاء الحق في رفع الدعوى مجددًا، بينما قد يمنع انقضاء الخصومة إعادة رفعها إذا كان الحق الأصلي قد سقط بالتقادم.
شروط ومدة تقادم الخصومة و آثاره :
لتقادم الخصومة وفقًا لقانون المرافعات، يجب توافر شروط محددة، وهي: مرور سنتين كاملة دون اتخاذ أي إجراء صحيح من قبل أحد الأطراف، وأن يكون هذا الإجراء جادًا ومؤثرًا في سير الدعوى، كما يجب ألا يكون هناك مانع قانوني يحول دون مباشرة الخصومة.
أما مدة تقادم الخصومة، فقد حددها المشرع بسنتين تبدأ من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الدعوى، باستثناء الطعن بالنقض الذي لا يسري عليه هذا الحكم.
ويترتب على انقضاء الخصومة بالتقادم عدة آثار قانونية، أهمها: إنهاء النزاع القائم أمام المحكمة دون المساس بأصل الحق، أي أن للمدعي الحق في رفع دعوى جديدة إذا لم يكن قد سقط بالتقادم الموضوعي، كما يسقط أي أثر قانوني للإجراءات السابقة، ما لم تكن هناك حقوق مكتسبة نتيجة لها. ويترتب أيضًا تخفيف العبء على المحاكم، مما يساهم في تحقيق سرعة الفصل في القضايا والحد من تراكم الدعاوى غير المتحركة.
عدم تقادم خصومة الطعن بالنقض :
استثنى المشرع خصومة الطعن بالنقض من حكم تقادم الخصومة الوارد في المادة 140 من قانون المرافعات، حيث نص صراحةً على أن مرور سنتين دون اتخاذ إجراء في الطعن بالنقض لا يؤدي إلى انقضائه.
ويرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة للطعن بالنقض، كونه وسيلة لضمان تصحيح الأخطاء القانونية التي قد تكون شابت الأحكام النهائية، مما يستوجب عدم تقييده بقاعدة تقادم الخصومة. كما أن الطعن بالنقض لا يُعد استئنافًا للخصومة الأصلية، بل هو مرحلة قانونية مستقلة تهدف إلى مراجعة صحة تطبيق القانون، لذا فإن استمراره دون تقادم يحقق مبدأ العدالة ويمنح الأطراف فرصة كاملة للطعن على الأحكام دون التقيد بمرور الزمن.
المادة 141 ترك الخصومـة :
مادة 141 – يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى المحضر.
تنص المادة 141 من قانون المرافعات على أن ترك الخصومة يتم بإحدى الوسائل التالية: إعلان رسمي من التارك لخصمه بواسطة محضر، أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله، بشرط اطلاع الخصم عليها، أو إبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في محضر الجلسة. ويعد ترك الخصومة تصرفًا قانونيًا يُمكّن المدعي من إنهاء الدعوى بإرادته المنفردة، بشرط ألا يكون المدعى عليه قد تقدم بطلبات في الدعوى، وإلا لزم موافقته على الترك.
النص القانوني للمادة 141 :
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى المحضر.
شرح تفصيلي للمادة 141 من قانون المرافعات: ترك الخصومة :
تعد المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من المواد الأساسية التي تنظم حق المدعي في ترك الخصومة كإجراء قانوني يتيح له التنازل عن دعواه قبل الفصل فيها بحكم نهائي. هذا الحق يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدعي في إنهاء الدعوى ومصلحة المدعى عليه في عدم الإضرار به جراء هذا التنازل.
مفهوم ترك الخصومة :
ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن الدعوى التي أقامها ضد المدعى عليه، مما يؤدي إلى إنهاء إجراءاتها دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي في موضوعها. ويختلف ترك الخصومة عن التنازل عن الحق، إذ إن الأخير يمنع رفع الدعوى مجددًا بشأن ذات الحق، بينما يتيح ترك الخصومة للمدعي إعادة رفع الدعوى لاحقًا ما لم يكن هناك مانع قانوني.
طرق ترك الخصومة وفقًا للمادة 141
تنص المادة 141 على ثلاث طرق رئيسية يمكن للمدعي من خلالها إعلان ترك الخصومة:
-
الإعلان الرسمي عن طريق المحضر:
- يحق للمدعي أن يوجه إلى المدعى عليه إعلانًا رسميًا بترك الخصومة عبر المحضر، وهو ما يكفل وضوح الإجراءات القانونية وتوثيقها رسميًا.
-
بيان صريح في مذكرة موقعة من المدعي أو وكيله:
- يمكن للمدعي تقديم مذكرة مكتوبة تفيد بترك الخصومة، ويشترط أن تكون موقعة منه أو من وكيله القانوني، على أن يتم إطلاع المدعى عليه عليها لضمان علمه بهذا الإجراء.
-
الإعلان الشفوي في الجلسة وإثباته في المحضر:
- يمكن للمدعي إعلان ترك الخصومة شفويًا أثناء جلسة المحاكمة، ويشترط في هذه الحالة أن يتم إثبات هذا الإعلان في محضر الجلسة ليكون رسميًا وملزمًا.
الآثار القانونية لترك الخصومة:
-
انتهاء الدعوى:
- بمجرد قيام المدعي بترك الخصومة وفقًا لأحد الطرق القانونية، تنتهي الدعوى من الناحية الإجرائية. ومع ذلك، لا يعني ذلك فقدان الحق في رفع الدعوى مجددًا، إلا إذا كان هناك تنازل عن الحق ذاته.
-
تحمل المصروفات:
- يترتب على ترك الخصومة إلزام المدعي بمصاريف الدعوى، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو يقرر القاضي خلاف ذلك بناءً على ظروف القضية.
-
حقوق المدعى عليه:
- إذا كان المدعى عليه قد قدم طلبات مقابلة أو عارضة، فإن ترك الخصومة من قبل المدعي لا يؤثر على هذه الطلبات، ويحق للمدعى عليه الاستمرار في نظر طلباته أمام المحكمة.
الفرق بين ترك الخصومة وأنواع التنازل الأخرى:
-
ترك الخصومة مقابل التنازل عن الحق:
- ترك الخصومة يتعلق فقط بإجراءات التقاضي، بينما التنازل عن الحق يعني أن المدعي يتخلى عن حقه نهائيًا ولا يجوز له المطالبة به مجددًا.
-
ترك الخصومة مقابل الصلح:
- الصلح هو اتفاق بين الطرفين ينهي النزاع بشكل ودي، بينما ترك الخصومة هو إجراء أحادي الجانب يتخذه المدعي فقط دون الحاجة إلى موافقة المدعى عليه.
متى لا يكون ترك الخصومة ممكنًا؟
- إذا كان هناك حكم نهائي قد صدر في الدعوى، فلا يجوز ترك الخصومة لأنه لم يعد هناك خصومة قائمة.
- إذا كان المدعى عليه قد قدم طلبات عارضة، فقد يتطلب الأمر موافقته على ترك الخصومة حتى لا تتضرر حقوقه.
التطبيقات القضائية للمادة 141:
- المحاكم تتعامل مع طلبات ترك الخصومة بحذر لضمان عدم الإضرار بحقوق المدعى عليه، خاصة إذا كان الترك بهدف تعطيل العدالة أو التهرب من حكم محتمل.
- في بعض الحالات، قد تفرض المحكمة شروطًا إضافية، مثل دفع تعويض للمدعى عليه إذا كان ترك الخصومة يسبب له ضررًا ماديًا أو أدبيًا.
الخاتمة :
تعتبر المادة 141 من قانون المرافعات إحدى الضمانات القانونية التي تحمي حق المدعي في التراجع عن الدعوى، مع الحفاظ على مصالح المدعى عليه. يهدف هذا النص إلى تحقيق المرونة في التقاضي، مع ضمان عدم استخدام ترك الخصومة كأداة للمماطلة أو الإضرار بالخصم. لذا، ينبغي على أطراف الدعوى فهم هذه المادة جيدًا واستخدامها وفقًا لمتطلبات العدالة والإنصاف.
التفرقة بين ترك الخصومة والنزول عن الحق محل الدعوى :
رغم أن ترك الخصومة والنزول عن الحق قد يتشابهان في بعض الحالات من حيث النتيجة الظاهرة، إلا أنهما يختلفان اختلافًا جوهريًا في المفهوم والآثار القانونية.
-
ترك الخصومة:
- هو إجراء قانوني يتخذه المدعي أثناء سير الدعوى، يتم من خلاله التنازل عن متابعة الدعوى القضائية دون المساس بالحق نفسه.
- المدعي يترك الخصومة أي يتنازل عن المضي في الدعوى، لكنه يظل محتفظًا بحقه الأساسي، ويمكنه رفع الدعوى مجددًا إذا أراد ذلك.
- الهدف من ترك الخصومة هو وقف الإجراءات القضائية فقط، ولا يعني التنازل عن الحق الأساسي في المطالبة.
-
النزول عن الحق:
- في المقابل، النزول عن الحق يتعلق بتخلي المدعي عن حقه القانوني نهائيًا، بمعنى أنه يتنازل عن الحق الذي كان يطالب به في الدعوى.
- النزول عن الحق لا يقتصر على الإجراء القضائي بل يمتد إلى الحق ذاته، وبالتالي لا يجوز للمدعي المطالبة به مجددًا، وهو إجراء دائم.
- الهدف من النزول عن الحق هو التخلي النهائي عن الحق، سواء كان حقًا ماديًا أو معنويًا.
باختصار: ترك الخصومة هو إجراء مؤقت لإنهاء الدعوى دون التنازل عن الحق، بينما النزول عن الحق هو تنازل دائم عن الحق الذي كان موضوع الدعوى.
التفرقة بين ترك الخصومة والنزول عن عمل من أعمال الخصومة :
ترك الخصومة والنزول عن عمل من أعمال الخصومة هما إجراءان قانونيان مختلفان في إطار الدعوى القضائية، لكنهما قد يتداخلان في بعض الحالات. ومع ذلك، هناك فرق جوهري بينهما من حيث النطاق والآثار القانونية.
-
ترك الخصومة:
- هو إجراء شامل يتخذه المدعي في أي مرحلة من مراحل الدعوى القضائية بهدف إنهاء القضية بشكل كامل، دون أن يتطلب حكمًا نهائيًا من المحكمة.
- عند ترك الخصومة، يتم وقف جميع الإجراءات المتعلقة بالقضية، وتعتبر الدعوى ملغاة من الناحية الإجرائية، ويمكن للمدعي إعادة رفع الدعوى لاحقًا إذا رغب في ذلك.
- هذا الإجراء يؤثر على الدعوى بأكملها، ويوقف كافة الإجراءات القضائية التي كانت تجري أمام المحكمة.
-
النزول عن عمل من أعمال الخصومة:
- هو إجراء جزئي يتخذه أحد أطراف الدعوى فيما يتعلق بعمل معين من أعمال الخصومة (مثل التنازل عن تقديم مستندات معينة، أو العدول عن طلبات معينة في الدعوى، أو التخلي عن دفاع محدد).
- هذا النزول لا يعني إنهاء الدعوى بالكامل، بل هو تخلي عن جزء من الإجراءات أو المطالبات دون المساس بالحق الأساسي للمدعي أو المدعى عليه.
- الآثار القانونية لهذا النزول تقتصر على العمل المعني دون أن يؤثر على مجمل الدعوى، مما يعني أن الدعوى قد تستمر في بعض جوانبها الأخرى.
باختصار:
- ترك الخصومة هو تنازل كلي عن الدعوى يؤدي إلى إنهاء جميع إجراءاتها.
- النزول عن عمل من أعمال الخصومة هو تنازل جزئي عن إجراء أو طلب محدد ضمن الدعوى، مما يترك باقي جوانب الدعوى قائمة.
التفرقة بين ترك الخصومة والنزول عن الحق في الدعوى :
هناك فرق جوهري بين ترك الخصومة والنزول عن الحق في الدعوى، حيث يؤثر كل منهما على مسار الدعوى وحقوق الأطراف بشكل مختلف:
-
ترك الخصومة:
- هو إجراء قانوني يقوم به المدعي للتخلي عن الدعوى نفسها، أي وقف الإجراءات القضائية دون المساس بجوهر الحق محل النزاع.
- يظل للمدعي الحق في رفع الدعوى مرة أخرى بشأن نفس الموضوع، ما لم يكن هناك مانع قانوني يمنعه.
- لا يؤثر ترك الخصومة على أصل الحق المدعى به، بل ينهي النزاع القضائي فقط.
-
النزول عن الحق في الدعوى:
- هو تنازل نهائي لا رجعة فيه عن الحق محل النزاع، مما يمنع المدعي من المطالبة به مرة أخرى أمام القضاء.
- بمجرد نزول المدعي عن حقه، تنتهي الدعوى بشكل نهائي، ولا يمكنه إعادة رفعها لاحقًا.
- يؤثر هذا الإجراء بشكل جوهري على مركز المدعي القانوني، حيث يفقد حقه في المطالبة نهائيًا.
باختصار: ترك الخصومة ينهي الدعوى لكن لا يمنع المدعي من رفعها مجددًا، بينما النزول عن الحق في الدعوى يمنع المدعي نهائيًا من المطالبة بالحق مرة أخرى.
للمدعى وحده ترك الخصومة و قابلية الخصومة للتجزئة بالنسية للترك :
وفقًا للقواعد العامة في قانون المرافعات، فإن المدعي وحده هو من يملك حق ترك الخصومة، باعتباره الطرف الذي بدأ إجراءات الدعوى. فلا يجوز للمدعى عليه أو المحكمة من تلقاء نفسها إنهاء الدعوى بترك الخصومة، بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب صريح من المدعي وفقًا للطرق المنصوص عليها في القانون.
أما من حيث قابلية الخصومة للتجزئة في الترك، فإن ذلك يعتمد على طبيعة النزاع. فإذا كانت الخصومة قابلة للتجزئة، جاز للمدعي أن يترك جزءًا من طلباته فقط، مع الاستمرار في باقي الطلبات. أما إذا كانت الخصومة غير قابلة للتجزئة – مثل الدعاوى المتعلقة بحقوق لا تحتمل التجزئة كالمطالبة بملكية شيء معين – فإن ترك الخصومة يجب أن يكون كليًا ليشمل الدعوى بأكملها.
باختصار: المدعي هو الطرف الوحيد الذي يملك حق ترك الخصومة، ويمكن أن يكون الترك كليًا أو جزئيًا وفقًا لقابلية الخصومة للتجزئة.
ثلاثة طرق لترك الخصومة وليس للترك ميعاد معين :
حدد المشرع ثلاثة طرق يمكن للمدعي من خلالها ترك الخصومة، وهي:
- الإعلان الرسمي: حيث يقوم المدعي بإعلان المدعى عليه بترك الخصومة عن طريق محضر رسمي، مما يضمن علم الطرف الآخر بهذا الإجراء بشكل قانوني موثق.
- مذكرة صريحة: يمكن للمدعي تقديم مذكرة مكتوبة تفيد بترك الخصومة، بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله، مع اطلاع المدعى عليه عليها لضمان الشفافية.
- إعلان شفوي في الجلسة: يحق للمدعي أن يعلن ترك الخصومة شفويًا أثناء الجلسة، على أن يتم إثبات ذلك في محضر الجلسة ليكتسب الصفة القانونية.
كما أن ترك الخصومة لا يتقيد بميعاد محدد، حيث يمكن للمدعي القيام به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء قبل الحكم فيها أو حتى أثناء نظرها في مرحلة الطعن، ما لم يكن قد صدر حكم نهائي يحسم النزاع.
لا يرد الترك على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام :
لا يجوز للمدعي ترك الخصومة في الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام، وذلك لأن هذه الدعاوى لا تخص الأطراف المتنازعة فقط، بل تتعلق بمصالح المجتمع ككل، مما يجعلها خاضعة لرقابة الدولة والقضاء. ومن أمثلة هذه الدعاوى الدعاوى الجنائية، ودعاوى الأحوال الشخصية المرتبطة بالنظام العام، والدعاوى المتعلقة بالصحة العامة أو النظام الاقتصادي.
والسبب في ذلك أن القضاء في مثل هذه الدعاوى لا يقتصر دوره على الفصل بين الخصوم، بل يمتد إلى حماية النظام العام وضمان تطبيق القواعد الآمرة. وبالتالي، حتى لو رغب المدعي في ترك الخصومة، فإن المحكمة تظل ملزمة بمواصلة نظر الدعوى وإصدار حكم فيها، تحقيقًا للمصلحة العامة.
جواز عدول التارك عن ترك الخصومة وشروط ذلك :
يُجيز القانون للمدعي العدول عن ترك الخصومة بشرط عدم قبول المدعى عليه لهذا الترك أو عدم صدور حكم من المحكمة يقرر ترك الخصومة بشكل نهائي. فإذا أعلن المدعي رغبته في ترك الخصومة، ولم يقبل المدعى عليه ذلك، يظل للمدعي الحق في العدول عنه والاستمرار في الدعوى.
أما إذا وافق المدعى عليه على الترك، أو إذا أصدرت المحكمة حكمًا بإثبات الترك، فلا يجوز للمدعي العدول عنه، ويترتب على ذلك إنهاء الدعوى نهائيًا، إلا إذا قرر القانون جواز رفعها مجددًا. وبالتالي، يرتبط العدول عن الترك بمرحلة الإجراء، حيث يجب أن يتم قبل صدور الحكم أو قبل أن تترتب عليه آثار قانونية نهائية.
إذا ترتب على ترك الدعوى سقوط الحق المرفوعة به وجب أن يكون التارك ممن يملك النزول عن الحق :
شروط التارك في حالة سقوط الحق بسبب ترك الدعوى :
إذا كان من شأن ترك الدعوى أن يؤدي إلى سقوط الحق المرفوعة به، فيجب أن يكون التارك (أي المدعي الذي يقرر ترك الخصومة) ممن يملك النزول عن هذا الحق. بمعنى آخر، لا يمكن للمدعي أن يترك الدعوى إذا كان الحق المرفوعة به لا يجوز له التنازل عنه قانونًا.
على سبيل المثال، إذا كان الحق الذي يطالب به المدعي حقًا غير قابل للتنازل (مثل بعض الحقوق المتعلقة بالنظام العام أو حقوق غير قابلة للتصرف)، فلا يجوز له ترك الدعوى بشكل يؤدي إلى سقوط هذا الحق. وبالتالي، يجب أن يكون المدعي صاحب الحق القابل للتنازل، أي أن يكون له كامل الحرية في التخلي عن حقه في المطالبة به أمام المحكمة، بحيث إذا قرر ترك الدعوى، لا تتأثر حقوقه الأساسية الأخرى.
باختصار: لا يجوز للمدعي ترك الدعوى إذا كان هذا الإجراء سيؤدي إلى سقوط حق غير قابل للتنازل، ويجب أن يكون التارك ممن يملك النزول عن حقه بحرية.
جواز الترك ولو كان قد صدر في الدعوى أحكام قطعية فرعية كانت أم موضوعية :
جواز ترك الخصومة رغم صدور أحكام قطعية في الدعوى :
يجوز للمدعي ترك الخصومة حتى بعد صدور أحكام قطعية في الدعوى، سواء كانت أحكامًا فرعية أو أحكامًا موضوعية، وذلك بشرط أن يكون الترك متعلقًا بالأجزاء التي لم يتطرق إليها الحكم القطعي.
-
الأحكام القطعية الفرعية: هي الأحكام التي تتعلق بالإجراءات أو الأمور غير الأساسية في الدعوى، مثل القرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية أو مصاريف الدعوى. في هذه الحالة، يمكن للمدعي ترك الخصومة في باقي الدعوى دون أن يؤثر ذلك على الحكم القطعي الصادر في المسائل الفرعية.
-
الأحكام القطعية الموضوعية: رغم أن الأحكام الموضوعية التي تصدر بحسم موضوع الدعوى تكون قطعية، يمكن للمدعي ترك الخصومة بالنسبة لبعض الطلبات أو الأمور الجزئية التي لم يشملها الحكم القطعي.
وبذلك، يحق للمدعي ترك الخصومة حتى بعد صدور حكم قطعي، ولكن ذلك يجب أن يكون في إطار ما لم يُفصل فيه الحكم القطعي، أي أن الترك لا يتداخل مع الأمور التي تم حسمها بحكم قضائي نهائي.
تفسير إرادة التارك بالحيطة والحذر :
عند الحديث عن إرادة التارك في ترك الخصومة، يتعين تفسير هذه الإرادة بحيطة وحذر شديدين، حيث أن ترك الخصومة قد يؤدي إلى إنهاء الدعوى بأكملها أو جزء منها. ولذلك، يجب التأكد من أن التارك قد أبدى إرادته بشكل صريح وواضح، ويدرك تمامًا العواقب القانونية لهذا الإجراء.
إن إرادة التارك يجب أن تكون خالية من أي إكراه أو ضغط، وأن يكون قد اتخذ هذا القرار بعد التفكير الكامل في تبعاته القانونية. لذا، يتطلب القانون أن يكون التارك قد قام بالإجراء بكل وعي وبموافقة كاملة، مع العلم التام بأن ترك الخصومة قد يؤدي إلى سقوط حقه في المطالبة بالدعوى، أو حتى وقف جميع إجراءات القضية.
كما أن المحكمة قد تتحقق من إرادة التارك بحذر، خاصة إذا كانت هناك شكوك حول ما إذا كان التارك قد اتخذ القرار بشكل طوعي ومدروس. لهذا، من الضروري أن تكون الإجراءات متوافقة مع ما يقتضيه مبدأ الشفافية والعدالة، لضمان عدم وقوع أي ظلم للطرف الآخر بسبب ترك الخصومة.
لا يجوز ترك الخصومة من وكيل الخصم الذي لم يفوضه تفويضا خاصا :
عدم جواز ترك الخصومة من وكيل الخصم غير المفوض بتفويض خاص :
لا يجوز للوكيل أن يترك الخصومة نيابة عن موكله إلا إذا كان قد حصل على تفويض خاص من الموكل يسمح له بذلك. ففي حالة إذا كان الوكيل مفوضًا بشكل عام أو في قضايا أخرى غير ترك الخصومة، لا يحق له اتخاذ قرار بترك الدعوى دون الحصول على تفويض صريح ومحدد من موكله.
السبب في ذلك هو أن ترك الخصومة يُعد من القرارات الجوهرية التي تؤثر في حق الموكل في الاستمرار في الدعوى أو التنازل عن حقه، مما يتطلب أن يكون هذا القرار صادرًا من الموكل نفسه أو من وكيل مفوض بشكل خاص للقيام بذلك.
وبالتالي، إذا كان الوكيل قد تم تفويضه بمهام قانونية أخرى ولكن لم يُمنح تفويضًا خاصًا بترك الخصومة، فلا يمكنه اتخاذ هذا القرار نيابة عن موكله، لأن ذلك يتطلب تفويضًا دقيقًا يعكس إرادة الموكل بشكل واضح، بما يضمن احترام حقوقه وحمايتها في جميع مراحل الدعوى
المادة 142 :
مادة 142 – لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي فى سماع الدعوى .
المادة 142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. لكن هذه القاعدة تُمَثَل باستثناءات معينة، حيث لا يلتفت إلى اعتراض المدعى عليه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو أي طلب آخر يكون الغرض منه عرقلة سير الدعوى أو منع المحكمة من المضي قدماً في سماعها.
بمعنى آخر، إذا كان المدعى عليه قد قدم اعتراضات تهدف إلى تعطيل الفصل في القضية أو منع المحكمة من اتخاذ إجراءاتها المعتادة، فلا يكون له الحق في الاعتراض على الترك بعد تقديم طلباته، لأنه تكون نواياه واضحة في محاولة تعطيل سير الدعوى.
المادة 142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية: دراسة في تفسيرها وتطبيقاتها :
تعد المادة 142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من المواد المهمة التي تنظم الإجراءات المتعلقة بالترك في الدعاوى المدنية. إذ تحدد متى يجوز للمدعى عليه الاعتراض على الترك، وما هي الحالات التي يكون فيها هذا الاعتراض غير مقبول. سنستعرض في هذه المقالة تفسير المادة 142 وتطبيقاتها العملية في النظام القضائي.
نص المادة 142 :
تنص المادة 142 على ما يلي:
– لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي فى سماع الدعوى
الشرح والتفسير :
الترك في الدعاوى :
الترك هو تنازل المدعى عن دعواه أمام المحكمة، وهو أمر يعكس رغبة المدعى في إنهاء الدعوى بشكل طوعي قبل أن تصدر المحكمة حكمًا فيها. وعلى الرغم من أن الترك يعد حقًا للمدعى، فإن المادة 142 فرضت قيدًا على ذلك الحق في حالات معينة، مما يجعل الترك غير نافذ إلا بموافقة المدعى عليه في بعض الظروف.
موافقة المدعى عليه على الترك :
المادة 142 تشترط موافقة المدعى عليه على الترك بعد إبداء طلباته. هذه الفقرة تعني أن المدعى لا يمكنه التنازل عن دعواه (أي “الترك”) بمجرد تقديم المدعى عليه دفوعه أو طلباته. ففي حالة تقديم المدعى عليه طلبات للمحكمة، يجب أن يحصل اتفاق بين الطرفين (المدعي والمدعى عليه) على قبول الترك، وذلك لضمان عدم تضرر المدعى عليه من هذا القرار.
الحالات التي لا يلتفت فيها اعتراض المدعى عليه :
تنص الفقرة الثانية من المادة 142 على أنه لا يُلتفت إلى اعتراض المدعى عليه على الترك في بعض الحالات التي تهدف إلى تعطيل سير الدعوى. وهذه الحالات تشمل:
-
الدفع بعدم اختصاص المحكمة: إذا كان المدعى عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، فإن اعتراضه على الترك بعد ذلك لا يُؤخذ به. هذه الحجة تعني أن المدعى عليه يحاول التهرب من مواجهة القضية في المحكمة التي أُقيمت أمامها، وبالتالي لا يُعتبر اعتراضه على الترك ذا تأثير قانوني.
-
الدفع بإحالة القضية إلى محكمة أخرى: في حال دفع المدعى عليه بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، يهدف ذلك إلى تأخير سير الدعوى أو تعطيل إجراءاتها. وبالتالي، لا يُلتفت إلى اعتراضه على الترك، لأن الحجة الأساسية هي تأخير القضية.
-
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى: إذا كان المدعى عليه قد دفع ببطلان صحيفة الدعوى، فهذا يمثل محاولة لعرقلة سير الدعوى منذ بدايتها. وفي هذه الحالة، لا يُسمح له بالاعتراض على الترك إذا كان هدفه هو تعطيل القضية أو منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.
-
طلب غير ذلك مما يهدف إلى تعطيل سير الدعوى: كما لو كان المدعى عليه يقدم طلبات تهدف إلى تأخير القضية أو منع المحكمة من سماعها، فإن اعتراضه على الترك في هذه الحالة لا يؤخذ به، حيث يكون الهدف الواضح هو تعطيل القضية وعدم تمكين المحكمة من الفصل فيها.
الغاية من المادة 142 :
الغرض من هذه المادة هو ضمان سير الدعوى بكفاءة وفعالية، ومنع أي طرف من محاولة عرقلة العدالة من خلال اعتراضات غير مبررة أو تهدف إلى تعطيل سير الدعوى. هذه المادة تحافظ على مبدأ حسن سير العدالة وتحقيق الحسم في القضايا دون التأخير بسبب مناورات من أي من الأطراف.
تطبيقات عملية للمادة 142 :
تتعدد التطبيقات العملية للمادة 142 في الحياة القضائية. فمثلاً:
-
في الدعاوى المدنية: إذا رفع شخص دعوى ضد آخر وطلب المدعى عليه دفعًا ببطلان صحيفة الدعوى أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، قد يؤدي ذلك إلى تأجيل القضية. إذا بعدها قرر المدعى التنازل عن الدعوى (الترك)، فلن يُسمح للمدعى عليه بالاعتراض على الترك إذا كان اعتراضه قائمًا على اعتراضات هدفها تعطيل سير الدعوى.
-
في الدعاوى التجارية: في الدعاوى التجارية، قد يرفع أحد الأطراف دعوى وتواجه المحكمة اعتراضات متعددة من المدعى عليه، كالدفع بعدم اختصاص المحكمة أو الدفع ببطلان الصحيفة. في حال قرر المدعى التنازل عن دعواه، لا يكون للمدعى عليه حق الاعتراض على الترك إذا كان اعتراضه قائمًا على تأخير الفصل في القضية.
خاتمة :
المادة 142 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تضع إطارًا قانونيًا هامًا في مسألة الترك في الدعاوى المدنية. فهي تهدف إلى منع أي من الأطراف من استخدام اعتراضاته كوسيلة لتعطيل سير الدعوى أو تأخير الحسم في القضايا، مما يساهم في تحسين سير العدالة ويضمن تحقيق الأحكام في وقت معقول.
شروط ترك الخصومة ومدى أهمية قبول المدعى علية للترك :
ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه أمام المحكمة، وهو إجراء طوعي يعكس رغبة المدعي في إنهاء الدعوى دون الحاجة لإصدار حكم فيها. لكن، وفقًا للقانون، لا يُعتبر الترك نافذًا إلا في ظل شروط محددة، مع ضرورة الحصول على موافقة المدعى عليه.
أول شرط أساسي لترك الخصومة هو أن يتم بإرادة المدعي وحده، أي أنه لا يمكن أن يتم الترك إلا إذا قرر المدعي التنازل عن دعواه بشكل صريح. لكن في بعض الحالات، لا يمكن أن يُنفذ هذا الترك إلا بموافقة المدعى عليه، خاصة عندما يتقدم الأخير بطلبات أو دفوع للمحكمة. هذه الموافقة تضمن عدم تضرر المدعى عليه من الترك أو تعرضه لأي أثر سلبي نتيجة لقرار المدعي بالتنازل.
أهمية قبول المدعى عليه للترك تكمن في عدة أمور رئيسية:
- حماية حقوق المدعى عليه: فبقبوله للترك، يُعتبر المدعى عليه قد تنازل عن أي حق في متابعة القضية أو في إبداء اعتراضاته القانونية ضدها.
- ضمان سير العدالة: إذا تم الترك بدون موافقة المدعى عليه في الحالات التي تُمكنه من الاعتراض، قد يؤدي ذلك إلى تعطيل سير العدالة، حيث يمكن أن تكون هناك محاولات غير مبررة لتعطيل سير الدعوى.
- منع المناورات: قبول المدعى عليه للترك يساعد في تجنب أن يكون الترك وسيلة لتهرب المدعي من متطلبات القضية أو لتجنب حكم قد يكون ضده.
لا يشترط قبول المدعى للترك في حالتين :
توجد حالتان استثنائيتان ينص القانون على أنه لا يشترط فيهما قبول المدعى عليه للترك، حيث يُسمح للمدعي بالتنازل عن دعواه دون الحاجة إلى موافقة المدعى عليه.
-
في حالة عدم تقديم المدعى عليه طلبات: إذا لم يقدم المدعى عليه أي طلبات أو دفوع للمحكمة، فإن المدعي يكون حرًا في ترك الدعوى دون أن يحتاج إلى موافقة المدعى عليه. ذلك لأنه في هذه الحالة لا يكون المدعى عليه قد بدأ في ممارسة حقوقه القانونية في القضية، وبالتالي لا يُعتبر اعتراضه على الترك ذا تأثير.
-
في حالة وجود اتفاق بين الطرفين: إذا كان هناك اتفاق بين المدعي والمدعى عليه على ترك الدعوى، فلا حاجة للحصول على قبول إضافي من المدعى عليه. وهذا يعني أن الطرفين قد اتفقا على إنهاء النزاع دون الحاجة لمتابعة الإجراءات القانونية في المحكمة، ما يجعل الترك نافذًا دون أي اعتراض.
في هاتين الحالتين، لا يعتبر القانون أن المدعى عليه قد تعرض لأي ضرر من جراء ترك الدعوى، لذلك يتم اعتبار الترك نافذًا دون الحاجة إلى موافقته.
الحالة الأولى : إذا لم يكن قد أبدى طلباته :
تنص المادة 142 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يكن المدعى عليه قد أبدى طلباته أمام المحكمة، فإن المدعي يكون حرًا في ترك الدعوى دون الحاجة إلى موافقة المدعى عليه. بمعنى آخر، إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم أي دفع أو اعتراض قانوني أو طلبات للمحكمة، فإن الترك يكون نافذًا بمجرد إرادة المدعي.
هذه الحالة تضمن للمدعي سرعة إنهاء النزاع دون تعقيدات أو تأخيرات قد تنتج عن اعتراضات من المدعى عليه. فإبداء المدعى عليه لطلباته يعد بمثابة بدءه في ممارسة حقوقه في الدفاع عن نفسه أو إبداء دفوعه القانونية، وبالتالي يصبح من الضروري الحصول على موافقته لتنفيذ الترك. أما في حالة عدم إبداء المدعى عليه لأي طلبات، فإن هذا يعكس غياب أي اهتمام أو اعتراض من جانبه على الدعوى، مما يسمح للمدعي باتخاذ القرار النهائي بترك الخصومة دون قيود.
هذا الوضع يهدف إلى تسريع الإجراءات القانونية، حيث أن عدم إبداء المدعى عليه لأي طلبات يعني أن القضية لم تشهد أي تدخل قانوني من جانبه، وبالتالي يمكن إنهاؤها بسهولة ودون اعتراض.
الحالة الثانية: إذا كان المدعى عليه قد دفع الدعوى بعدم الاختصاص :
تعتبر الحالة الثانية التي لا يشترط فيها قبول المدعى عليه للترك هي عندما يكون المدعى عليه قد دفع الدعوى بعدم اختصاص المحكمة. إذا كان المدعى عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعًا أو مكانًا، فإن ذلك يعتبر بمثابة اعتراض قانوني يهدف إلى تحديد المحكمة المختصة بنظر القضية، وبالتالي لا يُعتبر هذا الاعتراض مانعًا من ترك الدعوى.
في هذه الحالة، رغم أن المدعى عليه قد قدم دفعًا قانونيًا يتعلق بعدم اختصاص المحكمة، فإن هذا الدفع لا يؤثر على حق المدعي في ترك الدعوى. حيث يُعتبر دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص مجرد إجراء قانوني يتطلب من المحكمة أن تنظر فيه وتقرر بشأنه، لكنه لا يمنع المدعي من اتخاذ قراره بترك القضية سواءً كانت المحكمة المختصة أم لا.
الهدف من هذه الاستثناء هو أن الدفع بعدم الاختصاص لا يُعتبر اعتراضًا يهدف إلى تعطيل سير الدعوى أو منع المحكمة من الاستمرار في النظر في القضية، بل هو مجرد دفع يتعلق بتحديد السلطة القضائية المختصة. وبالتالي، لا يترتب عليه أي تأثير في حالة رغبة المدعي في ترك الدعوى، ويُسمح له بالترك دون الحاجة إلى موافقة المدعى عليه.
المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان :
إحالة القضية إلى محكمة أخرى أو الدفع ببطلان صحيفة الدعوى :
في بعض الحالات، لا يُشترط موافقة المدعى عليه على ترك الدعوى، ومنها إذا كان قد دفع بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى.
-
إحالة القضية إلى محكمة أخرى: إذا كان المدعى عليه قد طلب إحالة القضية إلى محكمة أخرى لعدم الاختصاص المحلي أو النوعي، فهذا يعني أنه يعترض على نظر المحكمة الحالية للقضية وليس على موضوع الدعوى نفسه. وبالتالي، لا يُعتبر اعتراضه على الترك ذا تأثير، حيث إن طلب الإحالة في حد ذاته لا يشكل دفاعًا في موضوع القضية، بل هو دفع شكلي.
-
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى: إذا كان المدعى عليه قد دفع ببطلان صحيفة الدعوى لأي سبب قانوني، مثل عدم استيفائها للشروط الشكلية أو عدم صحة إعلانها، فإن هذا الدفع يُعد من الدفوع الشكلية التي لا تمنع المدعي من ترك الدعوى. فالبطلان هنا لا يؤثر على الحق الموضوعي في إقامة الدعوى مجددًا، بل يتعلق بالإجراءات الشكلية فقط، لذا لا يلتفت لاعتراض المدعى عليه إذا قرر المدعي ترك الخصومة.
هذه الحالات تهدف إلى ضمان عدم استخدام الدفوع الشكلية كوسيلة لعرقلة سير العدالة أو منع المدعي من ممارسة حقه في ترك الدعوى عندما يرى ذلك مناسبًا.
صحيفة الدعوى أو أى طلب غير ذلك يكون الغرض منه منع المحكمة من المضى في سماع الدعوى فيما عدا هاتين الحالتين لا يتم الترك إلا بقبول المدعى عليه عند تعدد المدعى عليهم يجب قبولهم جميعا لترك الخصومة :
ترك الخصومة في حالة الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو أي طلب يهدف إلى منع المحكمة من نظر القضية :
إذا كان المدعى عليه قد دفع ببطلان صحيفة الدعوى أو تقدم بأي طلب آخر يكون الغرض منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى، فإنه لا يُعتد باعتراضه على ترك الخصومة. فالدفوع الشكلية، مثل بطلان الصحيفة أو طلبات تهدف إلى تعطيل الإجراءات، لا تمنح المدعى عليه حق الاعتراض على ترك الدعوى، لأن الهدف منها ليس الفصل في موضوع النزاع، بل عرقلة السير الطبيعي للقضية.
اشتراط قبول المدعى عليه لترك الخصومة :
فيما عدا الحالات المذكورة سابقًا، فإن ترك الخصومة لا يكون نافذًا إلا بموافقة المدعى عليه، خاصة إذا كان قد أبدى طلبات أمام المحكمة، حيث يُعتبر جزءًا من سير الدعوى وله حقوق قانونية مترتبة عليها.
حالة تعدد المدعى عليهم :
عند وجود أكثر من مدعى عليه في الدعوى، فإن ترك الخصومة لا يكون صحيحًا إلا بموافقة جميع المدعى عليهم. وذلك لضمان عدم الإضرار بأي طرف من أطراف النزاع، إذ قد يكون لبعض المدعى عليهم مصلحة في استمرار القضية حتى صدور حكم نهائي. لذا، يشترط القانون قبول جميع المدعى عليهم للترك، منعًا لأي تأثير سلبي على حقوق أي طرف في القضية.
الرجوع في الترك :
يُعد الترك إجراءً قانونيًا يقوم به المدعي للتنازل عن دعواه، ولكن قد يرغب المدعي في الرجوع عن هذا الترك بعد تقديمه. وفقًا للقانون، لا يجوز للمدعي الرجوع في الترك من تلقاء نفسه بمجرد تقديمه إلى المحكمة، بل يشترط لذلك موافقة المدعى عليه.
اشتراط موافقة المدعى عليه على الرجوع في الترك يهدف إلى حماية حقوقه، حيث إن قبوله للترك قد يكون قد أثر على موقفه القانوني في القضية. فإذا كان المدعى عليه قد قبل الترك أو بُني عليه أي إجراء قانوني آخر، فلا يمكن للمدعي التراجع عنه إلا إذا وافق المدعى عليه، وذلك ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للأطراف في النزاع.
بذلك، يُعد قرار الترك نهائيًا إلا إذا حصل المدعي على موافقة المدعى عليه للرجوع فيه، مما يمنع إساءة استخدام هذا الإجراء أو استغلاله كوسيلة للمناورة القانونية داخل المحكمة.
المادة 143 :
مادة 143 – يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى
تنص المادة 143 على أن الترك يؤدي إلى إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك رفع الدعوى، مما يعني اعتبارها كأنها لم تكن. كما يُلزم التارك بالمصاريف الناجمة عن الدعوى، وذلك لضمان عدم الإضرار بالطرف الآخر. ومع ذلك، فإن الترك لا يؤثر على الحق الموضوعي الذي تم رفع الدعوى بشأنه، حيث يظل لصاحب الحق إمكانية إعادة رفع الدعوى مستقبلًا إذا شاء، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
المادة 143: أثر الترك على إجراءات الخصومة والحقوق الموضوعية :
تعد المادة 143 من المواد القانونية المهمة التي تنظم أثر ترك الخصومة على الدعوى والإجراءات القضائية، حيث تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المدعي في التراجع عن دعواه وبين حماية المدعى عليه من التعسف في استخدام الحق في التقاضي.
مفهوم الترك وأثره على إجراءات الخصومة :
يُقصد بترك الخصومة تراجع المدعي عن الاستمرار في الدعوى التي أقامها، سواء تم ذلك بإرادته المنفردة أو بموافقة المدعى عليه، وفقًا لما يحدده القانون. ويترتب على هذا الترك، وفقًا لنص المادة 143، إلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك رفع الدعوى ذاتها، أي كأنها لم تُرفع من الأساس. وهذا يعني زوال جميع الآثار التي ترتبت على الدعوى منذ بدايتها.
الحكم على التارك بالمصاريف :
من الآثار الأساسية لترك الدعوى تحميل المدعي، الذي قرر ترك الخصومة، جميع المصاريف القضائية التي تكبدها الطرف الآخر بسبب رفع الدعوى. ويُعد هذا الإجراء وسيلة لضمان عدم استغلال الحق في التقاضي بطريقة تعسفية أو إرهاق الخصم بإجراءات لا فائدة منها.
عدم المساس بالحق الموضوعي :
رغم أن الترك يؤدي إلى إلغاء إجراءات الخصومة، إلا أنه لا يمس الحق الموضوعي الذي رفعت الدعوى من أجله. بمعنى أن المدعي يحتفظ بحقه في رفع الدعوى من جديد، متى شاء، طالما لم يسقط حقه بالتقادم أو لأي سبب قانوني آخر. وهذا يتيح للمدعي فرصة إعادة تقديم دعواه إذا توفرت لديه أدلة جديدة أو وجد أن الظروف أصبحت أكثر ملاءمة للمطالبة بحقه.
الفرق بين الترك والتنازل عن الحق:
من المهم التفرقة بين ترك الخصومة والتنازل عن الحق، حيث إن التنازل عن الحق يعني أن المدعي يتخلى نهائيًا عن موضوع الدعوى، مما يمنع إعادة رفعها مستقبلاً، بينما الترك يتعلق فقط بإجراءات التقاضي دون أن يؤثر على جوهر الحق ذاته.
الأثر العملي للمادة 143 في القضاء :
تُطبق المادة 143 بشكل عملي في المحاكم عندما يرى المدعي أن الاستمرار في الدعوى قد لا يكون في مصلحته، سواء لأسباب قانونية أو لعدم كفاية الأدلة أو لتغيير الظروف. ولكن عليه أن يدرك أن اتخاذ قرار الترك يترتب عليه التزامه بالمصاريف القضائية، مما يجعله قرارًا يحتاج إلى دراسة متأنية قبل الإقدام عليه.
خاتمة :
المادة 143 تحقق توازنًا بين مصلحة المدعي في حرية ترك الدعوى عند الحاجة، وبين حماية المدعى عليه من الإضرار به نتيجة التراجع المفاجئ عن الخصومة. كما أنها تمنح المدعي فرصة الاحتفاظ بحقه الموضوعي، مما يعزز مبادئ العدالة ويمنع استغلال النظام القضائي بشكل تعسفي.
وجوب التفرقة من حيث الآثار بين ترك الخصومة والنزول عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات :
يجب التفرقة بين ترك الخصومة والتنازل عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات من حيث الآثار القانونية المترتبة على كل منهما. فالترك، وفقًا للقانون، يؤدي إلى إنهاء الخصومة بالكامل وكأن الدعوى لم تُرفع، ويترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات السابقة وتحميل التارك المصاريف، دون المساس بالحق الموضوعي .
أما التنازل عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات، فيقتصر أثره على الإجراء ذاته، دون أن يؤدي إلى إنهاء الخصومة، حيث تظل الدعوى قائمة ويستمر نظرها أمام المحكمة، مما يتيح للمدعي متابعة السير في الدعوى وفقًا لما تبقى من إجراءات قانونية.
ترك الخصومة أمام الإستئناف لبعض المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة يعتبر تركا بالنسبة للباقين وضوابط ذلك :
عند ترك الخصومة في مرحلة الاستئناف من قبل بعض المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة، يُعتبر هذا الترك بمثابة ترك للدعوى بالنسبة لبقية الأطراف أيضًا، وذلك استنادًا إلى مبدأ وحدة النزاع في القضايا غير القابلة للتجزئة.
ويرجع ذلك إلى أن الحكم في مثل هذه المسائل لا يمكن أن يتجزأ بين الخصوم، إذ يجب أن يكون موحدًا لجميع الأطراف المعنية. ومع ذلك، يخضع هذا الأمر لعدة ضوابط، منها أن يكون الموضوع محل النزاع غير قابل للانقسام بطبيعته أو بحكم القانون، وألا يترتب على الترك الإضرار بحقوق باقي المحكوم لهم أو تغيير طبيعة الحكم الأصلي، مما يضمن تحقيق العدالة بين الأطراف كافة دون الإخلال بمراكزهم القانونية.
آثار الترك لا تترتب إلا من تاريخ الحكم بقبوله :
لا تترتب آثار ترك الخصومة إلا من تاريخ صدور الحكم بقبوله، مما يعني أن مجرد تقديم طلب الترك لا يؤدي تلقائيًا إلى إنهاء الدعوى أو إلغاء إجراءاتها. يظل النزاع قائمًا حتى تفصل المحكمة في الطلب، وتصدر حكمًا يقضي بقبول الترك، وعندها فقط تُلغى جميع إجراءات الخصومة بأثر فوري. وهذا يضمن استقرار الأوضاع القانونية، ويمنع إساءة استخدام حق الترك لتعطيل سير العدالة أو التأثير على مراكز الخصوم قبل الحصول على قرار قضائي نهائي.
المادة 144 :
مادة 144 – إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة او ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن
تنص المادة 144 من قانون المرافعات على أنه إذا نزل الخصم، مع قيام الخصومة، عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمنًا، اعتُبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن. ويعني ذلك أن الخصم يمكنه التنازل عن أي إجراء قانوني أو مستند تم تقديمه خلال سير الدعوى، سواء كان ذلك بشكل صريح عن طريق إعلان واضح، أو ضمنيًا من خلال أفعال تدل على التخلي عنه. ويترتب على هذا التنازل زوال الأثر القانوني للإجراء أو الورقة المتنازل عنها، كأنها لم تُقدم من الأساس، مما قد يؤثر على مسار الدعوى وفقًا لطبيعة الإجراء المتروك ومدى تأثيره على حقوق الخصوم.
المادة 144 من قانون المرافعات المصري تتعلق بالإجراءات التي يجب اتباعها عند تقديم الاستئناف على الأحكام الصادرة في القضايا المدنية. وتشمل تنظيمات خاصة بالوقت الذي يجب أن يتم فيه تقديم الاستئناف، وكذلك الإجراءات المتبعة في محكمة الاستئناف. من خلال هذه المادة، تهدف المشرع إلى ضمان سير العملية القانونية بشكل منظم وفعال. دعنا نستعرض تفاصيل المادة بشكل كامل.
نص المادة 144 من قانون المرافعات المصري:
تنص المادة 144 من قانون المرافعات على الآتي:
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة او ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن “
شرح وتفصيل المادة:
-
إيداع تقرير الاستئناف:
- تفرض المادة على الشخص الذي يرغب في الطعن على حكم صادر ضده أن يقوم بإيداع تقرير الاستئناف في قلم الكتاب داخل المدة المحددة وهي 15 يومًا من تاريخ صدور الحكم المستأنف.
- هذه المدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، مما يعني أن يوم صدور الحكم نفسه لا يُحتسب ضمن الأيام المخصصة لتقديم الاستئناف.
-
إجراءات الاستئناف:
- التقرير الرسمي: يجب أن يتم إيداع التقرير بشكل رسمي مع المحكمة. التقرير يجب أن يحتوي على تفاصيل الاستئناف بما في ذلك أسباب الاستئناف.
- المدة المحددة: يشير القانون إلى أن المدة المحددة هي 15 يومًا، والتي تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وتعد هذه المدة قصيرة مقارنة ببعض القوانين الأخرى في دول مختلفة، وهو ما يعكس أهمية الاستعجال في الطعن على الأحكام.
-
التوكيل الرسمي للمحامي:
- إذا كان المستأنف يقرن الاستئناف بمحامٍ، يجب على المحامي تقديم توكيل رسمي مصدق عليه من النقابة الفرعية التي ينتمي إليها.
- هذا يشير إلى ضرورة أن يكون المحامي مؤهلًا ومعترفًا به قانونيًا، مما يعزز من حماية الحقوق القانونية للمستأنف.
-
الهدف من المادة:
- الهدف الأساسي من المادة هو ضمان أن عملية الاستئناف تتم بسرعة وكفاءة، حتى لا يتأخر الفصل في المنازعات القضائية.
- تشدد المادة على ضرورة الالتزام بالمهل الزمنية لضمان عدم تعطيل سير العدالة، إذ أن التأخير في تقديم الاستئناف قد يؤدي إلى فقدان الحق في الطعن.
أهمية المادة 144:
- تعزيز العدالة: المادة 144 تسهم في تحسين سير العدالة وتفادي التأخير في الوصول إلى الحكم النهائي في القضايا. كما تضمن للأطراف المعنية حق الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم.
- الضبط القضائي: تساهم المادة في ضبط الإجراءات القضائية وتنظيم عملية الاستئناف، مما يقلل من الفوضى والازدواجية في محاكم الاستئناف.
- الحماية القانونية: تضمن المادة أن الاستئناف يتم بطريقة قانونية صحيحة، مما يمنح الأطراف فرصة عادلة لمراجعة الأحكام الصادرة ضدهم.
الخلاصة:
المادة 144 من قانون المرافعات المصري تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم عملية الاستئناف، حيث تضع إطارًا زمنيًا محددًا يجب على المستأنف الالتزام به. كما تشدد على ضرورة التوكيل الرسمي للمحامي إذا تم تمثيل الطرف في الاستئناف. تهدف المادة إلى تحقيق العدالة السرعية ومنع التأخير في الفصل في القضايا، مما يعزز من فاعلية النظام القضائي المصري.
التنازل عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات :
التنازل عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات هو أحد المفاهيم القانونية التي تشير إلى تنازل أحد أطراف الدعوى عن حقه في اتخاذ إجراء قانوني معين أو تقديم ورقة من أوراق المرافعات المطلوبة في سياق الدعوى .
قد يحدث هذا التنازل بناءً على اتفاق بين الأطراف أو بناءً على رغبة أحدهم في تسريع الإجراءات أو إنهاء النزاع بشكل سريع. على سبيل المثال، قد يتنازل المدعي عن حقه في تقديم مذكرة دفاع أو يتنازل أحد الأطراف عن الحق في طلب إحضار شهود معينين .
يعتبر التنازل عن إجراء قانوني أو ورقة من أوراق المرافعات غير ملزم إلا إذا تم التصريح به صراحة في الجلسة أو في وثيقة رسمية يتم تقديمها للمحكمة.
ومع ذلك، يجب أن يتم التنازل في إطار احترام القوانين والإجراءات القانونية المعمول بها، بحيث لا يؤثر ذلك سلبًا على حقوق الأطراف الأخرى في القضية.
المادة 145 من قانون المرافعات :
مادة 145 – النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به
مادة 145 من القانون تتعلق بمفهوم النزول عن الحكم وآثاره القانونية. تنص على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به، مما يعني أن الشخص الذي يتنازل عن الحكم الصادر لصالحه لا يمكنه الاحتفاظ بالحق الذي كان قد رُسخ لصالحه بناءً على ذلك الحكم. فالنزول عن الحكم يعتبر تنازلاً عن الحق ذاته، مما يعنى أنه لا يجوز له بعد ذلك المطالبة بهذا الحق في المستقبل، ولا يمكنه الرجوع إلى القضاء لاسترداده. هذه المادة تهدف إلى ضمان استقرار الأحكام القضائية وحماية حقوق الأطراف من التراجع عن القرارات النهائية التي تم اتخاذها.
المادة 145 – النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به :
تعتبر مادة 145 من القانون المدني واحدة من المواد التي تتعلق بمفهوم استقرار الأحكام القضائية وحماية الحقوق المكتسبة. إذ تنص هذه المادة على أن “النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به”، وهي قاعدة قانونية تضمن الحفاظ على استقرار العلاقات القانونية بين الأطراف وتمنع التلاعب بحقوق الأفراد عبر الرجوع في الأحكام النهائية التي تم تنفيذها.
النص القانوني للمادة 145:
تنص المادة 145 من القانون المدني على أنه: “النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به”. وهذه العبارة تحمل دلالة قانونية واضحة بأن تنازل الشخص عن حكم صادر لصالحه يعني بشكل تلقائي تنازله عن الحق الذي يترتب على هذا الحكم. بمعنى آخر، إذا قرر شخص ما أن يتنازل عن حكم قضائي صدر لصالحه، فإنه لا يمكنه بعدها المطالبة بالحق الذي استمده من هذا الحكم، ويُعتبر هذا التنازل شاملاً للحق بأكمله.
شرح وتفسير المادة:
النزول عن الحكم: يعني أن الشخص الذي صدر لصالحه حكم قضائي قد قرر التنازل عن هذا الحكم. وهذا قد يحدث في حالات عديدة، مثل قيام الشخص المتضرر بالتنازل عن حقه في الحصول على تعويض أو التنازل عن الحكم الصادر في قضيته لصالحه بسبب اتفاق مع الطرف الآخر أو لأسباب شخصية.
النزول عن الحق الثابت به: يشير إلى أن الشخص الذي يتنازل عن الحكم لا يمكنه الاحتفاظ بالحق الذي منح له بموجب هذا الحكم. فالنزول عن الحكم يؤدي إلى فقدان الحق الذي كان قد رُسخ بناءً عليه، ولا يجوز بعد ذلك للشخص الرجوع للمطالبة بهذا الحق أو الاحتفاظ به.
آثار النزول عن الحكم:
-
إغلاق الباب أمام المطالبة بالحق: بمجرد أن يتنازل الشخص عن الحكم، يصبح هذا التنازل نهائيًا، ولا يمكنه المطالبة بالحق الذي كان قد منحه له هذا الحكم في المستقبل. هذا يضمن استقرار القرارات القضائية ومنع التلاعب بالأحكام القضائية.
-
استقرار الحقوق: يساعد هذا المبدأ في الحفاظ على استقرار الحقوق في المجتمع القانوني. فلو كان بإمكان الأشخاص التراجع عن الأحكام التي تصدر لصالحهم متى شاءوا، لكان ذلك سيفتح بابًا كبيرًا للمنازعات القانونية المستمرة، وبالتالي، يعرقل سير العدالة.
-
حماية الأطراف الأخرى: من خلال ضمان أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق، يتم حماية الأطراف الأخرى من المماطلة أو التراجع عن الاتفاقات أو الأحكام بعد مرور الوقت، مما يساهم في استقرار التعاملات والعلاقات القانونية.
متى يتم النزول عن الحكم؟
يمكن أن يحدث النزول عن الحكم في عدة حالات:
- اتفاق بين الأطراف: في بعض الأحيان، قد يتفق الطرف الذي صدر لصالحه الحكم مع الطرف الآخر على التنازل عن الحكم وحقه الثابت به كجزء من تسوية أو تسوية ودية بينهما.
- رغبة في عدم الاستمرار في الإجراءات القضائية: قد يقرر الشخص الذي صدر لصالحه الحكم أنه لا يرغب في متابعة القضية أو الحصول على تنفيذ الحكم لأسباب شخصية أو عملية.
- التنازل في سياق صفقات تجارية أو اتفاقات: في بعض الأحيان، قد يتم التنازل عن الحكم في سياق صفقة تجارية أو اتفاق قانوني بين الأطراف.
الاستثناءات على قاعدة النزول عن الحق:
على الرغم من أن القاعدة العامة التي تنص عليها المادة 145 هي أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق، هناك بعض الاستثناءات التي يمكن أن تطرأ في بعض الحالات، مثل:
-
وجود نص قانوني آخر: قد توجد نصوص قانونية أخرى تتيح للشخص التراجع عن التنازل أو استعادة حقه في بعض الحالات الاستثنائية. على سبيل المثال، إذا كان التنازل عن الحكم قد تم تحت ضغط أو إكراه، قد يحق للطرف المتضرر الرجوع عن التنازل.
-
التنازل دون المساس بالحقوق الأساسية: في بعض الحالات، قد يكون التنازل عن الحكم لا يمس بالحقوق الأساسية أو الحريات العامة للفرد، مما يتيح له إمكانية استعادة هذه الحقوق.
خاتمة:
مادة 145 من القانون المدني تمثل مبدأ مهمًا في تحقيق العدالة وحماية استقرار الحقوق في المجتمع القانوني. من خلال التأكيد على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به، تساهم هذه المادة في منع التلاعب بالأحكام القضائية وضمان استقرار القرارات القضائية، مما يحافظ على الحقوق ويعزز الثقة في النظام القضائي .
هذه القاعدة تساعد على تسريع الإجراءات القضائية وحماية الأطراف من المماطلة أو الرجوع عن الأحكام بعد صدورها، مما يدعم تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.
التنازل عن الحكم :
التنازل عن الحكم هو إجراء قانوني يقوم من خلاله الشخص الذي صدر لصالحه حكم قضائي بالتخلي عن الحق الذي منح له بموجب هذا الحكم، سواء بشكل كلي أو جزئي .
ويعتبر التنازل عن الحكم من الوسائل التي قد يلجأ إليها الأطراف في بعض الحالات بهدف تسوية النزاع أو تجنب الاستمرار في الإجراءات القضائية، وقد يحدث هذا التنازل في قضايا متنوعة سواء كانت مدنية أو تجارية أو غيرها.
في حال التنازل عن الحكم، يفقد الشخص الذي تنازل عن الحكم الحق الذي استمده من هذا الحكم، ولا يجوز له المطالبة بهذا الحق في المستقبل.
يعد التنازل عن الحكم إجراء طوعيًا ومبنيًا على إرادة الأطراف، ولكن يجب أن يتم بشكل رسمي وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها لضمان أن يكون التنازل صحيحًا ونافذًا.
مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت . - 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني