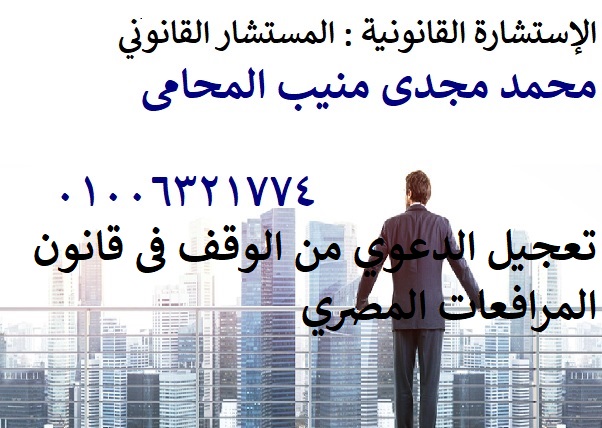في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُنظم وقف ميعاد الطعن في حالات استثنائية تهدف إلى حماية حقوق الأطراف وضمان عدم تعريضهم للضرر بسبب ظروف خاصة قد تمنعهم من ممارسة حقهم في الطعن. يتم وقف ميعاد الطعن في حالات معينة، ويُعتبر هذا الوقف إجراءً قانونيًا يسمح للأطراف بتأجيل اتخاذ إجراءات الطعن دون أن يتم اعتبار ذلك تنازلًا عن الحق.
من أبرز حالات وقف ميعاد الطعن هي إذا كان الطاعن في حالة عذر قهري، مثل حالة الوفاة أو المرض الذي يمنع الطاعن من اتخاذ الإجراءات القانونية في المدة المحددة. كما يمكن أن يتوقف ميعاد الطعن إذا كان الطاعن خارج البلاد ولا يستطيع العودة في الوقت المحدد للطعن.
وفي حالة وقف ميعاد الطعن، يستمر الميعاد في السريان بعد زوال السبب الذي أدى إلى الوقف، بمعنى أن الفترة التي توقفت فيها الإجراءات تُضاف إلى المدة الأصلية للطعن، مما يمنح الأطراف الوقت الكافي لإتمام الإجراءات.
يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف في الطعن ضد الأحكام القضائية في الحالات التي تمنعهم من الالتزام بالمواعيد القانونية بسبب ظروف استثنائية.
زوال وقف ميعاد الطعن في قانون المرافعات :
على سبيل المثال، إذا كان سبب وقف ميعاد الطعن هو مرض الطاعن أو سفره أو أي سبب آخر قانوني، فإن الميعاد يُستأنف من اليوم الذي ينقضي فيه هذا السبب، ولا يُحسب وقت العذر من ضمن المدة القانونية المحددة للطعن.
يُعد زوال وقف ميعاد الطعن أمرًا جوهريًا لضمان عدم تجاوز المدة القانونية المقررة للطعن، وبالتالي فإن زوال السبب لا يُعتبر تمديدًا للمواعيد السابقة، بل يُؤدي إلى استئناف سريان الميعاد في اليوم التالي لزوال العذر. يُعتبر هذا التنظيم وسيلة لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل، مع إعطاء الأطراف الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات المناسبة بعد زوال العذر الذي أوقف الميعاد.
المحكوم عليه في معنى المادة 216 :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تنص المادة 216 على أن “المحكوم عليه” هو الشخص الذي صدر ضده حكم قضائي نهائي في الدعوى ويكون ملزمًا بتنفيذ ما تضمنه هذا الحكم. وبحسب هذه المادة، فإن المحكوم عليه هو الذي يُلزم بتقديم الاستجابة لما تضمنه الحكم، سواء كان ذلك بالوفاء بمبالغ مالية، أو تنفيذ إجراءات معينة كإخلاء عقار أو أداء خدمة أو أي التزام آخر.
ويُشدد في المادة على أنه يجب على المحكوم عليه تنفيذ الحكم في المواعيد المحددة، وفي حال عدم التنفيذ يمكن أن تتخذ المحكمة الإجراءات اللازمة لإجباره على التنفيذ، مثل الحجز على الأموال أو اتخاذ تدابير أخرى. كما يُمنح المحكوم عليه الحق في الطعن على الحكم بالطريق القانوني المخصص لذلك مثل الاستئناف أو النقض ضمن المواعيد المقررة.
المادة 216 تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المحكمة والأطراف المحكوم عليهم، وضمان تطبيق العدالة عبر فرض الالتزام بالحكم القضائي وتنفيذ ما يترتب عليه من نتائج قانونية.
وفاة المحكوم عليه قبل إعلان الحكم عليه :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا توفي المحكوم عليه قبل أن يتم إعلانه بالحكم الصادر ضده، فإن هذا يؤثر على سير الإجراءات القانونية المرتبطة بالحكم. حيث يُعتبر الموت قبل إعلان الحكم بمثابة واقعة تؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم بشكل مؤقت، ويجب على المحكمة اتخاذ الإجراءات المناسبة في مثل هذه الحالات.
إذا توفي المحكوم عليه قبل إعلان الحكم، يتم وقف إجراءات الإعلان والطعن حتى يتم تحديد ما إذا كان الحكم سيتنقل إلى ورثته أم لا. في هذه الحالة، يُعتبر الورثة هم الذين يتعين عليهم استلام الإعلان بدلاً من الشخص المتوفى، ويحق لهم إبداء الرأي في الطعن على الحكم إذا رغبوا في ذلك.
كما يترتب على وفاة المحكوم عليه، خصوصًا في الحالات التي تتعلق بالديون أو الالتزامات المالية، أن الورثة قد يكونون مسؤولين عن دفع المبالغ المقررة في الحكم، وفقًا للأنصبة المقررة لهم من الميراث. في هذا السياق، يمكن للورثة تقديم اعتراضات أو طعون تتعلق بالحكم الصادر ضد المتوفى، وبتنفيذ الحكم وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لهذه الحالات.
إنقطاع سير الخصومة قبل صدور الحكم :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ينص على أنه في حال حدوث انقطاع في سير الخصومة قبل صدور الحكم، فإن هذا يؤدي إلى توقف الإجراءات القضائية مؤقتًا حتى يتم إزالة سبب الانقطاع. ويحدث انقطاع الخصومة في حالات مثل وفاة أحد الأطراف أو فقدان الأهلية أو في حال كان هناك سبب قهري يحول دون استمرار الخصومة.
عند انقطاع سير الخصومة، يُعتبر أن الإجراءات القانونية قد توقفت، وبالتالي يُعلق اتخاذ أي قرارات أو أحكام في الدعوى حتى يتم استئنافها. وفي حال حدوث وفاة أحد الأطراف، يجب على الورثة تقديم طلب إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات، وإذا كان هناك أي مانع قانوني آخر، فيجب على الطرف المعني تقديم ما يثبت زوال المانع لاستئناف الخصومة.
وبعد زوال سبب الانقطاع، يُستأنف سير الخصومة من النقطة التي توقفت عندها، ويُعطى الأطراف الوقت الكافي لاستئناف إجراءاتهم القانونية. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرار العدالة وعدم تعطيل حقوق الأطراف في حالة حدوث ظروف غير متوقعة تؤثر على سير الدعوى.
مكتب محامى صياغة وقضايا عقود الهبة والمقاولة
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني