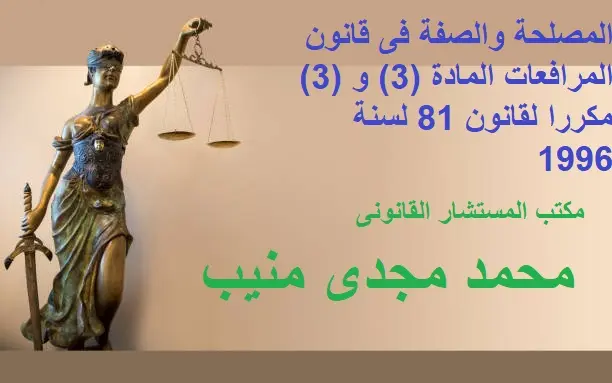المصلحة والصفة فى قانون المرافعات المادة (3) و (3) مكررا لقانون 81 لسنة 1996
تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات على
وتنص المادة 3 مكرر من ذات القانون على
ومن هذا النص يتبين ان المصلحة لها ثلاث شروط
- ان تكون المصلحة قانونية
- و ان تكون المصلحة قائمة
- ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة ” الصفة “
تعريف المصلحة فى القضاء
عبد المنعم الشرقاوى – نظرية المصلحة – ص 56
احمد مليجى – التعليق – ص 67
نقض 11/12/1947 – مجموعة أحكام النقض – المكتب – 1 – 13 – 623
المصلحة والصفة فى قانون المرافعات المادة (3) و (3) مكررا لقانون 81 لسنة 1996
نص المادة 3 من قانون المرافعات
ينص على أن أحكام قانون المرافعات تسري على جميع الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم، ما لم يكن هناك نص خاص في قانون آخر يقضي بخلاف ذلك. بمعنى آخر، تضع المادة قاعدة عامة تؤكد سريان قانون المرافعات على جميع الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم، سواء كانت مدنية أو تجارية، باستثناء الحالات التي يقر فيها قانون آخر قواعد خاصة تتعلق بنوع معين من الدعاوى.
أما المادة 3 مكررًا،
فهي تتعلق بتعديلات مهمة على إجراءات التقاضي، حيث تناولت تعديلًا في كيفية التعامل مع بعض الحالات التي قد تتطلب إجراءات استثنائية أو خاصة. المادة 3 مكررًا قد تنظم بعض القواعد التي تهدف إلى تسريع التقاضي أو تنظيم مواعيد السقوط أو غيرها من الإجراءات التي تستلزم تعديلًا في النظام القضائي ليواكب تطورات العصر.
وفيما يتعلق بالقانون 81 لسنة 1996، الذي يعدل قانون المرافعات،
فقد جاء هذا القانون ليضع تعديلات هامة على بعض النصوص الإجرائية بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل التراكمات في المحاكم. من أبرز هذه التعديلات كان تعديل مواعيد تقديم الطعون وزيادة الرقابة على التمسك بالدفوع أمام المحاكم. كما تم تعديل بعض الأحكام الخاصة بالإجراءات المتبعة في الدعاوى المدنية والتجارية، مما أسهم في تحسين فاعلية النظام القضائي.
باختصار، القانون 81 لسنة 1996 جاء لإحداث تغييرات مهمة على قانون المرافعات بهدف تيسير سير القضايا وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية، من خلال إضافة نصوص جديدة أو تعديل القواعد القائمة بما يتناسب مع الحاجة إلى إصلاح النظام القضائي.
المقصود بالمصلحة كشرط لقبول العوى ، أو أي طلب أو دفع أو طعن :
المصلحة هي شرط أساسي لقبول أي دعوى أو طلب أو دفع أو طعن في قانون المرافعات. وتعني المصلحة أن يكون للخصم الذي يرفع الدعوى أو يطلب أو يدافع أو يطعن في الحكم، فائدة قانونية مباشرة من نتيجة الحكم في الدعوى أو الطلب أو الدفع أو الطعن.
بمعنى آخر، يجب أن يكون للخصم مصلحة قانونية أو شخصية تُستفاد من الحكم في الموضوع المطروح أمام المحكمة، بحيث تكون النتيجة مؤثرة عليه بشكل مباشر.
على سبيل المثال،
في دعوى قضائية، لا يمكن لأي شخص رفع دعوى ما لم يكن له مصلحة قانونية فيها، مثل تعرضه لضرر أو انتهاك لحق من حقوقه. وبالمثل، فإن الطعن في حكم لا يُقبل إلا إذا كان الطاعن يملك مصلحة قانونية تتأثر بالحكم، سواء كان هذا الطعن يهدف إلى تصحيح حكم صدر ضده أو لتحسين وضعه القانوني.
يعتبر شرط المصلحة من الشروط الجوهرية التي تضمن أن تكون الدعاوى القضائية مبنية على أساس قانوني سليم وواقعي،
إذ يمنع رفع الدعاوى غير المبررة أو التي لا علاقة لصاحبها بها. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن يكون التقاضي موجهًا نحو تحقيق العدالة وحل المنازعات الفعلية التي تؤثر على حقوق الأطراف المتنازعة.
المقصود بلفظ (الطلب) ولفظ (الدفع) الواردان في المادة الثالثة :
في المادة الثالثة من قانون المرافعات، يُستخدم لفظ “الطلب” و”الدفع” للإشارة إلى نوعين مختلفين من الإجراءات التي يتخذها الأطراف في الدعوى القضائية.
الطلب في قانون المرافعات
يُقصد به كل ما يقدمه أحد أطراف الدعوى من طلبات للمحكمة بهدف الحصول على حكم في موضوع الدعوى أو في بعض القضايا الفرعية المرتبطة بها. يمكن أن يشمل الطلبات التي تتعلق بالموضوع الرئيسي للدعوى مثل طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي أو القيام بفعل معين، أو طلب اتخاذ إجراءات مؤقتة مثل طلب الحجز أو فرض تدابير احترازية. الطلب يتم تقديمه من قبل الطرف الذي يرغب في الحصول على قرار من المحكمة بشأن مسألة معينة في القضية.
أما “الدفع” فى قانون المرافعات
فيعني التصرف القانوني الذي يقوم به أحد أطراف الدعوى للطعن في صحة الدعوى أو دفع المطالبة بناءً على أسباب قانونية تتعلق بصحة الإجراءات أو وقائع معينة. الدفع قد يتضمن الاعتراض على الاختصاص، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود عيوب في الإجراءات، أو الدفع بعدم وجود مصلحة قانونية للطرف المدعي، أو الدفع بالتقادم. على عكس الطلب، لا يهدف الدفع إلى طلب حكم بشأن الموضوع الفعلي للدعوى، وإنما هو مجرد اعتراض قانوني يهدف إلى منع سير الدعوى أو التأثير في الطريقة التي ستُنظر بها.
التمييز بين “الطلب” و”الدفع” في المادة الثالثة من قانون المرافعات يساعد في تحديد كيفية التعامل مع كل منهما، حيث يعكس الطلب الرغبة في الحصول على حكم في الموضوع، بينما يعكس الدفع سعيًا لرفض الدعوى أو الاعتراض على سيرها.
خصائص المصلحة الواجب توافرها كشرط لقبول الدعوى ، أو أى طلب أو دفع أو طعن :
المصلحة هي أحد الشروط الأساسية لقبول الدعوى أو أي طلب أو دفع أو طعن في قانون المرافعات. تُعتبر المصلحة العنصر الجوهرى الذي يجب أن يتوافر لكل من يتقدم بدعوى أمام المحكمة أو يرفع أي طلب أو دفع، حيث بدون مصلحة قانونية واضحة لا يمكن للخصومة القضائية أن تقوم.
المصلحة يجب أن تكون مشروعة ومباشرة،
أي أن يكون المدعي أو مقدم الطلب أو الطاعن قد تأثر بشكل مباشر من النزاع أو القضية المطروحة أمام المحكمة. فلا يجوز لأي شخص رفع دعوى أو تقديم طلب أو دفع أو طعن لمجرد أنه يتدخل في القضايا التي لا تؤثر عليه شخصيًا أو لا تمس حقوقه، بل يجب أن تكون له مصلحة قانونية قائمة تتعلق بالحق المدعى به.
كما أن المصلحة يجب أن تكون قائمة بالفعل وليست مجرد مصلحة محتملة أو مستقبلية،
أي أن المدعي يجب أن يواجه ضررًا أو خطرًا حقيقيًا يستوجب التدخل القضائي. كما يجب أن تكون المصلحة قانونية ومشروعة، فلا يجوز للمتقاضين أن يرفعوا دعاوى أو طلبات أو طعون استنادًا إلى مصالح غير قانونية أو مخالفة للنظام العام.
وبناءً عليه، يعتبر شرط المصلحة أحد الضمانات القضائية التي تهدف إلى منع تحريك الدعوى أو الطعون من قبل الأطراف الذين لا يمتلكون حقًا مشروعًا أو مصلحة واضحة في القضية، مما يسهم في تحقيق العدالة وضمان حسن سير القضاء.
أولا : يجب أن تكون المصلحة قانونية :
يجب أن تكون المصلحة قانونية وفقًا لقانون المرافعات، بمعنى أنه لا يكفي أن تكون المصلحة مجرد مصلحة شخصية أو غير قانونية، بل يجب أن تتوافر في الدعوى أو الطلب أو الدفع أو الطعن مصلحة قانونية مشروعة تتوافق مع القواعد القانونية والنظام العام. فالمصلحة القانونية تعني أن الشخص الذي يرفع الدعوى أو يقدم الطلب أو الطعن يجب أن يكون له حق قانوني مشروع يمكنه الدفاع عنه أو المطالبة به أمام المحكمة.
المصلحة القانونية تقتضي أن تكون مرتبطة مباشرة بالحق المطالب به في الدعوى، وألا تكون المصلحة مجرد رغبة في الحصول على فائدة شخصية أو منفعة غير قانونية. على سبيل المثال، لا يمكن لأحد أن يرفع دعوى لحماية مصلحة غير مشروعة أو تتنافى مع القانون، مثل الدعوى التي تهدف إلى الإضرار بالآخرين أو الطعن في قرار قضائي ليس له علاقة بمصلحة المدعي.
وبذلك، فإن المصلحة القانونية هي شرط أساسي لقبول الدعوى أو الطلب أو الدفع أو الطعن، حيث أن المحكمة لا تتعامل مع القضايا التي لا تتضمن مصلحة قانونية حقيقية للأطراف المعنية، لأن ذلك يعد مضيعة للوقت والموارد القضائية ويخالف أساسيات العدالة.
ثانيا : يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وعلاقة ذلك بشرط الصفة في الدعوى :
يشترط في المصلحة التي تقوم عليها الدعوى في قانون المرافعات أن تكون شخصية ومباشرة، بمعنى أن يكون الشخص الذي يرفع الدعوى هو الذي يتأثر بشكل مباشر بالنتيجة القانونية التي ستترتب على الحكم، ويجب أن تكون المصلحة متعلقة به شخصيًا وليست مصلحة عامة أو مجردة. وبالتالي، لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى لمجرد الدفاع عن مصلحة شخص آخر، إلا إذا كان له تفويض قانوني أو مصلحة مباشرة في القضية.
المصلحة الشخصية تعني أن صاحب الدعوى يجب أن يكون صاحب الحق أو المصلحة التي يتم الدفاع عنها، فلا يجوز لأحد رفع دعوى تتعلق بمصلحة شخص آخر إلا إذا كان له صفة قانونية تمكنه من ذلك. أما المباشرة فتعني أن المصلحة يجب أن تكون قائمة على ضرر أو انتهاك لحق واقع على المدعي نفسه في الوقت الحالي، ولا يمكن قبول دعاوى مستقبلية غير قائمة على ضرر ملموس ومباشر.
ترتبط المصلحة ارتباطًا وثيقًا بـ شرط الصفة في الدعوى، حيث لا يمكن قبول الدعوى من شخص لا يمتلك صفة قانونية تتيح له المطالبة بحقوقه أو الدفاع عنها. فمثلاً، إذا كان شخص آخر هو المتضرر من تصرف قانوني أو قرار، فإنه لا يستطيع رفع دعوى إلا إذا كان له الصفة القانونية التي تتيح له ذلك، مثل أن يكون وكيلاً عن الشخص المتضرر أو يكون هو نفسه المتضرر المباشر. إذا كانت المصلحة غير شخصية أو غير مباشرة، فإن الدعوى ستكون غير مقبولة، مما يؤدي إلى رفضها من المحكمة.
وبذلك، يُعد توافر المصلحة الشخصية والمباشرة شرطًا أساسيًا لقبول الدعوى، ويُعتبر جزءًا من شروط أخرى مثل الصفة و الحق، مما يساهم في تنظيم وتقنين التقاضي لضمان أن الدعوى تستند إلى أساس قانوني صحيح وواقعي.
الإستثنئات من شرط المصلحة الشخصية المباشرة :
رغم أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يعد من الشروط الأساسية لقبول الدعوى أو الطعن أو الطلب في قانون المرافعات، إلا أن هناك بعض الاستثناءات التي تتيح للمتقاضين رفع دعاوى أو تقديم طلبات أو طعون دون أن تكون لهم مصلحة شخصية مباشرة في القضية، وذلك في الحالات التي يحددها القانون.
من أبرز هذه الاستثناءات، هي الدعاوى التي يرفعها الشخص بصفته “مدعيًا عامًا” أو “مندوبًا عن مصلحة عامة”، مثل الدعاوى التي يرفعها المدعي العام أو النيابة العامة في القضايا الجنائية أو القضايا التي تتعلق بالنظام العام أو مصلحة المجتمع. في هذه الحالات، لا يشترط أن يكون المدعي له مصلحة شخصية مباشرة، بل يكفي أن تكون الدعوى تهدف إلى حماية المصلحة العامة أو حقوق المجتمع.
كذلك، توجد استثناءات تتعلق بحالات معينة يرفع فيها بعض الأفراد دعاوى نيابة عن الآخرين، مثل الدعاوى التي تتعلق بحقوق الأشخاص غير القادرين على الدفاع عن أنفسهم، أو في حالة الطعون التي تهدف إلى الطعن في قرارات إدارية تضر بمصلحة أفراد أو فئات معينة، مثل الطعون في القرارات الإدارية التي تؤثر على الحقوق المدنية أو الاجتماعية لمجموعة من الأفراد.
وبذلك، يُمكن القول إن الاستثناءات من شرط المصلحة الشخصية المباشرة تتيح للأشخاص رفع دعاوى أو تقديم طعون في حالات خاصة تتعلق بحماية النظام العام أو مصلحة مجموعة معينة من الأفراد، وبالتالي يتم تجاوز هذا الشرط لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
إستثناء أول : الدعوى غير مباشرة :
الدعوى غير المباشرة هي الدعوى التي يُرفع فيها الشخص الدعوى نيابة عن شخص آخر لمصلحة هذا الآخر، ولكنه لا يمتلك مصلحة مباشرة في النتيجة التي ستترتب على الحكم في الدعوى. ويحدث ذلك عندما يكون المدعى هو شخص لا يتأثر مباشرة بالحكم في القضية ولكنه يرفع الدعوى لحماية حقوق شخص آخر.
في قانون المرافعات، لا تقبل الدعوى غير المباشرة إذا كانت لا تنطوي على مصلحة مباشرة للشخص الذي يرفع الدعوى. ويشترط في هذه الحالة أن يكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي في القضية، وإلا يُعتبر المدعي غير مستوفي لشروط قبول الدعوى. فعلى سبيل المثال، لا يمكن لشخص أن يرفع دعوى نيابة عن آخر لمجرد أن يكون له رأي في القضية أو يشعر بتعاطف مع المدعى عليه أو المدعي.
ومع ذلك، هناك حالات استثنائية في القانون تسمح للشخص برفع دعوى نيابة عن آخر، مثل حالات التفويض القانوني أو الوكالة أو عندما يكون للمدعي حق قانوني أو مصلحة ترتبط بشكل غير مباشر بالقضية، مثل الوصي أو الوكيل الذي يرفع دعوى لحماية حقوق القاصر أو الموكل.
الدعوى غير المباشرة يمكن أن تثير قضايا تتعلق بالمصلحة والصفة، إذ يجب على المدعي أن يثبت أنه يرفع الدعوى استنادًا إلى مصلحة قانونية قريبة أو حق معين يستند إلى تفويض أو علاقة قانونية تمكنه من ممارسة هذا الحق.
إستثناء ثان : دعاوى النقابات والجمعيات :
دعاوى النقابات والجمعيات في قانون المرافعات هي دعاوى يمكن أن ترفعها هذه الكيانات بصفاتها القانونية لحماية مصالح أعضائها أو مصالحها الخاصة، سواء كانت تتعلق بحقوق مهنية أو اجتماعية أو أي قضايا أخرى تهم أعضائها أو الغرض الذي أنشئت من أجله. ويُعتبر قانون المرافعات مرجعًا أساسيًا لتنظيم كيفية تقديم هذه الدعاوى أمام المحاكم.
النقابات والجمعيات تمتلك حق التقاضي أمام المحاكم لرفع الدعاوى المتعلقة بحقوق أعضائها، خاصة في القضايا التي تتعلق بالحقوق العمالية أو المهنية مثل دعوى إلغاء قرارات إدارية، أو الدفاع عن حقوق الأعضاء في إطار تنظيمات العمل أو النقابة، أو الطعن في قرارات المخالفة للقوانين المنظمة لمجالاتها. كما يمكن أن تكون النقابات والجمعيات طرفًا في قضايا أخرى تتعلق بالنظام العام أو الحقوق الجماعية لأعضائها، مثل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء النقابة أو الجمعية.
ومن الناحية القانونية، تشترط أن ترفع النقابات أو الجمعيات الدعاوى بصفة قانونية وصحيحة، مما يعني أن تكون الدعوى ذات علاقة مباشرة بمصلحة أعضاء النقابة أو الجمعية وأن يكون هناك نص قانوني يخول هذه الكيانات رفع مثل هذه الدعاوى. وهذا يُعد استثناءً من شرط المصلحة الشخصية المباشرة، حيث يكفي أن يكون للنقابة أو الجمعية مصلحة قانونية أو اجتماعية لتحريك الدعوى.
بالتالي، فإن قانون المرافعات يتيح للنقابات والجمعيات الحق في رفع الدعاوى التي تتعلق بمصالح أعضائها أو حقوقهم الجماعية، مما يسهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية بشكل منظم وفعال.
إستثناء ثالث : دعوى الحسبة :
دعوى الحسبة في قانون المرافعات هي دعوى خاصة يمكن رفعها من قبل أي شخص يمتلك مصلحة عامة أو يسعى لحماية المصلحة العامة ضد تصرفات قد تمس النظام العام أو القيم الاجتماعية أو المصلحة الجماعية. وتعد دعوى الحسبة من الدعاوى التي يمكن أن يُرفعها الأفراد دون أن يكون لديهم مصلحة شخصية مباشرة في الموضوع المتنازع عليه، بل يكون الهدف منها هو الحفاظ على المصلحة العامة أو تطبيق القانون.
تتمثل دعوى الحسبة في مطالبة المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تصرف أو عمل من شأنه أن يضر بالصالح العام أو يخالف القوانين التي تساهم في تنظيم المجتمع. ويعد رفع هذه الدعوى استثناءً من شرط المصلحة الشخصية المباشرة، حيث يُسمح لأي شخص أن يتقدم بها إذا كان التصرف المستهدف يتعارض مع النظام العام أو القيم الاجتماعية الأساسية.
تعود جذور دعوى الحسبة إلى الشريعة الإسلامية، حيث كانت تتيح للأفراد تحريك الدعوى ضد أي تصرف مخالف للشرع أو النظام، وفيما يخص قانون المرافعات، فإن الدعوى تُستخدم في الحالات التي يكون فيها التصرف غير قانوني أو يشكل تهديدًا للنظام العام، ويعهد للمحكمة النظر فيها واتخاذ القرار المناسب.
وعلى الرغم من أن دعوى الحسبة لا تتطلب مصلحة شخصية للطرف الذي يرفعها، إلا أنه يجب أن يتوافر فيها الشرط الأساسي وهو أن يكون الهدف من رفع الدعوى حماية المصلحة العامة.
قانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية :
صدر قانون رقم 3 لسنة 1996 لتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، وهو قانون يهدف إلى تمكين أي شخص من رفع دعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية تتعلق بمخالفة أو الإضرار بمصالح الأفراد أو المجتمع، وذلك بناءً على مصلحة قانونية أو عامة.
تشمل هذه الدعاوى القضايا التي تتعلق بالزواج والطلاق والميراث والنفقة والأبوة، حيث يُسمح لأي فرد بمباشرة دعوى الحسبة أمام المحاكم لطلب تصحيح وضع قانوني أو إثبات حق أو إلغاء تصرفات قانونية غير مشروعة، حتى لو لم يكن هذا الشخص هو المتضرر المباشر. وبموجب هذا القانون، يُمنح القاضي صلاحية النظر في الدعاوى التي ترفع من غير أطراف النزاع الأساسيين إذا كانت تتعلق بالحقوق العامة أو حماية مصالح الأسرة والمجتمع.
يتضمن القانون إجراءات محددة تتعلق بكيفية رفع دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، حيث يتطلب تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتوفير الأدلة والشهادات المتعلقة بالقضية، مما يتيح للمحكمة النظر فيها والفصل في الموضوع بما يتفق مع الشريعة والقانون.
وبذلك، يُعتبر هذا القانون بمثابة وسيلة قانونية للرقابة على تصرفات الأفراد في مسائل الأحوال الشخصية من أجل حماية الحقوق وحسن تطبيق القانون، ويساهم في تحقيق العدالة في القضايا التي تتعلق بالعلاقات الأسرية.
إختصاص النيابة العامة برفع دعاوى الحسبة ومدى تأثير القانون 81 لسنة 1996 على دعاوى الحسبة :
اختصاص النيابة العامة برفع دعوى الحسبة يُعتبر من أبرز الخصائص التي تميز هذه الدعوى في القانون المصري. حيث تُمنح النيابة العامة الحق في رفع دعوى الحسبة أمام المحاكم، وذلك عندما يتعلق الأمر بمصلحة عامة أو النظام العام. يمكن للنيابة أن تتحرك في هذا الشأن من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى من أي شخص آخر، وذلك بهدف حماية المصلحة العامة التي قد تتأثر بتصرفات فردية تخالف القانون أو القيم الاجتماعية.
وتُعتبر دعوى الحسبة أداة لحماية النظام العام أو الحقوق الجماعية، ولا تتطلب أن يكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة. وقد كانت النيابة العامة تمثل جهة أساسية في تحريك هذه الدعاوى ضد المخالفات التي تمس الصالح العام.
أما فيما يتعلق بتأثير القانون 81 لسنة 1996 على دعاوى الحسبة، فقد جاء هذا القانون ليُحدث تعديلات هامة في العديد من أحكام قانون المرافعات، وكان له بعض التأثير على الإجراءات المتعلقة بدعاوى الحسبة. القانون 81 لسنة 1996 عمل على تعديل بعض النصوص والإجراءات بما يساهم في تسريع القضايا القضائية وتنظيم الإجراءات بشكل أكثر كفاءة، كما كان له دور في تقليل التراكمات في المحاكم. ومن ناحية أخرى، لم يلغي هذا القانون اختصاص النيابة العامة في رفع دعوى الحسبة، لكنه قد يكون قد ساهم في تحسين آلية التعامل مع هذه الدعاوى بما يتوافق مع مقتضيات العدالة ومعالجة القضايا المتعلقة بالنظام العام والمصلحة العامة.
وبذلك، يمكن القول إن قانون 81 لسنة 1996 أتاح تحسينًا في الإجراءات المتبعة، لكنه لم يؤثر بشكل جوهري على اختصاص النيابة العامة في رفع دعاوى الحسبة، مما يضمن استمرار دورها في الحفاظ على النظام العام وحماية حقوق المجتمع.
قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الإحوال الشخصية الجديد رقم 1 لسنة 2000 نص على عدم المساس بإختصاص النيابة العامة :
قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الجديد رقم 1 لسنة 2000 نص على عدم المساس باختصاص النيابة العامة في قانون المرافعات. حيث أكد القانون على دور النيابة العامة في التدخل في قضايا الأحوال الشخصية لضمان حماية حقوق الأطفال، والنساء، وحفظ النظام العام. ويعني ذلك أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص في هذه القضايا، خاصة فيما يتعلق بالتأكد من حسن تطبيق القوانين المتعلقة بالطلاق، والنفقة، والحضانة، والميراث. هذا التوجه يعكس حرص المشرع على ضمان التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق المجتمع، وكذلك التأكيد على الرقابة القضائية الدقيقة لضمان العدالة في القضايا ذات الطابع الشخصي والعائلي.
رفع دعوى الحسبة في قانون المرافعات :
دعوى الحسبة هي دعوى ترفع أمام المحاكم من قبل أي شخص له مصلحة قانونية عامة أو شخصية لحماية النظام العام أو حقوق الأفراد في المسائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية أو الشؤون الاجتماعية. يُسمح للأفراد برفع دعوى الحسبة بناءً على مصلحتهم في تصحيح وضع قانوني أو للحفاظ على حقوق أساسية قد تكون مهددة أو غير محمية.
في قانون المرافعات، تعتبر دعوى الحسبة من الإجراءات القضائية التي تتمثل في تدخل القاضي للحفاظ على العدالة وحماية الحقوق حتى في غياب الأطراف المتضررة. ويمكن أن ترفع هذه الدعوى في حالات مثل المطالبة بإبطال عقد مخالف للقانون أو الشريعة، أو طلب تدابير للحفاظ على المصلحة العامة أو حقوق الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج، الطلاق، أو الميراث.
تُرفع دعوى الحسبة أمام المحكمة المختصة في الأحوال الشخصية، وعادة ما يُشترط أن يكون المدعي قد تأثر بشكل غير مباشر بالتصرفات أو الأوضاع التي يطالب بتغييرها أو تصحيحها. وتختلف دعوى الحسبة عن الدعاوى التقليدية من حيث أن المدعي قد لا يكون هو المتضرر المباشر، بل يرفع الدعوى لمصلحة عامة أو حماية للحقوق في سياق يهم المجتمع أو الأفراد.
من خلال رفع دعوى الحسبة، يُمكن للأفراد الحصول على حماية قانونية وتطبيق الإجراءات القضائية التي تصون الحقوق وتُعزز من حماية النظام العام، وذلك ضمن إطار قانوني يسمح بتفعيل الرقابة القضائية على التصرفات التي تضر بمصلحة المجتمع أو الأفراد.
إستثناء رابع : الدعاوى التي ترفعها النيابة العامة :
في قانون المرافعات المصري، ترفع النيابة العامة العديد من الدعاوى بهدف حماية حقوق الأفراد وضمان تطبيق القانون، وتعد النيابة طرفًا أساسيًا في بعض القضايا. ومن أبرز الدعاوى التي ترفعها النيابة العامة هي:
- الدعاوى التي تتعلق بالأحوال الشخصية: حيث تتدخل النيابة العامة في مسائل مثل الطلاق، والنفقة، والحضانة، والوصاية، لحماية حقوق الأطراف، خاصةً حقوق الأطفال والنساء.
- الدعاوى المتعلقة بالأموال العامة: ترفع النيابة العامة دعاوى لحماية المال العام من الفساد أو التعدي عليه، حيث تقوم برفع القضايا في مواجهة الأفراد الذين يقومون بإهدار المال العام أو التعدي عليه.
- الدعاوى الجنائية: تتولى النيابة العامة رفع الدعاوى الجنائية في الجرائم التي تمس أمن المجتمع والنظام العام، سواء كانت جرائم جنائية عادية أو جرائم متعلقة بالأمن الوطني.
- الدعاوى المتعلقة بالحق العام: تشمل القضايا التي تمس النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة، حيث ترفع النيابة الدعاوى لمصلحة المجتمع ككل.
دور النيابة العامة في رفع هذه الدعاوى يهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة، بالإضافة إلى تعزيز النظام القانوني في البلاد.
ثالثا :يجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة إلا إذا كان الغرض من الطلب الاحتياطي لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه في قانون المرافعات :
يشترط في الدعوى أو الطلب المرفوع أمام المحكمة أن تكون المصلحة قائمة وحالة، أي أن تكون المصلحة التي يطالب بها المدعي موجودة بالفعل وواقعية في الوقت الراهن، وليست مصلحة محتملة أو مستقبلية غير مؤكدة. بمعنى آخر، يجب أن يكون المدعى به ضرر أو حاجة فعلية تتطلب تدخل المحكمة لحمايته أو لتقرير حقه في المسألة المطروحة.
ومع ذلك، فإن القانون يتيح استثناءات لهذه القاعدة في بعض الحالات، مثل عندما يكون الغرض من الطلب الاحتياطي هو دفع ضرر محدق. في هذه الحالات، يمكن للمدعي أن يرفع طلبًا احتياطيًا حتى وإن كانت المصلحة لم تتحقق بشكل كامل بعد، ولكن ذلك يكون للحفاظ على حقوقه أو منع ضرر وشيك قد يترتب على تأخير التقاضي. على سبيل المثال، في الحالات التي يكون فيها الخطر محدقًا ويفرض اتخاذ إجراء فوري لحماية الحق من التهديد بالزوال أو الانتقاص.
كذلك، يجوز للمدعي طلب الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، بمعنى أنه إذا كان هناك حق يرغب المدعي في إثباته، ويخشى أن الزمان أو الظروف قد تؤدي إلى فقدان الأدلة التي تدعمه، يمكنه طلب إجراء احتياطي لتوثيق هذا الحق أو الحماية منه حتى يتمكن من تقديمه في النزاع المستقبلي.
هذه الاستثناءات تضمن حماية الحقوق في حالات الضرورة أو عند وجود احتمال حقيقي بأن الأدلة قد تتلاشى أو الحق قد ينقضي بسبب تأخير الإجراءات، مما يساهم في توفير العدالة وحماية المصالح المشروعة للأفراد.
المصلحة في دعوى قطع النزاع :
في قانون المرافعات المصري، تعتبر المصلحة شرطًا أساسيًا لرفع دعوى قطع النزاع، حيث لا يجوز لأي شخص أن يرفع دعوى أمام المحكمة إلا إذا كانت لديه مصلحة شخصية ومباشرة في الفصل في النزاع.
دعوى قطع النزاع هي الدعوى التي تهدف إلى إنهاء حالة من التنازع بين طرفين حول حق أو ملكية أو موقف قانوني معين. والمصلحة في هذه الدعوى تتعلق بحماية حقوق المدعي من أي تأثير سلبي قد ينشأ من استمرار النزاع أو عدم الفصل فيه. بعبارة أخرى، يجب أن يكون للمدعي مصلحة قانونية، سواء كانت مصلحة مالية أو غير مالية، من حسم النزاع بشكل نهائي، بحيث يترتب على حكم المحكمة في هذه الدعوى تغيير أو تثبيت الوضع القانوني له.
وفي ضوء ذلك، يحدد القضاء المصلحة بشكل دقيق من خلال التحقق من وجود حق واضح للمدعي في النزاع المثار. إذا لم تكن هناك مصلحة حقيقية، فإن المحكمة ترفض الدعوى بناءً على عدم توافر الشرط الأساسي لرفع الدعوى.
المصلحة في الدعاوى التقديرية :
الدعاوى التقديرية هي تلك التي تتعلق بالقضايا التي يترك فيها للقاضي تقدير حكمه بناءً على الظروف والملابسات الخاصة بكل قضية، مثل القضايا التي يترتب عليها تقدير القيم المالية أو تحديد الضرر أو تحديد مدة معينة. وفي هذه الدعاوى، تكون المصلحة شرطًا أساسيًا لقبول الدعوى، ولكن يختلف تقييم المصلحة فيها مقارنة بالقضايا التقليدية.
في الدعاوى التقديرية، لا يُشترط أن تكون المصلحة ملموسة أو محددة بالقدر الكافي كما في القضايا الأخرى. إذ قد تتعلق المصلحة في هذه الحالات بحق قانوني لا يمكن تحديد قيمته بشكل دقيق أو قد تتعلق بضرر غير مباشر أو غير متوقع، ولكن يُشترط أن تكون المصلحة قائمة وحقيقية، ويجب أن يكون للمدعي مصلحة قانونية أو شخصية تتأثر بالنتيجة المحتملة للحكم.
على سبيل المثال، في قضايا تقدير التعويضات أو تحديد العقوبات، يمكن للمدعي أن يُرفع دعوى تقديرية طالما كان له مصلحة في أن يتم تقدير التعويض بشكل عادل، حتى وإن كان الضرر قد لا يكون محددًا بدقة. يمكن أيضًا أن يكون للمدعي مصلحة في طلب تقدير قسط النفقة في قضية أحوال شخصية، أو تحديد مدة معينة للمطالبة بحقوقه، بناءً على ظروف خاصة قد تختلف من قضية لأخرى.
إذن، في الدعاوى التقديرية، يعتمد قبول الدعوى على مدى توافر مصلحة قائمة وحقيقية في القضية، مع مراعاة أن تقدير المحكمة قد يكون مرنًا ويستند إلى محاكمة ظروف القضية والحقوق التي يطالب بها المدعي.
المصلحة في دعوى وقف الأعمال الجديدة :
في قانون المرافعات المصري، تُعد المصلحة من الشروط الأساسية لقبول دعوى وقف الأعمال الجديدة، وهي الدعوى التي تهدف إلى وقف الأعمال التي تقوم بها إحدى الأطراف وتؤثر سلبًا على حقوق الطرف الآخر أو على الملكية الخاصة به. ويشترط في المدعي أن يكون له مصلحة مباشرة وحقيقية من وقف الأعمال التي يطالب بوقفها، بمعنى أن استمرار تلك الأعمال قد يضر بحقوقه أو مصالحه القانونية.
المصلحة في هذه الدعوى تتعلق في الغالب بالضرر الذي قد يلحق بالمدعي إذا استمرت الأعمال الجديدة، سواء كان الضرر متعلقًا بالملكية أو بالحقوق الشخصية أو أي نوع من الأنشطة التي قد تؤثر سلبًا على الوضع القانوني للمدعي. على سبيل المثال، إذا قام شخص ببناء أو تنفيذ أعمال قد تضر بممتلكات الجار أو تتسبب في إحداث تعدي على ملكيته، يمكن للمتضرر رفع دعوى لوقف هذه الأعمال حتى يبت القضاء في الأمر.
تعتبر المصلحة شرطًا جوهريًا لأن المحكمة لن تقبل الدعوى إذا لم يتوافر للمدعي مصلحة قانونية حقيقية من وقف تلك الأعمال، بل لا بد من أن يكون المدعي في وضع يعرضه ضرر مباشر من استمرار الأعمال المدعى بوقفها.
المصلحة في دعاوى المطالبة بالإلتزامات المستقبلة :
في قانون المرافعات المصري، تعتبر المصلحة من الشروط الأساسية لقبول دعاوى المطالبة بالالتزامات المستقبلية. وهذه الدعاوى تتعلق بالمطالبة بحقوق أو التزامات قد تكون مستحقة في المستقبل ولكنها لم تتحقق بعد. ولرفع مثل هذه الدعاوى، يتعين أن يكون للمدعي مصلحة قانونية حقيقية ومباشرة في المطالبة بتلك الالتزامات المستقبلية.
المصلحة في دعاوى المطالبة بالالتزامات المستقبلية تكون قائمة على أساس أن المدعي يواجه ضررًا أو موقفًا قانونيًا يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية لحمايته مسبقًا قبل حدوث الالتزام أو استحقاق الحق في المستقبل. على سبيل المثال، قد تكون هناك دعوى للمطالبة بتعويضات مستقبلية بسبب حادث وقع للمدعي وأدى إلى إصابات قد تستلزم علاجًا مستمرًا أو تعويضًا لفترة طويلة بعد وقوع الحادث. في مثل هذه الحالات، يكون المدعي في حاجة إلى الحماية القانونية لمستقبل حقوقه.
ومع ذلك، يشترط أن تكون المطالبة بالالتزامات المستقبلية متوافقة مع معايير قانونية واضحة، بحيث يكون الضرر المتوقع محققًا بدرجة معقولة، ويجب أن يكون واضحًا أن المدعي لن يتمكن من تحصيل حقوقه في المستقبل إلا من خلال حكم قضائي يقضي بتلك الالتزامات. إذا لم تتوافر المصلحة الحقيقية والشرعية، فإن المحكمة ترفض الدعوى بناءً على عدم وجود المصلحة القانونية في المطالبة بتلك الالتزامات.
المصلحة في الدعوى الإستفهامية :
الدعوى الاستفهامية هي الدعوى التي يرفعها الشخص أمام المحكمة للاستفسار عن موقف قانوني أو لتحديد حالة قانونية معينة، حيث لا يكون الهدف منها المطالبة بحق معين أو تعويض، بل يكون الغرض من رفع الدعوى هو الحصول على إيضاح قانوني أو استبيان حالة قانونية تهم المدعي.
يشترط في الدعوى الاستفهامية أن تكون المصلحة قائمة وحقيقية، ويجب أن يكون المدعي قد تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالحالة القانونية التي يسعى للاستفهام عنها. بمعنى أنه لا يجوز لأحد رفع دعوى استفسار لمجرد الفضول أو دون أن يكون له تأثير قانوني من الحصول على الإجابة. فالمصلحة في هذه الحالة هي مصلحة قانونية أو شخصية تكون مرتبطة بشكل وثيق بالمدعي، ويجب أن يكون الاستفسار له أثر مباشر على حقوقه أو على الوضع القانوني الذي يواجهه.
على سبيل المثال، قد يرفع شخص دعوى استفسار في حال كان لديه شك في مدى قانونية إجراء معين أو في تفسير نصوص قانونية قد تؤثر عليه في المستقبل، مثل سؤال عن مدى صحة عقد أو مدى قانونية تصرف معين من جهة إدارية أو حكومية. في مثل هذه الحالات، يُشترط أن يكون للمدعي مصلحة قانونية واضحة في الحصول على الإجابة الصحيحة من المحكمة، لتجنب وقوعه في ضرر أو للمساعدة في اتخاذ قرارات قانونية سليمة.
بالتالي، الدعوى الاستفهامية تظل محكومة بضرورة وجود مصلحة قانونية مرتبطة بالمدعي، حيث لا تقبل الدعوى في حال كانت المصلحة غير قائمة أو غير ملموسة.
المصلجة في دعاوى النحقيق المتعلقة بمنازعات مستقبلة :
في قانون المرافعات المصري، تعتبر المصلحة من الشروط الأساسية لقبول دعاوى التحقيق المتعلقة بمنازعات مستقبلية. وتتمثل هذه الدعاوى في الحالات التي يطلب فيها المدعي من المحكمة اتخاذ إجراء قانوني للتحقيق في مسألة قد تكون محلاً للنزاع في المستقبل، ولكن لم يحدث النزاع بشكل فعلي بعد. ويشترط لقبول هذه الدعاوى أن تكون هناك مصلحة حقيقية للمدعي في التحقيق في المسألة المعنية، بحيث يترتب على اتخاذ إجراء التحقيق حماية حقوق المدعي من ضرر مستقبلي.
المصلحة في هذا النوع من الدعاوى يجب أن تكون قائمة على احتمال حدوث نزاع في المستقبل يشمل حقوق المدعي، مما يستدعي منه اتخاذ إجراءات قانونية مسبقة لتوثيق أو التحقيق في مسألة معينة لضمان حقوقه عند حدوث النزاع. على سبيل المثال، قد يتقدم المدعي بدعوى للتحقيق في أمر ما يتعلق بعقد مستقبلي أو اتفاق لم يتم تنفيذه بعد، ولكن من المتوقع أن يكون محل نزاع بين الأطراف في المستقبل.
لذا، يشترط في هذه الدعاوى أن تكون المصلحة حقيقية ومباشرة، بحيث تكون هناك ضرورة قانونية للتحقيق في المسألة التي قد تؤثر على حقوق المدعي في المستقبل. إذا لم يتوافر هذا الشرط، فإن المحكمة قد ترفض الدعوى، باعتبار أن التحقيق في مسألة مستقبلية دون وجود مصلحة حقيقية يعد غير مبرر قانونياً.
المصلحة في دعوى إثبات الحالة :
دعوى إثبات الحالة هي الدعوى التي يتم رفعها أمام المحكمة بهدف توثيق حالة معينة أو موقف قانوني في وقت محدد، وذلك لإثبات واقع أو ظروف قد تكون موضع نزاع في المستقبل أو قد تؤثر في سير القضايا الأخرى. وتتمثل المصلحة في هذه الدعوى في الحاجة إلى ضمان الحفاظ على الأدلة أو توثيق الواقع بشكل قانوني لتفادي أي نزاع حول حقيقة الوضع في وقت لاحق.
يشترط في دعوى إثبات الحالة أن تكون المصلحة قائمة وحقيقية، حيث يجب أن يكون المدعي بحاجة إلى إثبات حالته أو الحالة التي يُستهدف إثباتها من خلال الدعوى. على سبيل المثال، قد يرفع شخص دعوى إثبات حالة إذا كان يخشى من تغيير الظروف التي تدعم موقفه القانوني في المستقبل، مثل توثيق حالة عقارية قبل إجراء أي تعديلات عليها، أو إثبات حالة صحية معينة قبل أن تطرأ تغييرات قد تؤثر على حقوقه القانونية.
المصلحة في دعوى إثبات الحالة ترتبط غالبًا بالحفاظ على حقوق المدعي في مواجهة ضرر قد يطرأ إذا لم يتم توثيق الوضع في الوقت المناسب. كذلك، يمكن أن يكون للمدعي مصلحة قانونية في تقديم الأدلة أمام المحكمة لحماية نفسه من أي محاولات لتغيير أو التلاعب بالواقع، مما يضمن له الاستفادة من الإجراءات القانونية في حال حدوث نزاع مستقبلي.
بناءً عليه، يجب أن تكون المصلحة في دعوى إثبات الحالة قائمة ومباشرة، بحيث تكون هناك حاجة حقيقية لتوثيق الوضع أو الحماية من التغيير الذي قد يؤثر على الحقوق أو المراكز القانونية للأطراف المعنية.
المصلحة في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية :
في قانون المرافعات المصري، تُعد المصلحة من الشروط الأساسية لقبول دعوى تحقيق الخطوط الأصلية. وتتمثل هذه الدعوى في طلب من المدعي للتأكد من صحة الخطوط الأصلية للمستندات التي قد تكون جزءًا من النزاع القضائي، بهدف إثبات صحتها أو نقضها. ويشترط لقبول دعوى تحقيق الخطوط الأصلية أن يكون للمدعي مصلحة حقيقية ومباشرة في إجراء التحقيق، حيث لا يجوز له رفع هذه الدعوى إلا إذا كانت صحة المستندات المعنية تؤثر بشكل جوهري على حقوقه في القضية.
المصلحة في هذه الدعوى تقوم على أن المستندات أو الخطوط محل التحقيق هي أساس النزاع بين الأطراف، وبالتالي فإن التأكد من صحتها أو تزويرها قد يكون له تأثير كبير على مجريات الدعوى ونتيجتها. على سبيل المثال، إذا كان النزاع يتعلق بعقد أو توكيل أو أي مستند آخر يمكن أن يشكل أساسًا لدعوى قضائية، فيجب على المدعي إثبات صحة الخطوط الأصلية لهذا المستند ليتمكن من الاستفادة منه قانونيًا في الدعوى.
إذا لم تكن هناك مصلحة حقيقية للمدعي في تحقيق الخطوط الأصلية، مثل إذا كانت الوثائق لا تشكل عنصرًا محوريًا في النزاع، فإن المحكمة قد ترفض الدعوى. كما يتعين على المدعي أن يثبت بشكل واضح أن تحقيق الخطوط الأصلية هو وسيلته الوحيدة أو الأكثر فعالية لضمان حقوقه في القضية المعروضة.
المصلحة في دعوى التزوير الأصلية :
في قانون المرافعات المصري، تُعد المصلحة شرطًا أساسيًا لقبول دعوى التزوير الأصلية، التي تهدف إلى الطعن في صحة مستند معين وادعاء أنه مزور. وتكون هذه الدعوى عادةً مرفوعة من الشخص الذي يدعي أن المستند الذي يستند إليه الطرف الآخر في القضية مزور، وبالتالي يطلب من المحكمة تحقيق التزوير لإثبات عدم صحة المستند.
المصلحة في دعوى التزوير الأصلية تتعلق بالحق الذي يخص المدعي، حيث لا يجوز له رفع الدعوى إلا إذا كانت صحة المستند المزور تؤثر مباشرة على حقوقه أو مواقفه القانونية في القضية. على سبيل المثال، إذا كان أحد الأطراف في النزاع يقدم مستندًا مزورًا للإثبات على صحة دعواه، وكانت هذه المستندات هي أساس دعوى المدعى عليه ضد المدعي، فإن المدعي يكون له مصلحة واضحة في رفع دعوى التزوير لإثبات عدم صحة هذه المستندات.
يجب أن تكون المصلحة قائمة على أساس ضرر محتمل أو حالي سيترتب على قبول المستند المزور في النزاع، وبالتالي يؤثر ذلك على نتائج القضية. إذا لم تكن هناك مصلحة حقيقية في الطعن في المستند أو إذا لم يكن لهذا الطعن تأثير جوهري على حقوق المدعي، فإن المحكمة ترفض الدعوى. وعليه، لا يُقبل رفع دعوى التزوير الأصلية إلا عندما تكون المصلحة واضحة ومباشرة لضمان حماية حقوق الأطراف من التلاعب والتزوير في المستندات.
لا خلط بين المصلحة و الحق الذي تحميه الدعوى :
في قانون المرافعات، يُعد كل من المصلحة والحق من العناصر الأساسية التي تساهم في قبول الدعوى، لكن يجب التفرقة بينهما بشكل دقيق. المصلحة هي الفائدة القانونية التي يسعى المدعي لتحقيقها من الدعوى، وهي شرط لقبول الدعوى أمام المحكمة. بينما الحق هو المطالبة التي يسعى المدعي للحصول عليها أو حماية موقفه القانوني بشأنها، مثل الحق في التعويض أو الحق في استرداد ملكية.
المصلحة لا تقتصر فقط على حماية حق معين، بل يمكن أن تتعلق أيضًا بحماية موقف قانوني أو فائدة مهنية أو اجتماعية قد يحققها المدعي من نتيجة الدعوى. وبالتالي، المصلحة قد تكون أوسع من مجرد الحق الملموس، فهي تشمل أيضًا مصالح معنوية أو غير مباشرة تتأثر بالنتيجة القانونية المتوقعة من الدعوى.
أما الحق، فهو المصلحة التي يُعترف بها قانونيًا كحق شخصي أو ملكية، وله سند قانوني يُمكن المطالبة به أمام المحكمة. المصلحة قد تكون شرطًا لقبول الدعوى، ولكنها لا تضمن بالضرورة أن المدعي يملك حقًا قانونيًا في الموضوع. في حين أن الحق يجب أن يكون قائمًا وقابلًا للمطالبة به أمام المحكمة، وبالتالي فهو الركيزة الأساسية التي تحميها الدعوى.
على سبيل المثال، قد يكون شخص ما لديه مصلحة في رفع دعوى لوقف تصرفات غير قانونية تمس حقوقه الشخصية، ولكن لكي تُقبل الدعوى، يجب أن يكون له حق قانوني يبرر المطالبة أمام المحكمة، كحقه في حماية ملكيته أو حقوقه الشخصية.
بذلك، لا يجب الخلط بين المصلحة والحق، فالمصلحة قد تدفع الشخص لرفع الدعوى، بينما الحق هو ما يسعى الشخص للحصول عليه أو حمايته من خلال هذه الدعوى.
مدى إشتراط إستمرار توافر المصلحة من رفع الدعوى إلى حين الفصل فيها وفقا للمادة 3 المعدلة بالقانون 81 لسنة 1996 :
وفقًا للمادة الثالثة المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 في قانون المرافعات المصري، يُشترط استمرار توافر المصلحة من رفع الدعوى وحتى الفصل فيها. وهذا يعني أن المدعي يجب أن يظل لديه مصلحة قانونية حقيقية ومباشرة في القضية طوال فترة سير الدعوى أمام المحكمة، حتى يصدر الحكم فيها.
إذا انعدمت المصلحة أثناء نظر الدعوى، سواء بسبب تغير الظروف أو استحالة تحقيق الهدف من الدعوى، يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى. هذا الاشتراط يهدف إلى حماية النظام القضائي من الدعاوى التي لا تمثل نزاعًا حقيقيًا أو لا تتطلب تدخلاً قضائيًا، مما يسهم في تخفيف العبء على المحاكم وضمان استخدام النظام القضائي بشكل فعال.
على سبيل المثال، إذا كانت الدعوى قد رفعت للمطالبة بحل نزاع ما بين طرفين بشأن عقد معين، ولكن تم تسوية هذا النزاع أو أصبح من غير الممكن تطبيق الحكم فيه بسبب تغير الظروف، فإن المحكمة قد تقرر عدم الاستمرار في نظر الدعوى لعدم توافر المصلحة القانونية من استمرارها. وبذلك، تؤكد المادة على ضرورة أن تكون هناك مصلحة قانونية قائمة طوال مدة سير الدعوى، وأنه لا يمكن للمحكمة المضي في نظر الدعاوى التي لا تتوافر فيها هذه المصلحة.
توافر المصلحة عند رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها والإتجاه الحديث لقضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا :
في قانون المرافعات المصري، يشترط استمرار توافر المصلحة من لحظة رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996. ويعني ذلك أنه لا يجوز رفع الدعوى إلا إذا كان للمدعي مصلحة حقيقية وقائمة في القضية، ويجب أن تظل هذه المصلحة قائمة طوال فترة نظر الدعوى وحتى الفصل فيها من قبل المحكمة.
قبل صدور هذا القانون، كان هناك اتجاه حديث في قضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا يشدد على ضرورة استمرار توافر المصلحة طوال فترة سير الدعوى، خاصة في الحالات التي قد تنقضي فيها المصلحة أو يتغير الموقف القانوني للطرف المدعي أثناء فترة التقاضي. هذا الاتجاه كان يهدف إلى ضمان أن تكون الدعوى قائمة على نزاع حقيقي وواقعي بين الأطراف، وذلك لتفادي الدعاوى التي قد لا تؤدي إلى نتيجة عملية أو قانونية.
وكان هذا الموقف يعكس ضرورة وجود مصلحة حقيقية ومستمرة لحين صدور الحكم، حتى لا تُستهلك موارد القضاء في قضايا لا تكون لها أي تأثير على الوضع القانوني للأطراف المعنية. وعلى ذلك، فإن محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا كانت تشترط أن تظل المصلحة قائمة حتى الفصل النهائي في الدعوى، مما يعكس الحرص على ضمان جدية القضايا التي ترفع أمام القضاء.
مدى تعلق شرط المصلحة و شرط الصفة بالنظام العام وفقا للمادة 3 معدلة بالقانون 81 لسنة 1996 :
وفقًا للمادة 3 المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 في قانون المرافعات المصري، شرطا المصلحة والصفة يُعتبران من الشروط المتعلقة بـ النظام العام. وهذا يعني أنه لا يجوز للمحكمة تجاهل هذين الشرطين أو التنازل عنهما، حتى إذا لم يثرهما أحد أطراف الدعوى. ويجب على المحكمة أن تتحقق من توافر هذين الشرطين بشكل تلقائي خلال سير الدعوى، حيث يتعين أن يكون المدعي قد توافرت له مصلحة قانونية مباشرة في الدعوى، وألا يكون قد رفعها بالنيابة عن شخص آخر ليس له صفة في القضية.
المصلحة تعني أن المدعي يجب أن يكون له حق قانوني أو مصلحة مشروعة في القضية التي يرفعها، وألا تكون الدعوى مجرد نزاع قانوني لا يترتب عليه أي تأثير قانوني على المدعي. أما الصفة فهي تعني أن الشخص الذي يرفع الدعوى يجب أن يكون هو صاحب الحق أو المصلحة في النزاع المعروض على المحكمة.
إذا تبين للمحكمة أن الدعوى تفتقر إلى أحد هذين الشرطين، فإنها ترفض الدعوى من تلقاء نفسها، حيث يُعد عدم توافر المصلحة أو الصفة عائقًا قانونيًا يمنع من نظر القضية. ولذلك، فإن توافر هذين الشرطين يعد أمرًا جوهريًا للحفاظ على سير العدالة وضمان الفصل في النزاعات الحقيقية والمشروعة التي تؤثر على حقوق الأطراف.
إضافة إلى ذلك، يُعد تمسك المصلحة والصفة بالنظام العام ضمانًا لعدم إضاعة الوقت والجهد في النظر في قضايا لا تستند إلى مبررات قانونية واضحة، مما يساهم في تقليل الدعاوى الكيدية التي قد تضر بفاعلية القضاء.
شرط الصفة في الدعوى في قانون المرافعات :
شرط الصفة في الدعوى هو أحد الشروط الأساسية لقبول الدعوى أمام المحكمة، ويقصد به أن يكون المدعي هو الشخص الذي يملك الحق أو المصلحة القانونية في المطالبة بالحق الذي ترفع الدعوى بشأنه. بمعنى آخر، يجب أن يكون المدعي شخصًا ذا صفة قانونية تمكنه من رفع الدعوى، أي أن يكون له علاقة مباشرة بالموضوع المطروح أمام المحكمة وأن يتأثر بالحكم في القضية بشكل مباشر.
إذا كانت الدعوى تتعلق بحق شخصي أو مصلحة قانونية معينة، يجب على المدعي أن يثبت أن له الصفة القانونية للتقاضي. فمثلًا، في دعوى ملكية عقار، يجب أن يكون المدعي هو صاحب العقار أو من له حق قانوني في المطالبة به. إذا كان المدعي لا يمتلك هذه الصفة، فإن المحكمة سترفض الدعوى لعدم استيفاء هذا الشرط.
ومن الحالات التي تتعلق بشرط الصفة في الدعوى، نجد أن هناك بعض الحالات التي قد يسمح فيها القانون لغير صاحب الحق الأصلي برفع الدعوى، مثل حالة الوكيل الذي يرفع الدعوى نيابة عن موكله بناءً على توكيل قانوني، أو حالة الوصي الذي يرفع دعوى لمصلحة القاصر.
إذن، شرط الصفة يهدف إلى ضمان أن الأشخاص الذين يرفعون الدعاوى لديهم مصلحة حقيقية وقانونية في القضية المطروحة أمام المحكمة، ما يساهم في ضمان سير العدالة بشكل سليم ومنظم.
الصفة شرط لقبول الطلب أو الدفع :
في قانون المرافعات المصري، تُعتبر الصفة شرطًا أساسيًا لقبول الطلب أو الدفع المقدم من أحد أطراف الدعوى. الصفة تعني أن الشخص الذي يقدم الطلب أو الدفع أمام المحكمة يجب أن يكون له الحق أو المصلحة القانونية في الموضوع المعروض، أي أن يكون صاحب الحق أو المصلحة التي يتناولها الطلب أو الدفع.
على سبيل المثال، إذا كان هناك نزاع يتعلق بملكية عقار، يجب أن يكون الشخص الذي يرفع الدعوى هو المالك الفعلي للعقار أو من له صفة قانونية في التقدم بهذا الطلب. إذا كان الشخص لا يمتلك الصفة القانونية المتعلقة بالحق الذي يطالبه أو الدفع الذي يقدم به، فإن المحكمة ترفض طلبه أو دفعه لعدم توافر الصفة اللازمة.
الصفة تعد من الشروط الجوهرية التي يتحقق منها القاضي قبل النظر في موضوع الدعوى أو الطلب أو الدفع، بحيث إذا تبين للمحكمة أن الشخص الذي رفع الدعوى أو قدم الدفع لا يملك الصفة القانونية في ذلك، فإن الدعوى أو الدفع يُعتبر غير مقبول قانونًا. بذلك، يهدف هذا الشرط إلى ضمان أن يكون أطراف الدعوى أصحاب حقوق ومصالح قانونية حقيقية، وذلك لتحقيق العدالة وتجنب التدخل في مسائل لا تخص الأطراف المعنية.
من هنا، يُعتبر شرط الصفة أحد الضمانات المهمة لتحقيق العدالة، حيث يحافظ على توافر الجدية في الدعاوى والطلبات ويمنع القضايا التي لا ترتبط بحقوق أو مصالح مباشرة للأطراف.
جواز الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط ألا يستلزم الفصل فيها بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع :
في قانون المرافعات المصري، يُجَوَّز الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض، بشرط ألا يستلزم الفصل في هذا الدفع بحث عناصر واقعية أو وقائع جديدة لم تكن قد طرحت أمام محكمة الموضوع. هذا يعني أنه يمكن للمدعى عليه أن يثير هذا الدفع أمام محكمة النقض، حتى وإن لم يكن قد تم طرحه أمام محكمة الموضوع (المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية) في المراحل السابقة من الدعوى، وذلك في حال اكتشاف انتفاء الصفة القانونية للمدعي.
ومع ذلك، يشترط ألا يتطلب قبول هذا الدفع من محكمة النقض إجراء تحقيقات جديدة أو بحث عناصر واقعية كانت غائبة عن محكمة الموضوع. بمعنى آخر، يجب أن يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة قائمًا على أساس قانوني واضح لا يعتمد على الوقائع التي لم تكن محل نظر في المحكمة الأولى. هذا يسمح لمحكمة النقض بالنظر في هذا الدفع دون الحاجة إلى التطرق إلى الأدلة أو الوقائع التي لم يتم عرضها مسبقًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية.
بذلك، يمكن لمحكمة النقض أن ترفض الدعوى إذا تبين لها أن المدعي يفتقر إلى الصفة اللازمة لرفعها، وذلك دون أن تضطر إلى العودة إلى العناصر الواقعية أو الأدلة التي لم تكن أمام محكمة الموضوع، مما يعزز من فاعلية النظام القضائي ويسهم في تيسير الفصل في القضايا بوقت أقصر.
رفع الدعوى من غير صاحب الصفة أو على من ليس له صفة فيها يترتب عليه انعدام الخصومة في قانون المرافعات :
في قانون المرافعات، يشترط لقبول الدعوى أن يكون المدعي صاحب الصفة القانونية في القضية التي يرفعها. إذا رفع شخص دعوى وهو لا يمتلك الصفة القانونية للتقاضي أو رفعها ضد شخص لا يمتلك الصفة القانونية للدفاع، فإن ذلك يترتب عليه انعدام الخصومة. بمعنى أن الدعوى تعتبر غير قائمة من الناحية القانونية، حيث يُعد رفع الدعوى في هذه الحالة إجراءً باطلاً.
الصفة القانونية تعني أن المدعي يجب أن يكون له مصلحة قانونية أو حق مرتبط بالموضوع الذي يرفع الدعوى بشأنه. كما يجب أن يكون المدعى عليه أيضًا له صفة قانونية بحيث يكون هو الشخص المسؤول عن الدفاع أو الذي يمكن أن يتأثر بالحكم في الدعوى. إذا كانت الدعوى مرفوعة من شخص لا يمتلك هذه الصفة، أو إذا كانت مرفوعة ضد شخص ليس له صفة في النزاع، فإن المحكمة لا تقبل النظر فيها، وتُعتبر الخصومة منعدمة قانونًا.
على سبيل المثال، إذا رفع شخص دعوى تطالب بحق ليس له علاقة به أو لا يتأثر به، أو إذا كان يرفع الدعوى ضد شخص ليس له علاقة مباشرة بالمسألة القانونية المطروحة، فإن الدعوى تكون فاقدة للشرعية القانونية من البداية. يؤدي ذلك إلى عدم وجود خصومة حقيقية بين الأطراف، ما يعني أن الإجراءات التي تتم في الدعوى تكون معدومة ولا تُعد فاعلة.
من ثم، انعدام الخصومة يعد نتيجة مباشرة لرفع الدعوى من غير صاحب الصفة أو ضد من ليس له صفة قانونية، مما يؤكد أهمية توافر هذه الصفة لضمان سير العدالة بشكل صحيح.
أثر إنتقاء الصفة هو إنعدام الخصومة :
في قانون المرافعات المصري، يُعتبر انتقاء الصفة من الأسباب التي تؤدي إلى انعدام الخصومة. الصفة تعني أن الشخص الذي يرفع الدعوى يجب أن يكون له مصلحة قانونية حقيقية في الموضوع المطروح، أي أن يكون هو صاحب الحق أو المصلحة في النزاع المعروض أمام المحكمة. إذا تبين للمحكمة أن المدعي لا يملك الصفة اللازمة لرفع الدعوى، فإن هذا يؤدي إلى انعدام الخصومة، بمعنى أنه لا يُمكن النظر في الدعوى أو الاستماع إليها، لأنها تكون قد رفعت من شخص ليس له الحق القانوني في إقامة هذه الدعوى.
أثر انتقاء الصفة في الدعوى هو إهدار جميع إجراءات التقاضي التي تمت في القضية، باعتبار أن الدعوى لم تكن قائمة على نزاع قانوني حقيقي بين الأطراف المعنية. وبالتالي، يعتبر الحكم الذي يصدر في دعوى تفتقر إلى الصفة حكمًا منعدمًا، لأن الدعوى لم تكن مشروعة منذ البداية.
على سبيل المثال، إذا رفع شخص دعوى باسم آخر أو بدون أن يكون له الحق القانوني في رفع الدعوى، فإن المحكمة تكتشف انتفاء الصفة وتُقرر انعدام الخصومة، مما يؤدي إلى رفض الدعوى أو ردها، ويترتب على ذلك أن جميع الإجراءات التي تمت في الدعوى تصبح غير قانونية، ويُعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل رفع الدعوى.
التفرقة بين الصفة وسلطة الوكيل في الحضور عند الخصم :
في قانون المرافعات، يوجد تفرقة واضحة بين الصفة و سلطة الوكيل في الحضور عند الخصم، حيث يتعلق كل منهما بمفهوم مختلف يرتبط بالحقوق والإجراءات القانونية في الدعوى.
الصفة تعني أن المدعي أو المدعى عليه يجب أن يكون له علاقة قانونية مباشرة بالموضوع المطروح أمام المحكمة. بمعنى أن الشخص الذي يرفع الدعوى يجب أن يكون له مصلحة قانونية في القضية، أو أن الشخص الذي ترفع ضده الدعوى يجب أن يكون هو الشخص الذي يتحمل المسؤولية القانونية أو يتأثر بالحكم. إذا كانت الدعوى مرفوعة من شخص ليس له صفة قانونية في الموضوع، أو ضد شخص لا يمتلك صفة قانونية، فإن الدعوى تكون غير مقبولة قانونًا.
أما سلطة الوكيل في الحضور عند الخصم، فهي تتعلق بالوكالة القانونية الممنوحة من طرف أحد الأطراف لشخص آخر ليقوم بالنيابة عنه في حضور الجلسات أو إجراء الإجراءات القانونية في الدعوى. الوكيل قد يكون محاميًا أو أي شخص آخر، ويجب أن يكون مُفوضًا بموجب توكيل رسمي. سلطة الوكيل تعني أنه يحق له الترافع أمام المحكمة نيابة عن موكله، ولكن الوكيل لا يكتسب الصفة القانونية في الدعوى، بل يعمل بناءً على التوكيل الذي يمنحه له الموكل. فإذا كان الوكيل مخولًا بالحضور في الدعوى، فإنه يتصرف نيابة عن الموكل في إجراءات القضية، ولكن ليس له صفة قانونية مستقلة تتعلق بالحق أو المصلحة في القضية.
إذن، الصفة تتعلق بوجود مصلحة قانونية للأطراف في الدعوى، بينما سلطة الوكيل تتعلق بتفويض الأفراد للآخرين لتمثيلهم أمام المحكمة في الخصومة، ولا تعني أن الوكيل يمتلك الحق أو المصلحة في الدعوى نفسها.
لا يجوز اختصام الوكيل في الأعمال التي وكل فيها اللهم إلا إذا كان الوكيل مفوضا في إجراء التصرف القانوني :
من المقرر وفقا لنص المادة ٦۹۹ من القانون المدنى أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما هي الحساب الأصيل فإذا باشر إجراء معينا ، سواء كان من أعمال الإدارة أو التصرف، فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للموكل ، اللهم إلا إذا كان الوكيل .مفوضا في إجراء هذا التصرف .
جواز إختصام القاصر المأذون له بالإدارة فيما يتعلق بأعمال الإدارة التي أذن له بها :
في قانون المرافعات، يُعتبر القاصر شخصًا غير قادر على ممارسة جميع حقوقه القانونية بشكل مستقل بسبب صغر سنه، لذا يتم تعيين الولي أو الوصي للقيام بالإدارة نيابة عنه. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يتم إذن للقاصر بإدارة بعض أموره المالية أو الحقوقية بشكل مستقل جزئيًا، وذلك في نطاق معين ووفقًا لما يقره القاضي.
ويجوز في هذه الحالات اختصام القاصر المأذون له بالإدارة في الدعاوى المتعلقة بالأعمال التي أُذن له بالقيام بها، أي تلك التي تدخل ضمن صلاحياته المحددة بالإدارة. على سبيل المثال، إذا تم السماح للقاصر بإدارة جزء من ممتلكاته أو التصرف في أمواله لأغراض محددة، فإنه يمكن اختصامه في الدعوى التي تتعلق بتلك الأعمال، لأن القاصر قد يكون هو الطرف الذي يتأثر بالقرار القضائي في هذه الحالات.
لكن يجب أن يكون هذا الاختصام في نطاق ما أُذن له به فقط، ولا يجوز اختصامه في أمور تتجاوز صلاحياته أو التفويضات التي حصل عليها من المحكمة. ذلك لأن القاصر المأذون له بالإدارة لا يتمتع بكامل الأهلية القانونية لإدارة جميع شؤونه، ولهذا فإن اختصاصه يجب أن يقتصر على الأمور التي أُذن له بها قانونًا.
إذن، يجوز اختصام القاصر المأذون له بالإدارة في الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرح له بها، بما يضمن حماية حقوقه في إطار التفويض المحدد من قبل المحكمة.
إختصام الشريك على الشيوع الذي يتولى إدارة المال الشائع في أعمال الإدارة الخاصة بهذا المال :
في قانون المرافعات المصري، يُجَوَّز اختصام الشريك على الشيوع الذي يتولى إدارة المال الشائع في الأعمال الخاصة بالإدارة القانونية لهذا المال، ويعتبر هذا الأمر جزءًا من التنظيم القانوني المتعلق بالأموال المشتركة بين عدة شركاء. ففي حالة وجود مال مشاع (مملوك بالتساوي بين عدد من الأشخاص)، إذا تولى أحد الشركاء إدارة هذا المال المشاع، فإن الآخرين من الشركاء الذين لم يشاركوا في إدارة المال، يمكنهم اختصامه قانونًا إذا قام بإجراء معين يتعلق بإدارة هذا المال يؤثر على حقوقهم أو يتجاوز صلاحياته.
يعتبر اختصام الشريك الذي يدير المال الشائع ضرورة في حالة حدوث نزاع بين الشركاء بشأن تصرفات أو قرارات تتعلق بإدارة المال المشاع، حيث يمكن لأحد الشركاء المطالبة بإيقاف تلك التصرفات أو بتغيير طريقة إدارة المال المشاع إذا كانت تضر بحقوقه أو لا تتماشى مع مصلحته. ويشمل ذلك التصرفات التي قد تضر بالمال الشائع أو التي يتم اتخاذها دون موافقة بقية الشركاء.
وبالتالي، يسمح القانون للشركاء الذين ليس لهم دور في إدارة المال المشاع بأن يتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحهم إذا كانوا يعتقدون أن تصرفات الشريك الذي يدير المال قد أضرت بحقوقهم أو لم تكن في إطار الإدارة القانونية السليمة لهذا المال المشاع.
شرط الصفة في حالة تعدد الأطراف :
في حالة تعدد الأطراف في الدعوى، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، يظل شرط الصفة من الشروط الأساسية لقبول الدعوى في قانون المرافعات. يشترط أن يكون لكل طرف من الأطراف في الدعوى الصفة القانونية التي تجعله مستحقًا للقيام بالإجراءات أو الدفاع أمام المحكمة.
عند تعدد الأطراف، سواء كانت الدعوى تتعلق بعدد من المدعين أو المدعى عليهم، يجب أن يكون لكل طرف في الدعوى مصلحة قانونية مباشرة في القضية والصفة القانونية التي تؤهله للمطالبة بالحق أو الدفاع عنه. فإذا كان أحد الأطراف لا يمتلك الصفة القانونية المناسبة، سواء كان ذلك في الجانب المدعي أو المدعى عليه، فإن المحكمة قد تقرر عدم قبول الدعوى بالنسبة لذلك الطرف، مما يؤدي إلى انعدام الخصومة بالنسبة له.
على سبيل المثال، في دعوى يرفعها مجموعة من الأفراد، يجب على كل مدعي أن يكون له مصلحة قانونية تتعلق بالقضية المطروحة أمام المحكمة، وكذلك يجب على كل مدعى عليه أن يكون هو الشخص الذي يتحمل المسؤولية أو يتأثر بالحكم. إذا كانت الدعوى تتعلق بحق أو مصلحة تخص شخصًا معينًا فقط، فإن المحكمة قد تقضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للأطراف الذين لا يملكون الصفة القانونية في القضية.
إذن، في حالة تعدد الأطراف، تظل الصفة شرطًا جوهريًا لقبول الدعوى بالنسبة لكل طرف من الأطراف، ويجب أن يتوافر لكل منهم المصلحة القانونية التي تبرر تدخلهم في الدعوى سواء كمدعين أو مدعى عليهم.
تمثيل الوارث لباقي الورثة :
في قانون المرافعات المصري، تمثيل الوارث لبقية الورثة في الدعاوى المتعلقة بميراثهم يعد من المسائل المهمة التي يحددها القانون في إطار تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمواريث. إذ يُسمح للوارث، في بعض الحالات، بتمثيل باقي الورثة في الدعوى إذا كان هذا التمثيل يتعلق بحقوق مشتركة بين الجميع، مثل المطالبة بحقوق مالية أو تصفية التركة، بشرط أن يكون هذا التمثيل يتم في إطار مصلحة الجميع ولا يُلحق ضررًا ببقية الورثة.
وفي حال رفع أحد الورثة دعوى تتعلق بالتركة أو بإحدى مسائل الميراث، يمكن له تمثيل باقي الورثة في الدعوى إذا كان يشترك معهم في نفس المصلحة القانونية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعلام باقي الورثة بالدعوى، لضمان حقوقهم وحمايتها. أما إذا اختلفت مصلحة الوارث الذي يتولى تمثيلهم عن مصالح الآخرين، فلا يجوز له تمثيلهم في هذه الدعوى إلا إذا حصل على توكيل رسمي من باقي الورثة أو كانوا قد اتفقوا على تمثيله.
وهذا التمثيل يتم على أساس أن الورثة يشتركون في حقوق مالية أو قانونية، وإذا كانت الدعوى تتعلق بمصلحة فردية لأحد الورثة فقط، فإنه لا يجوز له تمثيل باقي الورثة إلا بعد الحصول على موافقتهم أو تفويضهم.
تحقق الصفة بعد رفع الدعوى أو زوالها بعدئذ :
في قانون المرافعات، يشترط لقبول الدعوى أن يتوافر للمدعي الصفة القانونية في القضية، أي أن يكون له مصلحة قانونية في المطالبة بالحق أو الدفاع عنه. لكن قد يحدث في بعض الحالات أن تحقق الصفة بعد رفع الدعوى، أو أن تزال الصفة بعد رفع الدعوى. في كلتا الحالتين، يؤثر ذلك على سير الدعوى وقبولها.
إذا تحققت الصفة بعد رفع الدعوى، كأن يظهر أن المدعي كان يفتقر إليها في البداية لكنه أثبتها بعد رفع الدعوى، فإن المحكمة قد تقبل الدعوى وتستمر في نظرها بناءً على التحقق اللاحق للصفة. وهذا يعني أن الدعوى يمكن أن تُقبل إذا ثبت أن المدعي أصبح له مصلحة قانونية في القضية بعد رفعها، سواء كان ذلك بسبب تغير الوضع أو حصوله على توكيل قانوني أو إثبات حقوقه بطريقة أخرى.
أما إذا زالت الصفة بعد رفع الدعوى، فإن ذلك قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى أو وقف سيرها، خاصة إذا أصبح المدعي أو المدعى عليه غير صاحب مصلحة قانونية في القضية. على سبيل المثال، إذا كان المدعي قد فقد حقه أو مصلحته في الدعوى بسبب حدوث تغييرات قانونية أو واقعية، فإن المحكمة قد تقرر عدم النظر في الدعوى أو اعتبارها غير قائمة.
بالتالي، من المهم أن تكون الصفة القانونية مستمرة طوال سير الدعوى. إذا تغيرت هذه الصفة في أي وقت أثناء الإجراءات، فإن ذلك قد يؤدي إلى توقف الدعوى أو رفضها، بما يضمن احترام شروط قبول الدعوى واستمرار العدالة.
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة أمام محكمة أول درجة وموقف محكمة الإستئناف بعدئذ :
في قانون المرافعات المصري، يُعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة من الدفوع التي يمكن أن تثار أمام محكمة أول درجة (المحكمة الابتدائية). ويعني هذا الدفع أن المدعي لا يمتلك الصفة القانونية اللازمة لرفع الدعوى، سواء كان لعدم كونه صاحب الحق أو المصلحة في النزاع المطروح أمام المحكمة. إذا قبلت محكمة أول درجة هذا الدفع، فإنها تقضي بعدم قبول الدعوى، وبالتالي يتم رفض النظر فيها.
وفي حال قدم أحد الأطراف استئنافًا ضد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، تقوم محكمة الاستئناف بالنظر في هذا الدفع مجددًا. من حيث المبدأ، يمكن لمحكمة الاستئناف أن تواصل النظر في الدفع بعدم قبول الدعوى إذا كانت تملك قناعة بأن المدعي بالفعل لا يمتلك الصفة القانونية، ولكن المحكمة لا تقتصر على الوقوف عند هذا الدافع فقط.
إذا تبين لمحكمة الاستئناف أنه لا يوجد مانع قانوني من نظر الدعوى، أو إذا كانت محكمة أول درجة قد أخطأت في تطبيق القانون فيما يتعلق بتوافر الصفة، يمكن لمحكمة الاستئناف أن تقضي بقبول الدعوى وتعيد النظر فيها بناءً على ذلك. ومع ذلك، إذا كانت محكمة الاستئناف ترى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة قائم على أسس قانونية سليمة، فإنها تؤيد حكم محكمة أول درجة.
في النهاية، يبقى الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة من الدفوع المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على مسار القضية، ويجب على المحكمة أن تتحقق من توافر الصفة القانونية بشكل دقيق سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف.
الوزير هو صاحب الصفة في رفع الدعاوى المتعلقة بشئون وزارته :
في قانون المرافعات، يُعتبر الوزير هو صاحب الصفة القانونية في رفع الدعاوى المتعلقة بشئون وزارته. وهذا يعني أن الوزير، بصفته المسؤول الأول عن إدارة الوزارة، هو الشخص الذي يمتلك الحق في رفع الدعوى أو الدفاع عنها أمام المحكمة في المسائل التي تتعلق بالشئون الإدارية أو القانونية التي تخص وزارته.
الوزير يملك هذه الصفة القانونية بناءً على السلطات والاختصاصات التي يمنحها له القانون في إطار مهامه الوزارية. على سبيل المثال، إذا كانت الدعوى تتعلق بقرارات إدارية صادرة عن الوزارة أو مسألة مالية أو تنظيمية تخص الوزارة، فإن الوزير هو المخول قانونًا برفع الدعوى أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، سواء كان ذلك للدفاع عن مصلحة الوزارة أو لمتابعة تنفيذ القرارات.
ويترتب على ذلك أن أي دعوى تتعلق بشئون الوزارات لا يمكن أن ترفع إلا من قبل الوزير أو من يُفوضه في هذا الخصوص، حيث أن رفع الدعوى من شخص غير الوزير أو من ليس مفوضًا منه قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لعدم توافر الصفة القانونية.
إذن، فإن الوزير هو الذي يمتلك الصفة القانونية لرفع الدعاوى المتعلقة بالمسائل التي تخص وزارته، وهو الذي يحدد من خلال ممارسته لاختصاصاته الوزارية القضايا التي تحتاج إلى تدخل قانوني أو إجرائي.
الشركات القابضة هي صاحبة الصفة في قضايا قطاع الأعمال وفقا للقانون 203 لسنة 1991 :
وفقًا للقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام في مصر، تُعد الشركات القابضة هي صاحبة الصفة القانونية في القضايا المتعلقة بقطاع الأعمال. هذا يعني أن الشركات القابضة هي التي تتولى إدارة الأصول والأموال الخاصة بالشركات التابعة لها، ولها الحق في تمثيل هذه الشركات أمام القضاء في الدعاوى القانونية التي قد تنشأ.
تتمثل الشركات القابضة في كونها الكيانات القانونية التي تجمع عدة شركات تابعة في مجال معين، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالتالي فهي المسؤولة عن التصرفات القانونية والإدارية المتعلقة بالشركات التابعة. وفقًا لهذا القانون، تعتبر الشركات القابضة هي الطرف الرئيس في الدعاوى القضائية المتعلقة بالشركات التابعة لها، ويجوز لها أن ترفع أو تدافع عن القضايا القانونية التي تتعلق بمصالح القطاع أو الشركات التابعة.
وبذلك، فإن الشركات القابضة تشكل الجهة المختصة قانونًا بالتعامل مع النزاعات أو الدعاوى المتعلقة بالشركات التي تشرف عليها، سواء في القضايا المدنية أو التجارية أو الإدارية، كما أن المحكمة المختصة هي تلك التي يُرفع فيها الدعوى من قبل الشركة القابضة باعتبارها صاحبة الصفة في القضية، وليس الشركات التابعة بشكل منفصل.
جواز تغيير الصفة أمام محكمة الإستئناف بشرط عدم التأثير في الطلبات ولا في مراكز الخصوم :
في قانون المرافعات، يُسمح للطرفين في الدعوى بتغيير الصفة أمام محكمة الاستئناف في بعض الحالات، بشرط ألا يؤدي هذا التغيير إلى التأثير في الطلبات المقدمة من قبلهم أو في مراكز الخصوم القانونية. بمعنى آخر، يمكن للطرف الذي يرفع الاستئناف أو يدافع عنه أن يطلب تغيير الصفة التي كان عليها في المرحلة الابتدائية، سواء من حيث تمثيله أو من حيث تحديد الطرف الذي يحق له الاستئناف، ولكن هذا يجب أن يكون دون المساس بما تم تقديمه من طلبات أو ما استقر عليه وضع الأطراف في الدعوى.
إذا تم تغيير الصفة في محكمة الاستئناف، يجب أن يكون هذا التغيير مقيدًا بموافقة المحكمة وألا يؤثر على موضوع الدعوى أو المواقف القانونية للأطراف، مثل مركز المدعى أو المدعى عليه. بمعنى أن التغيير لا يُعد تغييرًا في الحق الموضوعي أو في الدعوى ذاتها، بل مجرد تعديل في تمثيل أو صفة أحد الأطراف، مما يساعد على تصحيح الوضع القانوني أو الإداري للطرف.
على سبيل المثال، إذا كان المدعي قد مثل في المحكمة الابتدائية شخص آخر بصفته وكيلًا أو ممثلًا عن جهة معينة، يمكن أن يُسمح له بتغيير الصفة أمام محكمة الاستئناف ليكون هو المدعي شخصيًا إذا كان قد حصل على تفويض جديد، بشرط ألا يؤثر هذا التغيير في طلباته أو في المركز القانوني للخصم.
إذن، تغيير الصفة أمام محكمة الاستئناف يُعتبر ممكنًا إذا كان الهدف هو تصحيح الوضع القانوني أو توضيح التمثيل، مع الحفاظ على استقرار الطلبات وأوضاع الخصوم في الدعوى.
صفة محامي هيئة قضايا الدولة :
في قانون المرافعات المصري، يتمتع محامو هيئة قضايا الدولة بصفة قانونية خاصة تجعلهم ممثلين قانونيين عن الدولة والجهات الإدارية في الدعاوى القضائية. وفقًا لأحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، فإن هذه الهيئة تتولى الدفاع عن الدولة ومصالحها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، كما تختص برفع الدعاوى أو الدفاع فيها عن الجهات الحكومية والهيئات العامة.
ويتمتع محامو هيئة قضايا الدولة بصفة قانونية تجعلهم المخولين بتمثيل الدولة أمام القضاء دون الحاجة إلى تقديم توكيل رسمي، حيث إن تمثيلهم ينبع من سلطتهم القانونية المباشرة بموجب القانون. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز مقاضاة الدولة أو أي جهة حكومية دون أن يكون محامي هيئة قضايا الدولة ممثلًا لها في الدعوى.
كما أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها ضد إحدى الجهات الحكومية دون اختصام هيئة قضايا الدولة يعد من الدفوع الشكلية التي تؤدي إلى عدم قبول الدعوى، مما يعكس الطبيعة الإلزامية لحضور محامي الهيئة في القضايا التي تكون الدولة طرفًا فيها. ويؤكد ذلك على الدور المحوري الذي تلعبه هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام والحقوق القانونية للدولة أمام القضاء.
رفع الدعوى ضد الولى الشرعي بإحدى صفتيه :
في قانون المرافعات، إذا كان للولي الشرعي أكثر من صفة قانونية، فإنه يجوز رفع الدعوى ضده بإحدى صفتيه، سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلًا قانونيًا عن القاصر أو ناقص الأهلية. ومع ذلك، يجب أن تكون الصفة التي تم اختصامه بها متناسبة مع موضوع الدعوى ومتوافقة مع مركزه القانوني فيها.
على سبيل المثال، إذا كان الولي الشرعي هو الأب، فقد يتم اختصامه بصفته شخصيًا في دعوى تتعلق بحقوقه الخاصة، أو قد يتم اختصامه بصفته وليًا على ابنه القاصر في دعوى تتعلق بحقوق القاصر. في هذه الحالة، يجب أن يكون واضحًا ما إذا كان المدعى عليه يمثل نفسه أو يمثّل القاصر، لأن لكل صفة آثارًا قانونية مختلفة في الخصومة.
وإذا تم رفع الدعوى ضد الولي بإحدى صفتيه، فلا يجوز تصحيح الصفة لاحقًا لتشمل الصفة الأخرى إلا إذا كان ذلك لا يؤدي إلى تغيير جوهري في الطلبات أو يؤثر على حقوق الأطراف. بمعنى أنه لا يجوز التحايل على الصفة أو التبديل بينهما بما قد يؤدي إلى تغيير مركز الخصومة أو التأثير في إجراءات الدعوى.
بالتالي، يجب تحديد الصفة الصحيحة عند رفع الدعوى ضد الولي الشرعي، بحيث يكون مختصمًا بالصفة التي تتناسب مع موضوع النزاع، حتى تكون الدعوى مقبولة شكلاً أمام المحكمة.
شرط الصفة يتعلق بالنظام العام :
في قانون المرافعات المصري، يُعد شرط الصفة من الشروط الجوهرية التي تتعلق بالنظام العام، مما يعني أن المحكمة تلتزم بالتحقق من توافر الصفة في الدعوى من تلقاء نفسها، حتى لو لم يثره أحد الخصوم. فإذا تبين أن المدعي لا يتمتع بالصفة القانونية لرفع الدعوى، فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى دون الحاجة إلى دفع من الخصم، وذلك لأن الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى وليس مجرد مسألة إجرائية يمكن التنازل عنها.
وبما أن الصفة تتعلق بالنظام العام، فإن الدفع بعدم توافرها يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى لأول مرة أمام محكمة النقض، بشرط ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع. كما يترتب على انتفاء الصفة انعدام الخصومة، أي أن الدعوى تُعتبر كأنها لم تُرفع أصلًا، لأن من رفعها ليس له علاقة قانونية مباشرة بالحق المطالب به.
ويهدف اعتبار شرط الصفة من النظام العام إلى ضمان أن يكون التقاضي محصورًا في أصحاب الحقوق الفعلية، ومنع الدعاوى الكيدية أو غير الجدية التي قد تستهلك وقت القضاء وتعرقل تحقيق العدالة.
صفة المحافظ في تمثيل الوزارات وإختصاصاته وفقا لقانون الحكم المحلي :
في قانون المرافعات المصري، يتمتع المحافظ بصفة قانونية خاصة في تمثيل الوزارات والإدارات المحلية في نطاق محافظته، وفقًا لأحكام قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979. حيث يعتبر المحافظ هو الممثل القانوني للجهات الحكومية والإدارية داخل المحافظة، ويملك صلاحية رفع الدعاوى أو الدفاع فيها نيابة عن هذه الجهات، وذلك في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصه.
كما يختص المحافظ بالإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح داخل محافظته، وإدارة المشروعات العامة والخدمات الحكومية المحلية، بما في ذلك التخطيط العمراني، والمرافق العامة، والتنمية المحلية. وعند نظر القضايا المتعلقة بالمحافظة أو المصالح الحكومية التابعة لها، يكون المحافظ هو صاحب الصفة القانونية في التقاضي، سواء كان ذلك في دعاوى مرفوعة ضد الجهة الإدارية بالمحافظة، أو في القضايا التي تقيمها المحافظة لحماية مصالحها.
وبناءً على ذلك، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قد يُثار إذا تم اختصام جهة إدارية داخل المحافظة دون اختصام المحافظ بصفته، باعتباره الممثل القانوني لهذه الجهات وفقًا لقواعد الحكم المحلي وقانون المرافعات.
المحافظ هو صاحب الصفة الوحيد في الخصومة المتعلقة بإختصاص الوزارة الذي نقل إليه :
في قانون المرافعات المصري، يُعتبر المحافظ هو صاحب الصفة الوحيد في الدعاوى والخصومات المتعلقة بالاختصاصات التي نُقلت إليه من الوزارات المختلفة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979. حيث إن نقل بعض اختصاصات الوزارات إلى المحافظات بموجب هذا القانون يجعل المحافظ هو الممثل القانوني الوحيد في النزاعات التي تنشأ بشأن هذه الاختصاصات، وليس الوزير المختص.
ويترتب على ذلك أنه في حال رفع دعوى تتعلق بقرار إداري أو إجراء يدخل ضمن اختصاص تم نقله من الوزارة إلى المحافظة، يكون المحافظ هو الطرف الذي يجب اختصامه في الدعوى، وليس الوزارة أو الوزير المعني. وأي دعوى تُرفع ضد الوزارة بشأن موضوع أصبح من اختصاص المحافظ تُعتبر غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، ويجوز الدفع بعدم قبولها لهذا السبب.
وتعزز هذه القاعدة مبدأ عدم تجزئة الصفة في التقاضي، بحيث يكون المحافظ هو المسؤول أمام القضاء عن القرارات الإدارية والإجراءات التنفيذية التي تدخل ضمن سلطته، وفقًا لما منحه له القانون من صلاحيات تنفيذية وإدارية مستقلة عن الوزارة الأصلية.
صفة المحافظ في حالة تفويض الوزير المختص له في موضوع الخصومة في قانون المرافعات :
في قانون المرافعات، الأصل أن الوزير المختص هو صاحب الصفة القانونية في تمثيل الوزارة ورفع الدعاوى أو الدفاع عنها فيما يتعلق بشؤون وزارته. ومع ذلك، يجوز للوزير أن يفوض المحافظ في بعض الأمور المتعلقة بالخصومة القضائية التي تخص الوزارة، مما يمنح المحافظ الصفة القانونية في هذا النطاق المحدد.
عند صدور تفويض صريح من الوزير المختص إلى المحافظ، يصبح للمحافظ الحق في مباشرة الإجراءات القانونية، سواء كان ذلك برفع الدعوى أو الدفاع فيها، ولكن في حدود التفويض الممنوح له. هذا يعني أن المحافظ لا يكتسب الصفة العامة في جميع المسائل القانونية للوزارة، بل فقط في القضايا التي شملها التفويض.
على سبيل المثال، إذا كان النزاع القضائي يتعلق بمسألة محلية تخص وزارة الإسكان أو التنمية المحلية، وكان الوزير المختص قد فوض المحافظ في التعامل مع هذه القضية، فإنه يصبح من حق المحافظ مباشرة الخصومة أمام القضاء دون الحاجة إلى تدخل الوزير، طالما أن التفويض ساري المفعول.
إذن، صفة المحافظ في موضوع الخصومة تنشأ من التفويض الصادر له من الوزير المختص، ويظل هذا التفويض محدودًا بالنطاق الذي حدده الوزير، ولا يجوز للمحافظ التصرف خارج هذه الحدود دون تفويض جديد أو تفويض عام يشمل المسألة المتنازع عليها .
جواز الحكم على المدعى بغرامة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لإنتقاء شرط المصلحة :
في قانون المرافعات المصري، يُجيز المشرّع للمحكمة الحكم على المدعي بغرامة إذا قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وذلك للحد من الدعاوى الكيدية أو غير الجادة التي تستنزف وقت القضاء والخصوم دون وجود مصلحة قانونية حقيقية. إذ يُعد شرط المصلحة أحد الشروط الجوهرية لقبول الدعوى، وفقًا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات، والتي تشترط أن تكون للمدعي مصلحة قانونية قائمة وحالة أو محتملة عند رفع الدعوى.
وفي حالة رفع دعوى دون توفر هذه المصلحة، يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم قبولها، مع إلزام المدعي بغرامة إذا رأت أن الدعوى أقيمت بسوء نية أو بهدف تعطيل إجراءات التقاضي والإضرار بالخصم. وتُفرض هذه الغرامة وفقًا لتقدير المحكمة، وتذهب إلى خزانة الدولة كوسيلة ردع لمنع استغلال القضاء في غير موضعه.
ويؤكد هذا الإجراء على أهمية التزام المدعين بالضوابط القانونية عند رفع الدعاوى، وضمان أن يكون التقاضي وسيلة لحماية الحقوق المشروعة، وليس مجرد أداة للمنازعات غير الجدية أو التعسفية.
شرط الأهلية لقبول الدعوى :
في قانون المرافعات المصري، يُعد شرط الأهلية من الشروط الأساسية لقبول الدعوى، حيث يجب أن يكون للمدعي أهلية التقاضي حتى يتمكن من مباشرة الدعوى والمطالبة بحقوقه أمام القضاء. ويُقصد بالأهلية هنا أهلية الأداء القانونية، أي أن يكون المدعي قد بلغ سن الرشد القانوني (21 عامًا ميلاديًا كاملًا) وغير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية مثل الجنون أو العته أو السفه، وفقًا لأحكام القانون المدني.
إذا كان المدعي ناقص الأهلية أو عديمها، فلا يجوز له مباشرة الدعوى بنفسه، بل يجب أن يُمثَّل عن طريق الولي أو الوصي أو القيم، بحسب الأحوال، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي أهلية. كما أن الدفع بعدم الأهلية من الدفوع الجوهرية التي يمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى أمام محكمة النقض، باعتباره متعلقًا بالنظام العام.
ويهدف اشتراط الأهلية إلى ضمان أن يكون التقاضي مقتصرًا على الأشخاص الذين يملكون القدرة القانونية على إدارة حقوقهم، ومنع استغلال ناقصي أو عديمي الأهلية في منازعات قضائية قد لا يدركون تبعاتها.
حالة زوال العيب الذي شاب تمثيل ناقص الإهلية أثناء مباشرة الخصومة :
في قانون المرافعات، إذا شاب الخصومة عيب في تمثيل ناقص الأهلية بسبب عدم تعيين ممثل قانوني له أو لوجود خلل في الإجراءات الخاصة بتوكيله، فإن هذا العيب قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى أو بطلان الإجراءات. ومع ذلك، إذا زال هذا العيب أثناء سير الخصومة، فإن ذلك يؤدي إلى تصحيح الوضع القانوني واستمرار الدعوى بشكل صحيح.
على سبيل المثال، إذا رُفعت الدعوى من أو ضد شخص ناقص الأهلية (مثل قاصر أو شخص تحت الحجر) دون تمثيله من قبل الولي أو الوصي أو القيم القانوني، فإن المحكمة قد تعتبر الدعوى معيبة شكلاً. ولكن إذا تم تصحيح العيب أثناء سير الدعوى، كأن يبلغ القاصر سن الرشد أو يتم تعيين ممثل قانوني له وفقًا للإجراءات الصحيحة، فإن الخصومة تستمر دون الحاجة إلى إعادة رفع الدعوى من جديد.
وهذا التصحيح يستند إلى قاعدة عامة في الإجراءات المدنية، وهي عدم التمسك بالشكليات على حساب الحق الموضوعي، بحيث يُعطى للخصومة فرصة الاستمرار إذا تم إزالة العيب الإجرائي الذي كان يشوبها، طالما أن ذلك لا يؤثر على حقوق الخصوم أو على جوهر الدعوى.
بالتالي، زوال العيب الذي شاب تمثيل ناقص الأهلية أثناء الخصومة يؤدي إلى تصحيح الإجراء واستمرار سير الدعوى دون الحاجة إلى إعادة رفعها، مما يحقق التوازن بين ضمان صحة الإجراءات وحماية الحقوق القانونية للأطراف.
أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بشرط المصلحة في الدعوى :
أرست المحكمة الدستورية العليا في مصر مبادئ هامة بشأن شرط المصلحة في الدعوى وفقًا لقانون المرافعات، حيث أكدت أن المصلحة شرط أساسي لقبول الدعوى الدستورية وغيرها من الدعاوى القضائية. وفسّرت المحكمة مفهوم المصلحة بأنه يجب أن تكون قانونية، شخصية، مباشرة، وقائمة أو محتملة، مما يعني أن رافع الدعوى يجب أن يكون له حق ذاتي متأثر بالنص القانوني المطعون فيه أو بالقرار الإداري محل النزاع.
كما شددت المحكمة في أحكامها على أن شرط المصلحة يتعلق بالنظام العام، وبالتالي يجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى. وأوضحت أن المصلحة لا تقتصر على الضرر الفعلي القائم، بل يمكن أن تكون مصلحة محتملة إذا كان من شأن تطبيق النص محل الطعن أن يُلحق ضررًا مباشرًا بالمدعي مستقبلًا.
ومن أبرز المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية أن المصلحة في الدعوى الدستورية يجب أن تكون متعلقة بمدى تأثير النص التشريعي المطعون فيه على حقوق المدعي الدستورية، فلا يُقبل الطعن إذا كان مجردًا أو لا يرتب أثرًا واقعيًا على المركز القانوني للطاعن. وبهذا، تُعتبر هذه الأحكام ضمانة مهمة للحيلولة دون استغلال القضاء في منازعات غير حقيقية أو أكاديمية لا تمس حقوقًا فعلية للمدعين.
أحكام النقض المتعلقة بالمادة 3 مرافعات و 3 مكررا :
أصدرت محكمة النقض المصرية العديد من الأحكام التي تناولت المادة 3 و المادة 3 مكرراً من قانون المرافعات، حيث تعتبر هاتان المادتان من الأسس الجوهرية التي تحدد شروط قبول الدعوى ومدى توافر المصلحة والصفة اللازمة للتقاضي.
- المادة 3 من قانون المرافعات تنص على أن “الدعوى لا تقبل إلا إذا توافرت فيها مصلحة قانونية قائمة أو محتملة”، وقد أكدت محكمة النقض في عدة أحكام أن المصلحة شرط جوهري لقبول الدعوى، ويجب أن تكون قائمة أو محتملة وقت رفع الدعوى. وقد بيّنت المحكمة أن عدم توافر المصلحة في الدعوى يؤدي إلى عدم قبولها، مشيرة إلى أن المصلحة لا تقتصر على الضرر الفعلي الحاصل، بل يمكن أن تكون مصلحة محتملة إذا كان يترتب على التصرف المطعون فيه إلحاق ضرر بالمدعي في المستقبل.
- أما المادة 3 مكرراً، فقد أضافت شرطًا جديدًا يتعلق بمفهوم المصلحة في الدعاوى التي تتعلق بالإجراءات المؤقتة. حيث نصت على أن “الدعوى لا تقبل إذا كان المدعى لم يتوافر له حق قائم” وأنه يجب أن يكون للمدعي مصلحة مباشرة أو حقيقية في الدعوى المقامة. وأكدت محكمة النقض في أحكامها أن هذا التعديل جاء لتوضيح معايير المصلحة التي يجب أن تتوافر في مختلف الدعاوى، وأن المصلحة يجب أن تكون شخصية وقائمة وليست مجرد مصلحة نظرية أو غير حقيقية.
كما أكدت محكمة النقض في العديد من الأحكام على أن شرط المصلحة يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى أمام محكمة النقض. وبالتالي، تعتبر أحكام محكمة النقض بشأن المادتين 3 و 3 مكرراً حاسمة في تحديد نطاق قبول الدعاوى وضمان أن يكون التقاضي موجهًا نحو حماية الحقوق المشروعة فقط.
الصفة والتعدد الاجبارى لاحد طرفى الدعوى
التعدد الاجبارى يكون فى حالتين
- اذا نص القانون على ذلك اى بوجوب اختصام جميع اطراف الرابطة الموضوعية فى الخصومة كدعوى القسمة للمال الشائع ودعوى الشفعة
- اذا لم ينص القانون على التعدد الاجبارى فيقرق بين الدعوى التقريرية والدعوى المنشئة وبين دعوى الالزام فيكون التعدد اجباريا بالنسبة لكل من الدعوى التقريرية والدعوى المنشئة دون دعوى الالزام والعلة انه لا يتصور تقرير رابطة واحدة او تغيير هذه الرابطة الا فى مواجهة جميع اطراف هذه الرابطة
فتحى والى ص 369 ، 370
المستشار جمال رمضان – شروط قبول الدعوى – ص 61 ، 62
عدم اختصام اطراف الرابطة الواحدة يكون الدفع حسب الاحوال عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة او رفعها على غير ذى كامل صفة
والفرق بين الصفة فى الدعوى والصفة الاجرائية فى مباشرتها :
الا ستثناء من شرط المصلحة الشخصية المباشرة ” صفة رافع الدعوى “
مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت . - 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني